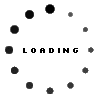قراءة أولية في التَحولّات “الإسرائيلية”
الحلقة الرابعة
“إسرائيل: دولة يهودية وديمقراطية“

بقلم الأسير: كميل أبو حنيش*
الحلقة الاولى اضغط هنا
الحلقة الثانية اضغط هتا
الحلقة الثالثة اضغط هنا
تُعد الأزمة السياسية الراهنة في “اسرائيل”، انعكاساً للأزمة التاريخية الكامنة، التي يمكننا أن نُلخصها “بأزمة الهوية”، ويُعتبر تعريف “اسرائيل” لذاتها بأنها “دولة يهودية وديمقراطية” في آنٍ معًا، إحدى تجليات هذه الأزمة، إذ يندرج خلف كل مفهوم من كلا المفهومين، مكوناتٍ سياسيةٍ وثقافيةٍ واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ واثنية، تنطوي على وجود مجتمعين منفصلين ومنقسمين عموديًا، انقسامًا حادًا.
وتُعد هذه الصيغة في التزاوج بين المفهومين المتناقضين شكلًا ومضمونًا إحدى الحلول المؤقتة لإرضاء كلا المجتمعين؛ إذ يُعبّر مفهوم اليهودية عن هوية الدولة بمضامينها الدينية والقومية والثقافية والقطرية المُستقاة من اليهودية بوصفها – حسب زعمهم – دين وقومية وتاريخ وتراث وثقافة في ذات الوقت، في حين يُعبّر مفهوم الديمقراطية عن القوى المدنية والعلمانية والليبرالية التي تسعى إلى تكريس هوية الدولة بمضامينها الديمقراطية والحداثية.
فقد تضمنت “وثيقة الاستقلال” كلا المفهومين ولكن بصيغٍ منفصلة عن بعضها البعض، حيث أعلنت الوثيقة أن “إسرائيل” دولة يهودية مفتوحة لجميع اليهود المقيمين فيها، وكذلك من هم خارجها.
وتم تجسيد هذا المبدأ في “قانون العودة” لسنة 1950 و”قانون الجنسية” لسنة 1952. وتضمنت الوثيقة أيضًا بعضًا من القيم الديمقراطية كالمساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، وكذلك ضمان الحريات كحرية الدين والضمير والثقافة والتعبير والتعليم واللغة.. الخ، غير أن دمج المبدئين بوثيقةٍ واحدة: “يهودية – ديمقراطية” في بدايات تسعينيات القرن الماضي، انطوى على مفارقةٍ صارخة، وذلك بسبب التناقض بين المبدئين؛ فاليهودية بوصفها ديانة لا تعترف بمبدأ المساواة بين اليهود وسائر الشعوب الأخرى وتعتبرهم “أغيارًا”، ولا تعترف بالحريات والحقوق المدنية والإنسانية، وتُعادي علمانية الدولة والمجتمع ولا تعترف بالقيم الديمقراطية الأساسية إلا بما يخدم القوى السياسية الدينية ومصالح المتدينين في الدولة.
أما مفهوم اليهودية بوصفها قومية التي تتبناها الأيديولوجيا الصهيونية فتتعارض أيضًا مع الديمقراطية وقيمها، لأن الصهيونية كفكرةٍ استعمارية لا تقبل بمبدأ المساواة بين اليهود وبين الفلسطينيين. ومن هنا يتضح جذر الخلاف بين المبدئين، وسنعالج بتوسع في مكانٍ آخر أوجهًا أخرى للتناقض بين اليهودية والديمقراطية.
ظهرت لأول مرة المزاوجة بين “اليهودية والديمقراطية” قانونيًا سنة 1985، بعد تعديل قانون “أساس الكنيست” إثر قرار محكمة العدل العليا منع “حركة كاخ” والحركة التقدمية من خوض الانتخابات.
وأضيف إلى التعديل في القانون الأساس نص يقول “أنه لن يسمح لأيِ حزب بخوض الانتخابات إذا ما رفض التعريف الخاص بإسرائيل كدولةٍ للشعب اليهودي” غير أن التعريف المزدوج “لإسرائيل – يهودية وديمقراطية” ظهر على نحوٍ أكثر وضوحًا سنة 1992، بعد سن “الكنيست” لقانون “أساس كرامة الإنسان وحريته”، حيث نص القانون (هدف هذا القانون الأساس هو الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته من أجل تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولةٍ يهوديةٍ وديمقراطية).
وفي “قانون أساس حرية العمل”، حيث ورُد في القانون (هدف القانون الأساس هو الدفاع عن حرية اختيار العمل من أجل تثبيت قيم دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية). وبعد إقرار هذين القانونين، أصبحت توليفة ” يهودية وديمقراطية” بالنسبة لمعظم “الإسرائيليين” كأنهما مصطلحًا واحدًا، وأصبح أي انتقاء يُوجه لليهودية كأنه اعتداء على الديمقراطية.
ومع ذلك، ثار جدل واسع حول هذه التوليفة بين المفهومين المتناقضين، في مختلف الدوائر السياسية والأكاديمية والثقافية والإعلامية. وقد حاولت المؤسسة القضائية توسيع مفهوم الديمقراطية بعد سن هذين القانونين، وركزت على الحقوق الفردية والحريات، وهو ما أثار غضب القوى والأحزاب اليمينية لا سيما الدينية منها التي أرادت تضييق المعنى الديمقراطي لحساب المعنى اليهودي، ودعت بصراحة إلى تحجيم دور القضاء الذي أخذ لنفسه حيزًا واسعًا في تفسيرِ القوانين.
في محاضرة لرئيس المحكمة العليا السابق “أهارون باراك” في المؤتمر العالمي للعلوم اليهودية سنة 1997، بَيّن خلالها (أن المكانة المعيارية التي مُنحت لقيم الدولة كيهودية وديمقراطية هو مكانة معيارية دستورية فوق قانونية، وسوف يلغى أي تشريع عادي، يمس دستوريًا بحقٍ من حقوق الإنسان حتى لو كان هدفه مقبولًا وحتى لو لم يتجاوز المدى المطلوب إذا لم يتلاءم مع قيم دولة إسرائيل كدولةٍ يهودية وديمقراطية) (المصدر: عقل صلاح وكميل أبو حنيش- إسرائيل دولة بلا هوية – ص 106).
أما بالنسبة إلى كيفية التوفيق بين “اليهودية والديمقراطية”، يقول باراك “أن المجتمع بطاقاته الروحية والفكرية هو الذي يقر معنى يهودية الدولة”، وبهذا أحال “باراك” تفسير هذا المعنى إلى المجتمع وطاقاته الروحية والفكرية، وهذه صيغة فضفاضة وتُعد هروبًا من مواجهة هذه المعضلة، منذ السنوات الأخيرة شهدنا سجالًا واسعًا حول معنى “الدولة اليهودية”، ونجم عنه سن عددٍ من القوانين كان آخرها “قانون القومية” التي كرست الطابع اليهودي على حساب الديمقراطي (نفس المصدر السابق. ص 106).
وإذا كانت المساواة إحدى المبادئ الهامة في أيِ نظامٍ ديمقراطي، فإن هذا المبدأ يُعتبر غائبًا في نظام الدولة الصهيونية؛ فالعرب في “إسرائيل” يعدوا مواطنين من الدرجة الثانية، علاوةً على أوجه التمييز القانوني ضدهم، وخاصة بعد إقرار “قانون القومية” الذي يُطوّب “إسرائيل” بوصفها أرضًا حصرًا على اليهود وحدهم، ويتناقض مع شروط الحقوق المتساوية، وبالتالي شروط الديمقراطية.
إن التأكيد على “يهودية الدولة”، يلغي بالضرورة أو يُقلص مساحة الشكل الديمقراطي الذي تُمارسه الدولة، وما نشهده حاليًا من أزمةٍ سياسية، تُعتبر استكمالًا “لقانون القومية”، فبعد حصر ملكية الدولة باليهود بعد إقرار “قانون القومية”، انتقل الصراع السياسي بين اليهود أنفسهم. فمن جهة تحاول القوى اليمينية تعزيز الطابع اليهودي للدولة على حساب الطابع العلماني الديمقراطي، وبين معسكر المعارضة الذي يرفض المساس بالنظام القائم ذي الوجه العلماني و”الديمقراطي”.
بينما أن تفسير معنى “دولة يهودية وديمقراطية” يترك للمجتمع بطاقاته الروحية والفكرية، كما اقترح القاضي “أهارون باراك” فإن هذا التفسير سيكون متناقضًا وشائكًا وإشكاليًا من مرحلةٍ لأخرى، ومن حكومةٍ لأخرى، وسيظل خاضعًا للمزاج والمصالح السياسية والحزبية والاجتماعية في “إسرائيل”، وهذا بالضبط ما يحدث في الوقت الراهن، بعد أن استغلت قوى اليمين فوزها بالانتخابات وأرادت تعزيز الهوية اليهودية على حساب الهوية الديمقراطية.
ويلخص عزمي بشارة التناقض بين مفهومي اليهودية والديمقراطية بالقول (إن الدولة العبرية تجد نفسها إذا أرادت المحافظة على يهوديتها في حالة تناقضٍ مستمر مع الديمقراطية وقيمها) (عزمي بشارة، من يهودية الدولة، حتى شارون، ص 54).
ويضيف بشارة (إن الصهيونية، لا المواطنة، هي وعاء الديمقراطية وهو عائق تطورها في آنٍ، فهي في ساعات الأزمات لا تعدو كونها ديمقراطية داخل القبيلة) (نفس المصدر السابق ص 109).
وفي ضوء أزمة خطة الإصلاح القضائية الحالية انتقل الصراع إلى داخل القبيلة نفسها، أي اليهود، بين المتدينين والعلمانيين، القوميين والليبراليين، اليمين واليسار أو “الفوضويين” كما شاعت تسميتهم مؤخرًا على لسان أكثر من مسؤول حكومي، بين الشرقيين والاشكناز.
ففي مقابلة أجرتها صحيفة “يديعوت أحرنوت في 11 مايو أيار 2016” أجمع أربعة من الرؤساء السابقين للمحكمة العليا في “إسرائيل”، على أن “إسرائيل” تشهد سيرورات مثيرة للقلق قد تؤول نتيجتها إلى نهاية النظام الديمقراطي فيها (انطوان شلحت – المشهد السياسي – تقرير مدار الإستراتيجي 2016- ص 68-94). وتعتقد قوى اليمين “إن توسيع الديمقراطية قد يقود إلى مساواة كاملة بين العرب واليهود، وهذا أمر لا تَتحمّله الهوية اليهودية العنصرية التي تقوم على مفهوم النفي الثقافي والوجودي معًا” (مجدي حماد. السلام الاسرائيلي – الجزء الأول واستراتيجية الهيمنة. ص 209).
وفي إشارة مبكرة لهذا الجدل والصراع الحالي، أشار “أهارون باراك” في مقابلة له أجريت على صحيفة يديعوت أحرنوت بتاريخ 19 أكتوبر 2018، “إلى أن النظام الذي لا يفصل بين السلطات وينتهك سلطة القانون، وينتهك القيم الأساسية وحقوق الإنسان، ليس نظامًا ديمقراطيًا”.
ويُعتبر القاضي “باراك”، أحد أبرز المدافعين عن صيغة التعريف المزدوج “لإسرائيل”، كدولة يهودية وديمقراطية، وتحظى مواقفه بتأييدٍ واسع في صفوف الاتجاهات العلمانية والليبرالية واليسارية للدور الذي لعبه أثناء رئاسته لمحكمة العدل العليا، ومحاولاته لتوسيع صلاحيات المحكمة في تفسير القوانين لصالح المكون الديمقراطي. فيما يحظى بعداءٍ شرس من القوى اليمينية لذات الأسباب، وقد صرح في ذات المقابلة المذكورة (إذا نحن لم نحمِ الديمقراطية لن تحمينا)، وذلك في تنبيه مبكر لما يعتزم اليمين إقراره من قوانين وإجراءات من شأنها أن تنسف الأسس التي قامت عليها الدولة.
وقد هاجم “باراك” بشدة خطة الإصلاح القضائية، واعتبرها وسيلة لتدمير الدولة ونظامها الديمقراطي، فسارع وزير العدل “يريف ليفين” لمهاجمته، بطريقة تنم عن كراهية دفينة حيث قال (القاضي باراك غاضب لأنني لم استشره في أمر الخطة الإصلاحية.. من هو حتى أستشيره).
ويُعد هذا السجال، استكمالاً للسجال التاريخي المحتدم على هوية الدولة بوصفها يهودية وديمقراطية في آنٍ واحد، فقد “أدت قوننة توليفة الدولة اليهودية والديمقراطية إلى صعود جدل داخلي، حول المعنى العملي لدولة يهودية وديمقراطية، حول الامكانيات العملية للتوفيق بين المركبات الخاصة اليهودية من جهة، والإلتزام في الوقت ذاته بالمركبات العالمية للديمقراطية (هنيدة غانم. في معنى الدولة اليهودية. ص 22).
ويعتقد الباحث الأكاديمي “أورن يفتاحئيل” في كتابه (الاثنوقراطية) (أن القانونين الصادرين في العام 1992، قد عرفا الدولة بأنها يهودية وديمقراطية، وبذلك تم تكريس الطابع اليهودي للدولة، وأردف ذلك “بالتزامها الديمقراطي” وهو إشكالي ليس كمبدأ مجرد، وإنما ضد واقع العملية التهويدية المتواصلة التي أدت إلى إعادة هيكلة المجتمع على نحوٍ أحادي من خلال سياسات وممارسات التهويد بعيد المدى “اورن يفتاحئيل. الاثنوقراطية ص 130”.
ويضيف “يفتاحئيل” (لذلك فإن البنية الأساسية للنظام الإسرائيلي وبالتالي العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية، لا تعود فقط إلى الإعلان بأنها يهودية، وقد يكون ذلك قريبًا من الوضع الدستوري القائم في دولة ديمقراطية مثل فنلندا اللوثرية، وانجلترا الانجليكانية، فالمشكلة عميقة بفعل بنيويتها، وهي تكمن في العمليات المتوازية للتهويد من جهة والقضاء على المعالم الغربية من جهةٍ أخرى، التي تم تسهيلها وإضفاء الشرعية عليها بالإعلان عن أن إسرائيل يهودية، وبالسياسات والمؤسسات السياسية الاثنية الناجمة عن هذا الإعلان” (نفس المصدر ص 134).
وربما تعود المشكلة إلى الجذور الأولية: أي منذ ظهور الصهيونية والجدل الذي تطور مع الوقت حول صيغة الدولة: هي دولة يهودية أم دولة اليهود؟ فالتيارات والأحزاب الدينية، ترى في التعريف الأول (الدولة اليهودية) وما ينطوي عليه من مضامين دينية وشرعية هو التعريف الأكثر ملاءمة للدولة. فيما شددت التيارات العلمانية على الثاني (دولة اليهود) بطبيعتها العلمانية التي يعيشها فيها اليهود العلمانيين والمتدينين على حدٍ سواء، مع وجود دور هامشي أو محدود للدين في مؤسسات الدولة وسياساتها. (والتوليفة الصهيونية الكلاسيكية التي حاولت الجمع في اليهودية بين الديانة والقومية قد أفلست وأفرزت ما يُسمى الصهيونية الجديدة اليمينية، ونقيضها “ما بعد الصهيونية” اليسارية من جهة والأصولية اليهودية، ونقيضتها” ما بعد اليهودية من جهة أخرى (إلياس شوفاني: دليل اسرائيل عام 2004، ص 59).
وعلى صعيد الهوية، لا تنحصر الإشكالية في “إسرائيل”، في امتناع الجمع بين يهوديتها وصهيونيتها وديمقراطيتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى أن هذه الأسس الثلاثة تستعلي على التهويد في الحالة “الاسرائيلية” الراهنة أيضًا. فمضمون اليهودية، بما هي ديانة الهية، يتناقض مع فحوى الصهيونية، كونها تنطلق من أنها حركة قومية، وكلتاها تتنافى مع الديمقراطية الأولى كونها عقيدة دينية، والثانية لكونها فكرة استيطانية عنصرية. وفي “إسرائيل” الراهنة، يستحيل فصل الدين عن الدولة، لأنها صنيعة الصهيونية التي قامت على الجمع بين الديني والأمني في منطلقاتها الأساسية (نفس المصدر السابق. ص 60).
وفي المحصلة، فإن محاولة الصهيونية الجمع بين يهودية الدولة وديمقراطيتها في إطار (قومي يهودي) حَولّت من “إسرائيل” دولة لا هي صهيونية فعلًا، ولا هي يهودية أو ديمقراطية كذلك،ِ إنها دولة بلا هوية (نفس المصدر السابق. ص 60). ومن ناحيةٍ ثانية تشير مختلف الدراسات أن “إسرائيل” ماضية نحو دولة دينية أكثر وديمقراطية أقل؛ فقد تزايدت معدلات الذين يعلنون عن أنفسهم بأنهم متدينون أو ملتزمون بالدين، وذلك بالقياس عما كان الوضع عليه قبل عدة عقود، وجمهور المتدينين لا يؤدون في معظمهم الخدمة العسكرية أو المساهمة في تَحملّ العبء الاقتصادي، وهو ما أثار المعسكر العلماني الذي كان يهمين على الدولة منذ بداية تشكيلها، ومطالبته بضرورة إشراك المتدينين في تقاسم العبء العسكري والاقتصادي، ومن ناحيتهم ينتقد المعسكر الديني النهج العلماني في الدولة والمجتمع ويطالبون بزيادة المساحة التي يشغلها الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية، وهو ما يفسر إصرار الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف على إقرار الإصلاح القضائي، لأنهم يعتبرون أن القضاء هو الحارس القوي على بقاء الطابع العلماني في الدولة، وهو المسؤول عن تحجيم دورهم والحيز الصغير الذي يشغله المتدينون في إدارة الدولة.
لقد فشلت “بوتقة الصهر” التي تبنتها الدولة في بدايات تَشّكلها؛ فمنذ بداية سبعينيات القرن الماضي أخذت تتلاشى حالة السطوة السياسية الثقافية “الإسرائيلية” العلمانية شبه الغربية”، وبدلًا منها أخذت تَّكل عدة مجتمعات أو ثقافات شبه مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، وإن كانت متعلقة الواحدة منها بالأخرى داخل الدولة “الإسرائيلية” (باروخ كيمبرلنغ – مجلة قضايا إسرائيلية: العدد 3. ص5).
ثمة عددًا من الثقافات والهويات “الإسرائيلية” المنفصلة عن بعضها البعض آخذة بالتَشكّل: الثقافة الدينية القومية – الثقافة الارثذوكسية القومية، الشرقية التقليدية، العربية “الإسرائيلية”، الروسية، الأثيوبية، وكذلك ثقافة الطبقة المتوسطة العلمانية (نفس المصدر السابق. ص 5). وصار لكل ثقافة من هذه الثقافات مؤسساتها وأحزابها ومدارسها ونواديها ومجلاتها ووسائل إعلامها الخاصة بها. وإذا كان الانقسام السياسي الحالي له جذوره التاريخية، غير أنه تَكَرس بصورةٍ حادة في العقدين الأخيرين لصالح القوى اليمينية.
وكما أسلفنا ثمة انزياح نحو اليمين يتزايد مع الوقت، وبالأخص نحو اليمين الديني، “فالصهيونية بدأت كمشروع دولة تستعمل الدين وسيلة، وبعد قرن بدأ يبدو أن المؤسسة الدينية تستعمل الدولة نفسها وسيلة، فهذه الدينامية كانت ولا تزال غير محسوبة داخل “إسرائيل” (زريق: دليل إسرائيل العام 2004، ص 32).
لقد تطورت الفكرة الصهيونية مع نشوء الدولة، ونشأ مع الوقت تياران أساسيان: الصهيونية الجديدة ينضوي تحتها الأحزاب الدينية الأرثذوكسية، والدينية القومية بعد أن عملت على صهينة الدين، وبعض الأحزاب العلمانية كحزب الليكود الذي أظهر بعض التيارات السائدة داخله عن تدين الصهيونية أما التيار الثاني، عُرف بتيار “ما بعد الصهيونية” الذي ينضوي تحته عددٍ من الأحزاب العلمانية واليسارية وبعض التيارات الفكرية والثقافية، وهذا الاتجاه يسعى إلى دمقرطة الدولة. فمنذ الثمانينات تتراكم ضغوط توجب الحسم بين دولة يهودية وبين دولة ديمقراطية، وخاصة الصهيونية الجديدة هي إيثار الدولة اليهودية، وخلاصة ما بعد الصهيونية هي إيثار الدولة الديمقراطية ” (اوري رام: ذاكرة دولة وهوية. ص 40).
وفي المحصلة، فإن الأزمة السياسية الحالية في الدولة الصهيونية، لها جذورها التاريخية الكامنة المُتمثّلة في الانقسام بين مكونات المجتمع الصهيوني، والذي تطور مع الوقت ليأخذ شكل معسكرين منقسمين عموديًا بصورةٍ حادة، ومتصارعان على تشكيل هوية الدولة، وبين الحين والآخر كانت تبرز أزمات بسبب ذلك الصراع، غير أنها لم تكن تُشكّل ذلك الخطر الذي من شأنه أن يهدد الدولة ومستقبلها. غير أن حالة الاستعصاء السياسية السائدة منذ أربع سنوات، قد أوجدت الأرضية لقرار الحسم ومن ناحية القوى اليمينية، وجدت الفرصة سانحة بعد نجاحها بتشكيل الحكومة اليمينية بالكامل، لإحداث انقلابٍ جذريٍ في بنية الدولة، يتيح لها تطبيق أجندتها في تقليص الحيز الديمقراطي، وتوسيع الحيز اليهودي، وما يضمن لها تعزيز قوتها في مؤسسات الدولة، وضمان بقائها لأطول فترة في الحكم. وقد فوجئت القوى اليمينية المُشكّلة للائتلاف بحجم الاحتجاجات واتساعها، بعد تداعي القوى العلمانية والليبرالية واليسارية للدفاع عن وجودها ومصالحها، معُتبرة أن مشروع الدولة الصهيونية والانجازات التي تحققت طوال العقود الماضية، ما هو إلا ثمرة جهودها وارثها التاريخي، وأن القوى اليمينية تقامر في مستقبل الدولة، وإن ما تعتزم إقراره من قوانين يمس أسس الدولة والنظام القائم، والنتيجة دخول الدولة العبرية في مرحلة الصراعات التي قد تقود إلى حربٍ أهليةٍ طاحنة.
ومن المفيد الانتباه أن مئات الآلاف من المحتجين، يهتفون منذ أكثر من ثلاثة شهور بهتافات تنم عن القلق من تَحولّ “إسرائيل” إلى دولة دكتاتورية والكلمة التي تتردد على ألسنتهم طوال الوقت (ديمقراطية.. ديمقراطية) وهذا الهتاف يلخص التناقض بين الهويتين المتصارعتين: اليهودية والديمقراطية.
* عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كاتب وأديب وشاعر، ومفكر