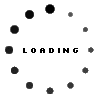Права людини... відсутній наріжний камінь досвіду громадянської держави...!!
Звіт: Абделькадер Джаз
Опубліковано в журналі Masarat Magazine - Судан - 10/3/2025
15\10\2025
У регіоні, роздираному політичними, економічними та безпековими конфліктами, дебати щодо «громадянської держави» залишаються центральним варіантом для країн Близького Сходу та Африканського Рогу, щоб уникнути регіонального та міжнародного втручання. Однак такий підхід зазвичай обмежується формальними рамками, які забезпечують міжнародну легітимність, і не сприяє побудові справжніх інституцій, що захищають права та гарантують громадянство.
Тут виникає найважливіше питання: чи може громадянська держава перетворитися з простого політичного гасла на інституційну реальність, присвячену справедливості та свободі, чи вона залишиться фасадом для поглинання внутрішнього та зовнішнього тиску без суттєвих реформ?
Маргіналізація є помітною рисою:
Вона сказала Єгипетський дослідник, що спеціалізується на африканських справах, професор Ніхад Махмуд, Звуження політичного дискурсу на Близькому Сході та в регіоні Африканського Рози до ідеї громадянської держави відображає пошук цими країнами золотої середини, яка б збалансувала необхідність уникнути домінування релігійних та військових рухів, водночас надаючи їм видимість легітимності на внутрішньому та міжнародному рівнях, не беручи на себе глибоких зобов'язань щодо прав людини чи побудови міцних громадянських інституцій. Вона зазначає, що складні безпекові, економічні та політичні контексти спонукають ці країни використовувати дискурс громадянської держави як інструмент для зменшення етнічних та релігійних розбіжностей та створення прийнятного іміджу для міжнародної спільноти, яка часто пов'язує допомогу з існуванням цієї громадянської форми.
Однак, вона вважає, що ця пропозиція залишається недосконалою, якщо її не поєднати з фундаментальними реформами, які посилюють незалежність судової влади, зміцнюють громадські свободи та захищають політичні та соціальні права, як основу будь-якого справжнього проекту держави прав та громадянства. Вона додає, що успіх будь-якого громадянського експерименту в регіоні залишається залежним від його здатності зробити права людини невід'ємною частиною конституційної та законодавчої структури. В іншому випадку концепція громадянської держави стане лише символічним гаслом або пропагандистським фасадом для поглинання внутрішнього та зовнішнього тиску, не призводячи до реальних змін у стосунках громадянина з його державою. Вона вважає, що нинішні умови збройних конфліктів, економічних криз та регіональної напруженості роблять успіх цих експериментів надзвичайно складним, оскільки багато режимів досі закріплюють концепцію «традиційної безпеки», пов'язаної з виживанням влади, водночас маргіналізуючи основні права, які є наріжним каменем сталої стабільності.
Справжні реформи не нав'язуються ззовні:
Ніхад наголосив, що будь-який серйозний громадянський проект повинен вийти за рамки цього вузького бачення безпеки та прийняти ширший підхід, який включає збереження людської гідності, гарантування громадянських, політичних та соціальних прав, а також встановлення громадянства як комплексної системи, що виходить за межі сектантських та етнічних розбіжностей. Тільки тоді громадянська держава може перетворитися з політичного гасла на стійку інституційну реальність.
Щодо ролі міжнародних та регіональних втручань, Ніхад пояснила, що вони мають подвійний вплив, іноді сприяючи прискоренню процесу реформ шляхом підтримки миробудівництва, зміцнення судової системи або допомоги у розробці конституцій, які поважають принципи прав. Однак вони часто уповільнюють або переривають цей процес, особливо коли пов'язані з суперечливими порядками денними держав, що втручаються. Вона наголосила, що справжня реформа не може бути нав'язана ззовні, а має йти зсередини, керуючись справжньою місцевою політичною волею. В іншому випадку вона залишатиметься крихкою та вразливою до краху, оскільки баланс сил змінюється. Вона додала, що майбутнє держави, що базується на правах, на Близькому Сході та в країнах Африканського Рози залежить від здатності місцевих суб'єктів використовувати ці втручання та перетворювати їх на конструктивні партнерства, що просувають національні пріоритети, а не стають інструментом опіки чи політичного та військового впливу. Вона вважає, що шлях до держави, що базується на правах, вимагає політичної мужності та комплексного бачення, яке виходить за межі вузьких розрахунків влади та охоплює комплексний національний проект.

Політична тиранія – це патологічне явище:
Я підтвердив Д-р Саміра Ібрагім, єгипетська журналістка та дослідниця з питань Африканського РогуУчасть в управлінні та веденні державних справ є фундаментальним правом усіх громадян, що ґрунтується на принципах справедливості, рівності та збереження людської гідності. Однак, за її словами, це право часто монополізується певними групами, перетворюючи його на інструмент політичної тиранії, що перешкоджає розвитку потенціалу суспільств. Описуючи тиранію як патологічне явище, яке вразило як давні, так і сучасні системи правління, вона розрізняла класичну тиранію та специфіку сучасної тиранії, яка характеризується стійкістю, складністю її ліквідації та нездатністю дозволити встановлення раціональних моделей управління, що відповідають прагненням людей та сприяють справжньому розвитку. Вона пояснила, що проникнення тиранії в арабський регіон та на Близький Схід призвело до раннього підриву статусу особи та втрати довіри до держави, що свідчить про те, що нездатність держав покращити якість життя та досягти процвітання є одним із її найвизначніших наслідків. Вона зазначила, що коріння збереження цього явища лежить у культурі авторитаризму та патріархату, а також у широко поширеній корупції та нецільовому управлінні багатством, а також у наслідковій бідності, маргіналізації та невігластві, що відкриває шлях до проявів насильства та конфліктів. Вона додала, що офіційні режими несуть пряму відповідальність за ці умови, оскільки протягом десятиліть не змогли досягти відчутних трансформацій. Це робить будь-яку реальну реформу залежною від зміни самої природи управління та переходу від патерналістської або опікунської моделі до системи, легітимність якої базується на народних мандатах, вільних та чесних виборах, і яка підлягає ефективному парламентському контролю. Водночас вона попередила, що авторитарні режими часто перешкоджають можливостям для мирного переходу, посилюючи потенціал для сповзання до насильства та контрнасильства.
Приватизація та скорочення привілеїв:
У цьому ж контексті д-р Саміра зазначила, що країни регіону переживають глибокі трансформації під впливом глобалізації та глобальної економічної політики, яка штовхає до приватизації та скорочення соціальних привілеїв. Вона пояснила, що ці трансформації, незважаючи на те, що деякі країни демонструють стійкість у протистоянні з ними, часто служать інтересам правлячих еліт, які використовують свій контроль над владою як інструмент для забезпечення свого виживання, а не як засіб досягнення демократичних змін.
Вона додала, що поєднання політичного авторитаризму та глобального економічного тиску створює середовище з подвійними викликами. З одного боку, це обмежує політичну участь та перешкоджає появі альтернативних еліт, здатних до реформ. З іншого боку, це послаблює суспільний договір між державою та суспільством, скорочуючи послуги та привілеї, що збільшує крихкість внутрішньої стабільності. Саміра вважає, що подолання цієї дилеми вимагає переосмислення відносин між державою та суспільством на основі прозорості, підзвітності та соціальної справедливості, щоб приватизація була не засобом підриву прав, а радше основою для підвищення економічної ефективності та одночасного захисту вразливих груп. Вона наголосила, що будь-який процес реформ не буде успішним, якщо він не буде поєднаний зі справжньою політичною волею, яка ставить громадянство та участь населення в основу політичного та економічного процесу.
Перевантажений політичний простір:
Я визнаю Д-р Саїд Саллам, директор Центру стратегічних досліджень Vision в Україні, Політичний простір у регіоні залишається обтяженим авторитарною спадщиною. Гасло «громадянської держави» висувається не як дорожня карта до справедливості, а радше як тимчасовий прапор у битві референцій. Він розглядав його як лише фасад, що полірує поверхню, уникаючи заглиблення у складні корені: свободи, незалежну судову систему та активну громадянську позицію. Він пояснив, що політичні еліти часто вирішують залишатися на узбіччі битви, уникаючи підриву мін, що ховаються глибоко всередині реформ, так що «громадянська» зрештою стає символічною завісою, за якою ховається відсутність відданості побудові держави, яка є підзвітною та не ухиляється від ухилення, і яка закріплює права, а не відкладає їх.
Безплідна земля прав:
Саллам зазначав, що цивілізованість не приносить плодів у країні, позбавленій прав. Держава, яка не зміцнює своїх громадян конституцією, що їх захищає, подібна до дерева без коріння: вона може тимчасово цвісти, але їй загрожує вирватися з корінням за першої ж бурі. Він наголошував, що легітимність походить не від форми правління, а від глибини суспільного договору, який перетворює державу з контролюючої влади на гаранта, а з процедурного управління на колективну свідомість. Він вважав, що відсутність цієї гарантії відкриває шлях до відтворення тиранії в нових образах, перетворюючи державу на крихку структуру, яку переслідує привид імплозії.
Переробка воронки:
Саллам говорив про іноземні інтервенції, порівнюючи їх з вогнем: вони освітлюють шлях, якщо їх мудро спрямувати, але вони випалюють землю, якщо їх використовувати для вузьких цілей. Якщо їх пов'язують з підтримкою, обумовленою повагою до прав людини, вони стають важелем змін, зміцнюючи громадянське суспільство та підтримуючи підзвітність. Однак, якщо їх використовують як привід для підживлення репресивних режимів в ім'я стабільності, вони лише повторюють гноблення та продовжують період плутанини. Тут, додав він, держава стає ареною конфлікту між внутрішньою волею та зовнішніми інтересами, а проект побудови держави прав стає схожим на спробу посадити троянду в ґрунт, политий порохом.