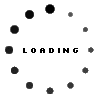Палестина між бездіяльністю історії та націоналізмом
Читання книги Шломо Санд: Винахід єврейського народу

Махмуд Аль-Саббах - письменник і перекладач
Цей текст було написано 29 лютого 2020 року.
Час від часу ми читаємо в ізраїльських газетах, особливо в «Гаарец», статті, в яких висловлюється жаль з приводу того, що «палестинські історики» пишуть про Ізраїль, спираючись на давню історію Палестини. Кілька років тому з'явилося важливе дослідження Моті Голані та Аделя Манни, в якому обговорюється, як «інший» вилучається з сучасної історії, коли йдеться про війну 1948 року. Те, що є історією для однієї сторони, не є історією для іншої (Дві сторони медалі: Незалежність і Накба 1948. Два наративи війни 1948 року та її результат [англо-івритське видання]. 2011).
Недалеко від цієї атмосфери знаходиться книга Шломо Санда («Винайдення єврейського народу»), яка вийшла 2008 року. Пізніше книгу було перекладено французькою та англійською мовами (книга отримала Французьку премію за найкращу нехудожню книгу року 2008). Переклад арабською мовою був відкладений до 2011 року, коли Палестинський центр ізраїльських досліджень (Мадар) опублікував його в перекладі Саїда Айяша з передмовою автора.
Його основна теза полягає в тому, що «не існує чистої єврейської національності чи єдиного єврейського народу, етнічне та біологічне походження якого сягає єдиного кореня, як стверджує сіоністська думка. Існує єврейська релігія та її послідовники, які належать до різних та віддалених національностей, етнічних груп та географічних регіонів, і вони пов'язані лише своєю приналежністю до цієї релігії, як це відбувається з християнами, мусульманами та іншими в минулому та сучасному житті. Сіоністський проект, насіння якого розвинулося в дев'ятнадцятому столітті під впливом німецького націоналізму та виникнення й глибокого вкорінення епохи націоналізму в Європі, створив і винайшов єврейську національність, копіюючи європейський досвід, якого не існує з історичної та наукової точки зору». Іншими словами, модель націоналізму, яку проголошує сіоністський рух, є не що інше, як аномальна, амебна модель, що базується переважно на міфічній ілюзії, просякнутій реакційними та расистськими ідеями, далекій від будь-якого реального «історичного» значення, і в якій релігійні почуття змішуються з націоналістичними амбіціями, створюючи гібридну суміш, що чіпляється за заяви про повернення до давньої батьківщини та обіцяної землі, засновані на релігійних текстах: «Того дня Господь уклав угоду з Аврамом, кажучи: «Нащадкам твоїм Я даю цю землю від річки Єгипетської до великої річки, річки Євфрат, кенеїв, кенізейців, кадмонейців, хеттеїв, періззеїв, амореїв, ханаанейців, гіргашеїв та євусеїв» (Буття 15:18-20). Сіоністський проект, як його бачать «нові історики», є проектом, який несе багато побоювань, що він буде руйнівним для тих, хто належить до юдаїзму. Можливо, саме це пояснив Бенні Морріс, одна з найважливіших постатей цих істориків, коли сказав: «Увесь сіоністський проект є есхатологічним проектом.» Це відбувається у ворожому середовищі. У певному сенсі, його існування було нелогічним для його успіху в 1948 році, і нелогічно, щоб він досяг успіху зараз. Однак воно досягло того, чого досягло. Іншими словами, у цій справі є диво. Знищення може бути кінцем цього процесу, і саме це мене лякає».
Після створення держави сіоністська суспільна думка прийняла постсіоністські націоналістичні домовленості відповідно до змін у політичній системі та її поточних процесів з метою побудови національної держави з єврейською більшістю, базовою основою якої була громада єврейських колоністів у Підмандатній Палестині. А ще є громада поселенців на територіях, окупованих у 1967 році, яку екстремісти ізраїльських правих люблять називати «серцем Землі Ізраїлю», посилаючись на «месіанські» релігійні наративи. Викуп землі та «звільнення» її від відчуження є передумовою для визволення єврейського народу. Таким чином, юдаїзація Західного берега, а потім і Східного берега річки Йордан є основною умовою визволення єврейського народу. Це «божественна» місія, змішана з політичним прагматизмом, висловлена Джозефом Вайтнером, представником «Єврейського агентства» та особою, відповідальною за поселення, коли він наголосив, що сіоністський рух на початку Другої світової війни на початку 1940-х років дійшов висновку, що в цій «країні» немає місця для обох народів (арабів та євреїв) разом, і що для досягнення сіоністських цілей необхідно створити державу на захід від річки Йордан, в якій не буде арабів. Тому, за його словами, було необхідно «переселити арабів звідси та з сусідніх країн... переселити їх усіх, і після завершення цього процесу переселення (сіоністська держава) зможе поглинути мільйони наших братів». (Давар: 29 вересня) 1967)
Книга «Винайдення єврейського народу» з моменту своєї публікації стала джерелом широких суперечок як з боку прихильників, так і з боку опонентів. Це лежить в основі культурної пам'яті про «єврейське релігійно-національне» існування в Палестині. Хоча воно й намагається дестабілізувати цю міфологізовану структуру, воно, своєю чергою, зіткнулося з шквалом заперечень, які не припиняються й донині. Зрозуміло, що ми нелегко відмовляємося від своєї культурної пам'яті, що пояснює таку бурхливу реакцію на книгу в Ізраїлі, де багато ізраїльських читачів (і нечитачів) вважають її, мабуть, найгіршою книгою, опублікованою з часів створення держави. Це не означає, що книга погана в буквальному сенсі, або тому, що Санд не має рації у своїх словах, а радше тому, що Шломо Санд певним чином кинув виклик престижу влади/пам'яті в Ізраїлі, коли виступив проти офіційного авторитарного наративу культурної пам'яті, який базується на суміші фанатичної та етноцентричної релігійної думки, текстів Тори та єврейської релігійної теології, що користується підтримкою як єврейських, так і християнських віруючих громад. Сам Санд прокоментував це, сказавши: «Після багатьох років використання таких виразів, як «єврейський народ» та «єврейський націоналізм», протягом понад чотирьох тисяч років, нелегко прийняти таку книгу, як моя». Тут ми маємо право поставити питання: чи повинен інтелектуал бути представником цього стародавнього суспільства, тобто стародавнього Ізраїлю, який колись існував у Палестині? Навіть у цей час в академічних колах точаться значні дебати щодо того, чи є стародавній Ізраїль «історичним» фактом, чи просто дивним вигадкою, яка не має жодного зв'язку з історією стародавнього Сходу.
Санд каже про свою книгу: «У своїй книзі «Винайдення єврейського народу» я спробував пояснити, як сіоністський рух сфабрикував для євреїв фальшиву історію, засновану на ідеї єврейського народу. Я показав, що це хибна ідея та міф, які використовувалися для виправдання ізраїльської окупації палестинських територій та для ведення воєн проти арабських країн». Головна теза цієї книги полягає в тому, що єврейського народу в загальноприйнятому та поширеному розумінні не існує. Є різні єврейські народи з різними культурами. Спільним знаменником між ними є те, що вони практикують однакові релігійні ритуали та обряди. В антропологічному та соціологічному (соціальному) сенсі народ – це термін, що використовується для позначення людської групи, об'єднаної спільною культурою, такою як: мова, література, музика та інші культурні умови. Це не стосується єврейського народу, який був вигаданий сіоністським рухом. Між євреями Німеччини та євреями Іраку чи Марокко немає спільної культури, а це означає, що єврейські громади жили в межах різних національних культур залежно від країни, в якій вони проживали. З іншого боку, існує додаткова умова, яка визначає поняття народу, а саме походження від єдиного коріння. У зв'язку з цим сіоністські історики також поширюють інший міф, який стверджує, що Палестина — це земля євреїв, і що вони були вирвані з неї римським імператором Титом у 67 році нашої ери. Це помилкове переконання, оскільки немає переконливих історичних чи наукових доказів, які б його підтверджували. Таким чином, книга є подорожжю в давню історію, в якій автор заглиблюється в тисячі років за допомогою детальної аргументації, в якій він доводить, що євреї, які живуть сьогодні в Ізраїлі та інших частинах світу, зовсім не є нащадками «давнього народу», який жив у «Царстві Юдеї» в період «Другого Храму». За його словами, їхнє походження сягає корінням у різні народи, які протягом історії наверталися до юдаїзму в різних частинах Середземноморського басейну та навколишніх регіонів. Сюди також входять євреї Ємену (залишки Хім'яритського королівства на Аравійському півострові, які прийняли юдаїзм у четвертому столітті нашої ери) та євреї-ашкеназі Східної Європи (залишки Хозарського королівства, які прийняли юдаїзм у восьмому столітті нашої ери). На відміну від інших «нових ізраїльських істориків», які прагнули підірвати припущення сіоністської історії, Санд у цій книзі не обмежується 1948 роком чи початком сіоністського руху наприкінці ХІХ століття. Швидше, він повертається на тисячі років назад, намагаючись довести, що єврейський народ ніколи не був «расовим народом» зі спільним походженням, а радше великою та різноманітною сумішшю людських груп, які прийняли юдаїзм на різних етапах історії. За його словами, міфологічний погляд на євреїв як на стародавній народ призвів до прийняття низки сіоністських мислителів повністю расистської ідеології. «У Європі були часи, коли якщо хтось казав, що всі євреї належать до народу неєврейського походження, таку людину одразу ж називали антисемітом», — каже Сенд. «Сьогодні, якщо хтось наважиться сказати, що ті, кого вважають євреями у світі (…), ніколи не становили народу чи національності, і що вони досі ними не є, то ми одразу ж побачимо, що його називають ненависником Ізраїлю». Він вважає, що опис євреїв як переміщеного та ізольованого народу вигнанців, які «жили у переміщенні та мандрували крізь час та континенти, досягаючи краю землі, і зрештою, з появою сіоністського руху, масово повернулися на батьківщину, з якої їх було переміщено», є не що інше, як відвертий «націоналістичний міф». Він додає: «У певний момент дев’ятнадцятого століття інтелектуали єврейського походження в Німеччині взяли на себе зобов’язання ретроактивно винайти народ, виходячи з непереборного бажання створити сучасну єврейську національність».
Але що це означає?
Головний аргумент книги про те, що не існує єврейської національності (єврейського народу), не слід розуміти як заперечення євреїв, їхніх вірувань, світогляду чи їхньої історії. Він розглядає юдаїзм як релігію, подібну до християнства та ісламу, транснаціональну релігію, яка не обмежується чи не замежується певною національністю чи «етнічною приналежністю». Якщо євреї справді були «народом», то що спільного мають етнографічні компоненти єврея в Києві та єврея в Марокко, окрім релігійних вірувань та деяких релігійних практик? (с. 43). Але з дев'ятнадцятим століттям і початком ери націоналізму, під впливом німецького націоналізму, сіоністський проект сіонізував юдаїзм на користь національного проекту, який згодом мав створити свою державу в Палестині, поєднуючи релігію, етнічну приналежність та національність у складну структуру, ретроактивно виводячи свої націоналістичні виправдання з релігії, минулого та історії. Таким чином, сучасний Ізраїль «є політичним проектом, який був уявлений наприкінці дев'ятнадцятого століття, став реальністю через Голокост, а потім був заснований у 1948 році». Якщо історія — це передусім історія часу її написання, як цитує Санд фразу італійського філософа Бенедетто Кроче (с. 310), то палестинська історія, або історія Палестини, все ще коливається — на думку Санда — між навмисною бездіяльністю та орієнталістською націоналістичною марнославством, коли вона пропагує ідею про те, що араби повинні визнати Ізраїль не як державу «єврейського народу», а як державу всіх ізраїльських громадян, які проживають у ній, незалежно від їхнього походження чи релігії (с. 10 вступу). Санд вважає, що написав свою книгу з двома цілями: «По-перше, як ізраїльтянин, демократизувати державу та зробити її справжньою республікою, а по-друге, виступити проти єврейського фундаменталізму». Він також каже: «Якщо в минулому не було єврейського народу, а сьогодні немає єврейської нації, то існування сіоністських поселень створило два народи на Близькому Сході. «Сьогодні є палестинський народ, який люто бореться за свою свободу та решту своєї батьківщини, і є ізраїльський народ з мовою та культурою, яких не поділяє ніхто у світі, хто визначає себе як євреїв» (с. 10, вступ). Тут Санд намагається виписати «Ізраїль» з історії Палестини, якщо взяти метафоричний вислів данського дослідника, що спеціалізується на історії давньої Палестини, Нільса Петера Ламке. Все, що можна назвати історією, є не що інше, як історія, яка була вигадана тим чи іншим чином, або в кращому випадку це культурна пам'ять із суспільним характером. Коли існує більше ніж одна група, окрім групи, яка існує в даному суспільстві, ми можемо припустити існування більше ніж однієї культурної пам'яті. Якщо ми розширимо це і припустимо існування конфлікту між групами, логічно зробити висновок, що переможець — це той, хто вирішить, яка з цих пам'яток є «правильною», яку слід записати. і викладається учням шкіл. Можливо, це питання спонукатиме історика заперечити, оскільки він більше, ніж інші, здатний знати «правильну версію», але, на жаль, схоже, що історики насправді цього не роблять. Вони, як правило, більше цікавляться історичними «фактами», можливо, тому, що не здатні контролювати спогади. Або тому, що, з іншого боку, вони представляють політичну владу та її вибір, незалежно від того, що люди можуть вважати «історією».
«Хоча Ізраїль народився через створення жахливої катастрофи для місцевого населення, у регіоні створена реальність, повне заперечення якої призведе лише до нових катастроф». с. 10. «Це спонукало відомого мислителя, такого як Ерік Гобсбаум, сказати, що книга Шломо Санда «є необхідною вправою у випадку Ізраїлю, щоб розвіяти історичний націоналістичний міф і закликати до Ізраїлю, в якому всі його мешканці мають рівні права».
У вступі до книги Санд намагається чітко донести до своїх арабських читачів, що він підтримує права палестинського народу і що цьому народу заподіяно кривду, але це не означає, що він покине будинок, у якому зараз живе, навіть якщо він стоїть на руїнах палестинського села чи міста. Він продовжує цю саму твердження протягом чотирьохсот сторінок, з яких складається його книга. Я майже стверджую, що я, як палестинець, не є важливим, великим чи малим, і для мене не перемога, що ізраїльський історик чи археолог визнає марність пошуків історій про отців, пророків і царів Старого Заповіту в Палестині. Така дискусія є суто академічною, обмеженою вузьким колом читачів і рідко виходить за його межі. Однак, це відбувається в рамках методологічного контексту пошуку виходу зі структурної кризи сіоністського проекту, що свідчить про те, що ці дебати все ще скуті сіоністськими пелюшками, навіть якщо вони використовують різні ярлики, такі як «нові історики» чи «постсіоністська думка». Тому найкраще, що може зробити Ізраїль, каже Санд, це визнати, що його нація є вигаданою нацією, яка, стверджує Санд, повинна реформуватися, оскільки держава належить усім її громадянам, незалежно від того, євреї вони чи араби. Таким чином, Санд деконструює дискурс ідентичності, визначаючи сіонізм як екстремістський, етнічно орієнтований націоналістичний рух, який зміг здійснити свій історичний проект, окупувавши землю, вигнавши людей та ізраїлізувавши їх. світового єврейства, таким чином зміцнюючи формування однорідної ідентичності в майбутньому через процес «зростання етнізації в політиці ідентичності протягом 1970-х років – на хвилі контролю над широкою громадськістю, який почав становити шалену загрозу в ізраїльській національній уяві» (с. 303)
Загальний клімат, у якому Санд писав свою книгу, є частиною атмосфери, що домінувала в ізраїльських академічних колах у період після першої палестинської інтифади, що спалахнула в 1987 році. Ізраїльські письменники розпочали процес «модерністської» критики сіоністського руху, його ідеології та суті його проекту в регіоні, розбираючи кризи, від яких страждає Ізраїль, прагнучи створити формули для оновлення цієї ідеології та її реконструкції таким чином, щоб забезпечити її увічнення. Деякі з них визнають, що ізраїльська присутність на Західному березі річки Йордан та в секторі Газа є «окупацією». Коли ці люди розглядають поняття «як світ», з контексту їхніх слів стає зрозуміло, що, окрім Ізраїлю, світ стосується Європи та Америки, а оточення Ізраїлю – це близькосхідні утворення та країни, що є нечітким виразом, у якому домінує радше політична географія, ніж історико-соціальні категорії. Таким чином, ці утворення не піднімаються до рівня приєднання до «глобального» клубу, і ці утворення набувають значення лише тоді, коли дискусія обертається навколо питань безпеки, економіки, ринку та «демократії». Саме це проявляється в сіоністському дискурсі з моменту його заснування, наслідки чого підкреслюються використанням орієнталістських інструментів для визначення та ідентифікації іншого. Таким чином, ці ізраїльські академічні кола, а також багато хто з тих, хто цікавиться справами Близького Сходу, охоплені одержимістю, схожою на шаленство, яке опановує їхні розуми, аби переписати палестинську історію.
Сіоністська модель у Палестині постає як чужорідне тіло, що ґрунтується на територіальних претензіях націоналістичного характеру, нав'язуючи реальність, яка прагне змінити багато аспектів та проявів, властивих єврею, яким він був відомий Європі до другої половини ХХ століття. Таким чином, сіонізм прагнув створити історичний зв'язок між єврейськими громадами світу та Палестиною, використовуючи біблійний текст та освячуючи його як всеохопний, лінійний, незворотний історичний текст, який гарантує зв'язок єврея з цією землею як землею безперервної божественної обіцянки давнім євреям, а після них і сучасним євреям – як спадкоємцям і нащадкам євреїв – таким чином легітимізуючи колонізацію країни таким чином, що не приймає тлумачення права євреїв на країну.
Сіонізм спирається на це через «факти» [історичні та релігійні]. Однак, що помітно в історичному підході, так це те, що факти, які він прагне довести, не є остаточними та завжди підлягають сумнівам та змінам, модифікаціям, інтерпретаціям та контрінтерпретаціям. Вони суперечать «релігійній істині», яка не змінюється, навіть якщо змінюється її контекст, а інтерпретації відрізняються. Загальновідомо, що релігійна істина не має нічого спільного з її суперечностями «історичним фактам», будь то археологічні, історичні чи інші докази. Отже, ця релігійна істина, яка по суті знаходиться поза часом і простором, і всі історії, що містяться в ній, є правдивими та правильними і залишаться такими, підтверджуватиме твердження євреїв про те, що юдаїзм є їхнім виключним правом, а Бог є виключним правом племені дітей Ізраїля. Тут ми бачимо дуже важливе питання. Хоча визначення юдаїзму як «монотеїстичної релігії» несе релігійне послання для всього людства, діти Ізраїлю протягом століть наполягали на тому, що єврейська релігія виникла виключно та виключно для дітей Ізраїлю і ні для кого іншого. Вони не перетворили юдаїзм з універсальної монотеїстичної релігії на племінну та квазіетнічну релігію, як деякі стверджують. Але це справді так, якщо ми візьмемо за орієнтир ці п'ять книг. Немає жодних ознак того, що Господь, який явився Аврааму, Ісааку, Якову та Мойсею, є Господом усіх людей (Вихід 22:20, Буття 17:7-8, Вихід 6:7, Вихід 34:14, Вихід 20:3-5). Швидше, є підтвердження того, що цей Бог є Богом євреїв і Богом дітей Ізраїля та їхніх нащадків. Тора, зі свого боку, не була опублікована, доки не поширилася релігія та усвідомлення єдності Бога серед інших народів.
У другому розділі автор обговорює своє відкриття про те, що єврейські письменники протягом понад вісімнадцяти століть не написали вичерпної історії свого минулого, незважаючи на давність своєї релігії. Жодної історії їхньої релігії не з'явилося до початку вісімнадцятого століття, і що початки написання єврейської історії в сучасну епоху не характеризуються чітким націоналістичним дискурсом. Концепція «єврейської нації» не виникла чітко аж до другої половини ХІХ століття, коли почали формулювати національну історію, вигадавши ідею про те, що євреї існують як народ (нація) окремо від своєї релігії. Перші томи «Історії євреїв від найдавніших часів до наших днів» історика Генріха Греца були опубліковані в німецькому місті Лейпциг у 1950-х роках. Ця робота мала значний вплив на формування сіоністської ідеології та відіграла важливу роль у формуванні національної ідентичності євреїв у майбутньому.
Грац доклав величезних зусиль, щоб вигадати єврейський народ, і його робота відіграла незаперечну роль у формуванні національного стилю написання єврейської історії. У цьому розділі Санд розглядає всі дослідження та праці, які мали на меті представити історію євреїв. Він стверджує, що перші піонери в цій галузі не представляли себе як єврейські націоналісти, а радше розглядали дослідження єврейського минулого та висвітлення його позитивних аспектів як додатковий засіб налагодження зв'язків для інтеграції своєї єврейської громади в європейські суспільства, в яких вони жили. Тобто, вони вважали себе євреями лише тому, що сповідували певну релігію, але для зміцнення абстрактного почуття відданості групі нація, як і релігійна спільнота до неї, потребувала ритуалів, свят, урочистостей та міфів. Для того, щоб ця група могла визначитися та розчинитися в єдине, міцне утворення, їй потрібна була постійна публічна культурна діяльність, окрім винайдення єдиної колективної пам'яті, чим і займалися багато ізраїльських істориків на початку ХХ століття.
У третьому розділі автор намагається деконструювати ізраїльські міфи. Він вважає, що вигнання було одним із фундаментальних стовпів, які ефективно сприяли створенню та винаходу міфу про єдиний єврейський народ. Вигнання, про яке тут йдеться, стосується того, чого зазнали євреї в період після зруйнування Храму в 70 році нашої ери. А далі відбулося вигнання та викорінення вірних євреїв з Єрусалиму та їх розсіювання по всій землі. Таке визначення вигнання є найбільш прийнятною моделлю та сприяло формуванню сучасної ізраїльської національної свідомості та колективної пам'яті. У дослідженні цієї книги щодо істини щодо самого вигнання, заснованому на багатій римській документації, важко помітити навіть незначну натяку на таке масове вигнання з «землі Юдеї». Це також вказує на те, що з суто економічної точки зору взагалі не було потреби у вигнанні, а саме: римський чи ассирійський окупант потребував мас єврейських фермерів та платників податків, тому вигнання такого масштабу стало б для цього окупанта певною економічною катастрофою. Посилаючись на те, що Мілковський згадував про термін «перенасичення» або вигнання в період між першим і третім століттями нашої ери, вищезгаданий термін стосується стану маргіналізації та політичної ізоляції, а не викорінення та переміщення з країни, як це пропагувалося, і таким чином він розриває зв'язок між концепціями політичної ізоляції, що характеризується вигнанням, та операціями з викорінення, яким піддавалися євреї.
Сенд каже, що немає єврейського вигнання... і найкраще, що Ізраїль може зробити, це визнати, що він вигадана нація. Він насміхається з того, як сіонізм зміг розвинути свою ідеологію навколо концепції «Землі Ізраїлю», яку він вважає зброєю, що дозволяє йому не лише захопити землю історичної Палестини, а й захопити землю, на якій кордони Ізраїлю простягаються від Нілу до Євфрату..!! Санд пояснює, як сіоністський рух очолив проект єврейського націоналізму, перетворивши юдаїзм на щось подібне до німецького націоналізму, заперечуючи існування єврейського народу та вважаючи це не більш ніж «міфом», на якому була заснована Держава Ізраїль. Він також доводить хибність концепції «єврейського народу», стверджуючи, що руйнування римлянами Другого Храму не призвело — всупереч тому, що деякі стверджують — до їхнього вигнання римлянами. Не доведено, що римляни вигнали цілі народи, а євреї були присутні в той час у великій кількості в інших громадах Персії, Єгипту, Малої Азії та інших місць, що означає, що ця концепція є фундаментально хибною.
У своєму обговоренні того, як виник термін «Земля Ізраїлю», автор порушує низку питань про те, як (палестинська) земля перетворилася на національну батьківщину для євреїв, на якій люди готові жертвувати собою заради неї. Найважливіше питання: чи є [Земля Ізраїль] історичною батьківщиною єврейського народу? Автор відповідає на це питання негативно, вважаючи, що сіонізм викрав релігійний термін «Земля Ізраїлю» та перетворив його на геополітичний термін, наголошуючи, що Земля Ізраїлю не є батьківщиною євреїв, і що вона була перетворена на їхню батьківщину лише наприкінці ХІХ століття та на початку ХХ століття з виникненням сіоністського руху, який закликав до цього твердження, відповідно до того, до чого закликав Мойсей Гесс у своїй книзі («Рим і Єрусалим»), що єврейська проблема полягає у відсутності національної батьківщини для євреїв. Суть сіоністської думки виражена в тому, що стверджується в «Декларації незалежності» (14 травня 1948 року): «Єврейський народ виник у Землі Ізраїлю, і в ній удосконалилася його духовна, релігійна та політична ідентичність. У ній вони вперше жили в суверенній державі. У ній вони створили свої культурні, національні та людські цінності та заповідали всьому світу безсмертну Книгу Книг. Коли єврейський народ був насильно вигнаний зі своєї країни, вони зберегли свій союз з нею, навіть у землі свого вигнання, і ніколи не переставали молитися та чіплятися за надію повернутися до своєї країни та відновити там свою політичну свободу».