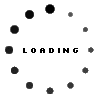“الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر”… خدعة روّج لها النظام العربي

ماجد كيالي – كاتب سياسي فلسطيني
11/10/2023
أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر تحققت بفضل الأنظمة العربية “المقاومة”، التي أحكمت بقبضة حديدية على الدولة والجيش والموارد، حولت الجيش من أداة لخلق التوازن في القوى إلى سلاح بمواجهة الشعب.
كشفت الحرب الجارية في غزة أن أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر مجرد خديعة كبرى، أو أسطورة، ساهمت الأنظمة العربية الاستبدادية في صنعها، لحاجتها الى وجود إسرائيل كي تبرر طبيعتها التسلّطية، وهيمنتها على موارد بلدانها، وتغييبها مجتمعاتها، ومصادرتها حقوق “مواطنيها” وحرياتهم، وأيضاً كي تبرر عجزها ولامبالاتها بمواجهة التحدي الذي مثّلته إقامة إسرائيل في هذه المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني، ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما من النواحي السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية أيضاً.

منذ البداية، استثمرت الأنظمة العربية في ترويج إسرائيل كذبة أنها عرضة لتهديد وجودي، وأنها واجهت جيوش دول عربية عدة في وقت واحد (1948)، لكن مراجعة بسيطة تبين أن معظم الدول العربية بالكاد نالت استقلالها في ذلك الزمن، وبالكاد توجد جيوش مؤهّلة، فالجيش الأردني، مثلاً، كان بقيادة الجنرال غلوب، مع عشرات الضباط الإنكليز.
يذكر المؤرخ وليد الخالدي في كتابه “تقسيم فلسطين من الثورة الكبرى… إلى النكبة” (ص 181 ـ 191)، أن مجموع عديد قوات الجيوش العربية (من مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان) لم يتجاوز الـ 20 ألفاً، مع أسلحة متقادمة، وتعتمد على ذخيرة بريطانية، ومن دون تدريبات أو قيادة مشتركة. في المقابل، كان مجموع القوات الصهيونية 70 ألف مقاتل (هاجاناه، أرغون، شتيرن)، وذلك كله في أيار/مايو 1948.
الجولان مثالاً !
شهدنا في حرب حزيران/ يونيو (1967) هزيمة الجيش الإسرائيلي جيوشاً عربية عدة خلال أيام معدودة، وبطريقة مهينة، ومن ضمنها جيشا الدولتين اللتين كانتا ترفعان لواء التقدم والوحدة، ومواجهة إسرائيل، فالجيش المصري تحطم في حين كان راديو “صوت العرب” يبشر بالانتصارات، أما قوات الجيش السوري في الجولان، فبعدما كانت تسمع من راديو دمشق، حينها، أنباء الانتصارات، إذا بها تفاجأ بنبأ سقوط الجولان بيد إسرائيل؛ وبدل أن يتحمل وزير الدفاع السوري آنذاك، حافظ الأسد، المسؤولية، أضحى رئيسا!.
وفي سنوات سابقة، وإبان زياراتي إلى بلدي فلسطين، تسنت لي مراراً زيارة مرتفعات الجولان، وكم كانت تنتابني مشاعر الحزن والذهول والغضب وأنا أسأل أصدقائي في مجدل شمس عن كيفية سقوط جبال هذه الهضبة الصخرية العالية والوعرة والواسعة، وعن سبب عدم سماح النظام السوري بعودة أهالي القنيطرة إلى مدينتهم، وهو التصرف السليم، بدل تركها كخرابة أو كمدينة أشباح!.
كشفت الحرب الجارية في غزة أن أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر مجرد خديعة كبرى، أو أسطورة، ساهمت الأنظمة العربية الاستبدادية في صنعها، لحاجتها الى وجود إسرائيل كي تبرر طبيعتها التسلّطية، وهيمنتها على موارد بلدانها، وتغييبها مجتمعاتها، ومصادرتها حقوق “مواطنيها” وحرياتهم.
في الحرب التالية (تشرين الأول/ أكتوبر 1973)، نجح الجيش المصري في عبور القناة وتحطيم خط بارليف، ما حقق مفاجأة كبيرة كسرت عنجهية الجيش الإسرائيلي، إلا أن ذلك الأمر لم يُستكمل بتحرير كل سيناء، ليس فقط بسبب ثغرة الدفرسوار، وإنما بقرار سياسي، قاد إلى اتفاقات كامب ديفيد، لاسترجاع سيناء بواسطة المفاوضات.
أما على الجبهة السورية، فإن بطولات مقاتلي الجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني استطاعت اقتحام تلال عدة في الجولان، وتحرير مدينة القنيطرة، إلا أن هذه العملية لم تًستكمل أيضاً، بتحرير كامل الجولان، ليس بسبب توقف الحرب على الجبهة المصرية، فقط، وإنما بسبب عدم استعداد الرئيس السوري، المسؤول عن هزيمة حزيران، للمغامرة التي قد تؤدي إلى إسقاط حكمه؛ والذي كما نعلم طال طويلاً، وآل إلى ابنه، وهو ما يفسر، أيضاً، استنكافه عن المفاوضات لاسترجاع الجولان، وتحفظه على استعادة لبنان أراضيه في الجنوب إبان مسار “مفاوضات مدريد” في مطلع التسعينات.
“أسطورة” صنعتها الأنظمة
على ذلك، فإن أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر تحققت بفضل الأنظمة العربية في البلدان المعنية، لأن الجيوش فيها تركزت وظيفتها على الحفاظ على النظام، حتى أن بدعة “التوازن الاستراتيجي” التي برر بها حافظ الأسد قبضته الحديدية على الدولة والجيش والشعب والموارد، طوال فترة حكمه، تبين أنها مجرد تورية، إذ إن التوازن الذي كان يعده هو في مواجهة شعبه، وفي سبيل تعزيز مكانته الإقليمية، وليس في مواجهة إسرائيل، التي بقي النظام يعد بالرد على اعتداءاتها المهينة والمتوالية في المكان والزمان المناسبين.
في مقابل ذلك كله، فإن المقاومة الفلسطينية المسلّحة، على تواضع إمكاناتها وتدريباتها، وبغض النظر عن رأينا في أوضاعها أو أشكال عملها، وانتقاداتنا الكثيرة لها، استطاعت هز تلك الأسطورة في كثير من المواجهات المباشرة، مثلاً، في معركة الكرامة في الأردن (1968)، التي كانت الانطلاقة الحقيقية للكفاح المسلح الفلسطيني، وفي عمليات نوعية جريئة كالتي قادتها دلال المغربي (1978)، واخترقت فيها فلسطين/ إسرائيل من لبنان باتجاه حيفا وتل أبيب، وفي معركة قلعة شقيف (1982) في لبنان، وفي المعارك التي شهدها مخيم جنين، وأيضا في الحرب الثالثة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة (2014)، وذلك على رغم أن الحديث يتعلق بمقاتلين بأسلحة فردية، في مواجهة جيش مدرب ومدجج بأحدث الأسلحة ووسائل الاتصال، مع دبابات وطائرات ومدفعية وبوارج حربية، أيضاً هذا حصل في الحرب التي شنّها الجيش الإسرائيلي على لبنان (2006).
هكذا، اعتبر توماس فريدمان أن يوم 7 تشرين الأول، هو “أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل”… المقاومة الفلسطينية لم تغز فقط إسرائيل، بل إنها أخذت أسرى إلى غزة، عبر حدود أنفق الاحتلال مليار دولار على بنائها، ومن المفترض أنها عصية على الخرق”.
الفكرة هنا، وبمعزل عن المعطيات والخلفيات أو الرؤى السياسية، تفيد بخواء فكرة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، إذ لم يحصل قتال حقيقي البتة بين أي جيش وإسرائيل (باستثناء حرب 1973)، مع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي قدمها جنود تلك الجيوش العربية وضباطها. أيضاً، لا ينبغي أن يُفهم من ذلك أن تلك الجيوش كان يمكن أن تهزم إسرائيل لو أنها قاتلتها، لأن تلك الدولة تتمتع بحماية، وضمانة دولية لأمنها واستقرارها وتفوّقها، وبحكم تمتعها بقوة تدميرية عاتية، فضلاً عن حيازتها أسلحة نووية، أو سلاح يوم القيامة، بالتعبيرات الإسرائيلية.
المعنى هنا، أنه يمكن هز إسرائيل وكسر جبروتها وإجبارها على الانصياع لمطالب عربية وفلسطينية، وضمنه انسحاب من أراض محتلة. لكن هزيمتها تتطلّب أكثر من العواطف والرغبات والتمنيات، فهي تحتاج إلى موازين قوى أفضل، وإلى معطيات عربية ودولية مواتية، ليست متوافرة في المدى المنظور.
يقول جدعون ليفي: “أمس، رأت إسرائيل صوراً لم تتوقعها في حياتها، بسبب غطرستها. اخترق بضع مئات من المسلحين الفلسطينيين السياج وغزوا إسرائيل بطريقة لم يتخيلها أي إسرائيلي. لقد أثبت بضع مئات من المقاتلين الفلسطينيين أنه من المستحيل سجن مليوني إنسان إلى الأبد، من دون دفع ثمن باهظ. وكما هدمت الجرافة الفلسطينية القديمة المدخّنة بالأمس الجدار، وهو الأكثر تطوراً بين كل الجدران والأسوار، إلا أنها مزقت أيضاً عباءة الغطرسة واللامبالاة الإسرائيلية”. (“هآرتس”، 8/10/2023).