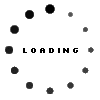حكومة نتنياهو تضع نصف الإسرائيليين في مواجهة نصفهم الآخر

ماجد كيالي
26/7/2023
ما حصل في إسرائيل لجهة تمرير الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي (الـ 64 عضوا من 120)، من المنتمين للتيارين القومي والديني، تعديلا يقضي بتقويض السلطة التشريعية، من خلال الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ليس حدثا عاديا، لا سيما مع انسحاب 56 عضوا معارضا من جلسة الكنيست، في خطوة ذات مغزى.
يمكن ملاحظة ذلك من عدة زوايا، يكمن أهمها في:
أولا، هذه السابقة الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، منذ قيامها قبل 75 عاما، التي يتم فيها صوغ قانون أساس، أو اتخاذ قرار يمسّ بطبيعة النظام السياسي، أو بخيارات الدولة، من قبل نصف الكنيست، أو أزيد قليلا، مقابل النصف الأخر، في حين، في مرات سابقة، كانت تبذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى توافقات وسط، بما يعزز وحدة المجتمع الإسرائيلي، ومناعة الدولة، كضرورة وجودية في مواجهة ما تعتبره إسرائيل محيطا معاديا.
ثانيا، هذا القانون يطيح بالطابع الذي تروج له إسرائيل عن نفسها كدولة ديمقراطية ليبرالية وكامتداد للغرب في المنطقة، إن لصالح كونها دولة يهودية، ولصالح تقويض الفصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على كل السلطات. إذ بذلك تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة القضائية، في حين إنها تسيطر بطبيعة الحال على السلطة التشريعية (بأغلبية الـ 64 عضوا) في الكنيست، ما يعني أنها بذلك تتحرر أيضا من أية مراقبة قانونية.
ثالثا، بدت إسرائيل هذه المرة غير معنية البتّة بالاستجابة للضغوط الخارجية، من الدول الغربية الحليفة، وضمنها الولايات المتحدة، حتى إنها صدت بجلافة التلميحات والطلبات المباشرة، من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتناع عن تلك الخطوة، بتصريحات من نتنياهو والوزيرين المتطرفين يتسئيل سيموتريش وايتمار بن غافير، عبرت بصفاقة عن رفض أي تدخل اميركي، بدعوى أن إسرائيل دولة ديمقراطية وإن فيها حكومة منتخبة، تقرر ما هو الأفضل لها؛ في حين إنه في مفاصل سابقة كانت إسرائيل تنصاع للبيت الأبيض. حدث ذلك في الانسحاب من سيناء (1956)، وإبان مفاوضات كامب ديفيد مع مصر (1977)، ولدى التحضير لمؤتمر مدريد للسلام (1991)، في الأزمة التي حدثت بين حكومة اسحق شامير والرئيس جورج بوش (الأب).
بدت إسرائيل غير معنية البتّة بالاستجابة للضغوط الخارجية، من الدول الغربية الحليفة، وضمنها الولايات المتحدة، حتى إنها صدت بجلافة التلميحات والطلبات المباشرة، من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتناع عن تلك الخطوة
يتضح من ذلك أن نتنياهو لا يلوي على شيء، في فرضه بصْمَتِه في تاريخ إسرائيل، منذ صعوده إلى رئاسة الحكومة بعد اغتيال اسحق رابين، إذ عمل كل جهده، في تلك الفترة للإطاحة باتفاق أوسلو مع الفلسطينيين (1996 ـ 1999). وفي حقبته الثانية (2009 ـ 2021) واصل سياسته، التي تجسدت هذه المرة بتقويض مكانة السلطة الفلسطينية ووأد فكرة وجود كيان فلسطيني مستقل، وتعزيز الاستيطان لتغيير الطابع الديمغرافي في القدس والضفة الغربية، كما عمل على الحط من المكانة القانونية لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين، من خلال صك قانون إساس (2018) الذي نص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.
لكن طموحاته في هذه المرحلة شملت، أيضا، تعزيز اليمين القومي والديني، وتغليب طابع إسرائيل كدولة يهودية على طابعها كدولة مواطنين، وتغليب طابعها كدولة دينية على طابعها كدولة علمانية، مع التخفف في كل ذلك من طابعها كدولة ديمقراطية ـ ليبرالية، إلى حد أن عديد من السياسيين وأصحاب الرأي في إسرائيل بدأوا يتحدثون عن خطر نتنياهو الذي يريد أن يحول إسرائيل إلى دولة دكتاتورية، ودولة فساد، وإلى دولة دينية.
يمكن لفت الانتباه هنا، أيضا، إلى ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى، أن نتنياهو روج لمشروعية القانون الجديد بدعوى امتلاكه أغلبية في الكنيست وهو ادعاء ينطوي على تحايل، إذ لا يحق لأغلبية ما في نظام ديمقراطي ادخال تغييرات جوهرية في النظام السياسي، او اتخاذ قرارات تاريخية، من موقع أغلبية نسبية، على نحو ما يحصل في الواقع الإسرائيلي اليوم، إذ إن ذلك يتطلب أغلبية من ثلثين، أو من 75 بالمئة، أو بالذهاب نحو استفتاء، أو بحسب ما يتم الاجماع عليه في دستور. ومشكلة إسرائيل هنا افتقادها إلى دستور، مع ذلك فأغلبية 64 من 120 لا تمنحه هذا الحق، لأن ذلك يعطي لأي حكومة أخرى، لاحقة، أن تعدل في القوانين الأساسية بحسب مصالحها.
المسألة الثانية، فإن القوة التصويتية للائتلاف الحاكم هي بمجموع 2.305.234 صوتا، من مجموع الناخبين المصوتين الـ 4.793.641 في الانتخابات للكنيست الحالية (الـ 25)، ويستنتج من ذلك أن ثمة قوة تصويتية أكبر من القوة التصويتية لمعسكر نتنياهو، وهي بمجموع 2.488.406 صوتا، لكن ذلك المعسكر خسر 288 ألف صوت (150 ألف صوت لحزب “ميريتس”، و138 ألف للتجمع الوطني الديمقراطي)، بحيث تمت إضافة تلك الأصوات الضائعة، التي لم تصل إلى نقطة الحسم، إلى القوائم الفائزة، وهو ما يفسر رجحان كفة التيارات اليمينية القومية والدينية، وهو ما أفاد نتنياهو ومعسكره.

شملت طموحات نتنياهو في هذه المرحلة تعزيز اليمين القومي والديني، وتغليب طابع إسرائيل كدولة يهودية على طابعها كدولة مواطنين، وتغليب طابعها كدولة دينية على طابعها كدولة علمانية، مع التخفف في كل ذلك من طابعها كدولة ديمقراطية ـ ليبرالية
اما المسألة الثالثة، فهي تفيد بأن نخبة المجتمع الإسرائيلي، والدولة العميقة، والفئات الأكثر حيوية وفاعلية فيه، وهذا يشمل الجيش، والنقابات (الهستدروت، واتحاد الصناعيين)، وأصحاب الشركات الكبرى، وضمنها شركات التكنولوجيا المتقدمة “الهاي تيك”، والطبقة الوسطى، هي تقف في الصف المناهض لنتنياهو.
على ذلك ثمة أسباب داخلية، وأيضا، خارجية تفيد بأن ما فعله نتنياهو سيرتد عليه، آجلا أم عاجلا، إن في ردة فعل المجتمع المدني والمحكمة العليا والشركات والجيش الإسرائيلي، كما في رد الحكومات الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، التي كانت أبرزت في السبعينيات شعار: “إنقاذ إسرائيل رغم أنفها”.