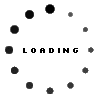في الآثار السلبية للعقوبات على روسيا… ماذا عن “التجرية السوفييتية”؟

ماجد كيالي*
24 فبراير 2023
بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا، الذي أسمته “عمليه عسكرية خاصة”، قبل عام (24/2/2022)، لكن تلك العملية لم تنته بعد، ولا أحد يعرف كيف أو متى ستنتهي، والأهم إنها تمخّضت عن حرب، بمعنى الكلمة، إذ نجم عنها خراب مدن، وتدمير بني تحتية، وتشريد ملايين الأوكرانيين، وانهيار اقتصادهم وحياتهم الاجتماعية، مع أزمات اقتصادية عالمية.
في غضون كل ذلك، انتهجت القيادة الروسية سياسة متعددة الوجوه قوامها:
أولا، التعتيم على مسارات تلك الحرب ورفض أو منع، أي انتقاد لها، في نظام شمولي، لا يعترف بالتعددية الحزبية، ويتحكم بوسائل الإعلام، ويصادر حرية الرأي، والتعبير، بل ويعاقب عليه، إلى حد أن رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، المفترض أنه يمثل المواطنين، اقترح مؤخرا إضافة مادة حول مصادرة ممتلكات المعارضين باعتبار أن العقوبات الحالية بالغرامات والسجن ليست كافية.
ثانيا، تقصّد عدم الوضوح أو التخبّط، في تحديد أهداف تلك الحرب (“العملية العسكرية الخاصة”)، إذ تراوحت من الدفاع عن حق التحدث باللغة الروسية وحماية الأقلية الروسية في إقليم دونباس، إلى نفي وجود أوكرانيا كبلد ودولة، باعتبارها جزءا من الجسم الروسي، في التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة والدين، وصولاً إلى استهداف تغيير النظام الدولي الراهن، بنزع الهيمنة الأميركية عن العالم وبالتحول إلى نظام متعدد الأقطاب.
وشمل ذلك، أيضا، ما أسمته القيادة الروسية بـ “عملية نزع النازية” من أوكرانيا، ودرء تحولها إلى قاعدة لحلف “الناتو”، وحماية روسيا من محاولات اضعافها وتهديدها وتفكيكها، وأخيرا اقتطاع أربعة أقاليم من أوكرانيا وضمها نهائيا إلى روسيا (بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم).
ثالثا، انتهاج سياسة الإنكار أو الانفصال عن الواقع، بنفي اية انعكاسات سلبية أو ارتدادات عكسية، لتلك الحرب على روسيا ذاتها، من كل النواحي، السياسية والاقتصادية والعسكرية.
هذا ينطبق على كل الأهداف، من إضعاف الهيمنة الأميركية، وإبعاد “الناتو” عن حدود روسيا، وفك العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة. إذ إن ذلك الغزو أدى إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ أوكرانيا كبلد، وإلى انبثاق قومية أو عصبية اوكرانية، فهي إن لم تكن موجودة سابقا، فقد تبلورت بفضل بوتين ذاته، أي بسبب غزوه أوكرانيا وتشريد ملايين من شعبها.
إن إنكار الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا، وأعتقد أنها كبيرة جدا، هو الظاهرة الأكثر لفتا للانتباه، إذ تؤكد روسيا أن عملتها لم تنهار، وهذا صحيح، وإن الخسائر التي تكبدتها الدول الغربية، التي شنت حرب عقوبات اقتصادية على روسيا، تضررت هي منها أيضا، وهذا صحيح بشكل جزئي
وعلى الصعيد العسكري فقد استطاع الجيش الأوكراني الصغير، الصمود بل وتوجيه ضربات قوية للجيش الروسي المتثاقل والتقليدي، وللآلة العسكرية الروسية المتقادمة، بفضل الدعم الغربي، وهو ما ترسخ في الانسحاب من حول كييف وخاركوف وأجزاء من خرسون، وبعدم القدرة على أخذ مدينة صغيرة بحجم باخموت التي تتعرض لهجوم عسكري منذ ستة أشهر.
بيد إن إنكار الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا، وأعتقد أنها كبيرة جدا، هو الظاهرة الأكثر لفتا للانتباه، إذ تؤكد روسيا أن عملتها لم تنهار، وهذا صحيح، وإن الخسائر التي تكبدتها الدول الغربية، التي شنت حرب عقوبات اقتصادية على روسيا، تضررت هي منها أيضا، وهذا صحيح بشكل جزئي.
في الواقع فإن روسيا، على هذا الصعيد، تستغل حال انعدام الشفافية، وتعتيمها على أحوالها، وحجبها المعلومات والاحصائيات، في مقابل انكشاف الغرب بكل احواله، للترويج لتلك الادعاءات.
مثلا، فإن عدم انهيار الروبل الروسي يعود أساسا إلى جمود التبادل التجاري مع الغرب، بسبب حزم العقوبات التي فرضت على روسيا، إذ أن حوالي 40 بالمئة من واردات روسيا (تكنولوجيا وآلات ومواد طبية الخ) كانت تأتي من الدول الأوروبية، بمعنى أن العوائد الروسية المتأتية من تصديرها النفط والغاز ظلت في الخزينة الروسية، فالدولة تبيع ولكنها لا تصرف أو لم تعد تشتري شيئا؛ هذا أولاً.

ثانيا، قبل غزو اوكرانيا كان لدى روسيا احتياطي استراتيجي يقدر بحوالي 600 مليار دولار، وهو الذي مكّنها من تحمل تبعات الحرب، لكن ذلك الاحتياطي بات مستنزفا، ما يفسر سعي روسيا لبيع النفط والغاز بأسعار أقل من تلك العالمية بحوالي الثلث.
ثالثا، هناك المبادلات مع الصين، سيما في النفط والغاز، كما مع الهند وإيران وتركيا، وهي تتيح للاقتصاد الروسي التقاط الانفاس، أو تأمين الحد الأدنى اللازم.
يعود عدم انهيار الروبل الروسي أساسا إلى جمود التبادل التجاري مع الغرب، بسبب حزم العقوبات التي فرضت على روسيا، إذ أن حوالي 40 بالمئة من واردات روسيا (تكنولوجيا وآلات ومواد طبية الخ) كانت تأتي من الدول الأوروبية، بمعنى أن العوائد الروسية المتأتية من تصديرها النفط والغاز ظلت في الخزينة الروسية
رابعا، لم يثبت أن الدول ذات الأنظمة الاستبدادية، أي غير الديمقراطية أو غير التمثيلية، يمكنها أن تنهار بسبب الضغوط الاقتصادية الخارجية، لأنها تسيطر على البلد، وتعيش على الريع الناجم عما تمتلكه من ثروات باطنية، وهي تفتقد لدورة اقتصادية طبيعية، كما إنها منفصمة عن نمط عيش مجتمعاتها، وهي غير معنية بأصوات الناخبين، وتعتقد أن استمرار وجودها في السلطة، أهم من سلامة شعبها، أو سلامة مصالحه أو حقوقه، على خلاف الدول الديمقراطية ـ التمثيلية، على علاتها؛ هذا حدث في العراق وليبيا وسوريا وفي ايران وكوريا الشمالية، وهو الذي يفسر الوضع في روسيا أيضا، حيث الرئيس هو الذي يقرر الخيارات، ويتخذ الخيارات في كل شيء.
مع كل ذلك، ففي الجدل في شأن الانعكاسات الاقتصادية للحرب الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن التنويه إلى الملاحظات الآتية:
أولا، بعد الحرب في أوكرانيا (2014)، وبحسب احصائيات البنك الدولي، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من 2.6 ترليون دولار في العام 2014، إلى 1.3 ترليون دولار في العام 2015، وهو يتراوح الآن بين 1.6 ـ 1.7 ترليون دولار سنويا، بمعنى أن ثمة تراجع اقتصادي كبير قد حصل بين تلك الحرب وما بعدها، وأن روسيا منذ ذلك الحين ليس لديها نمو اقتصادي، وإنما تراجع، مع ملاحظة أن روسيا تلك التي مساحتها 17 مليون كلم مربع، وتتمتع بثروات باطنية هائلة ومنوعة، معظم صادراتها للعالم هي من النفط والغاز والقمح والاسمدة، وبعض أنواع الأسلحة، التي ثبت تقادمها في الحرب الأوكرانية. وربما هنا يحلو للبعض إحالة تقدم، ومستوى رفاهية، أوروبا إلى امدادات الطاقة الرخيصة من روسيا، لكن السؤال هنا هو لماذا لم تفعل تلك الامدادات فعلها في الاقتصاد الروسي إذا؟ ولماذا الاقتصاد الروسي على هذه الدرجة من التراجع، أو التخلف بالقياس لدول أوروبية أصغر حجما بكثير؟
ثانيا، في المقارنة مع الصين (وليس مع الولايات المتحدة أو المانيا أو اليابان)، فقد كان للاتحاد السوفياتي السابق (سلف روسيا) اقتصادا اقوى من الصين، إذ بلغ ناتجه الإجمالي في العام 1988 حوالي 554 مليار دولار، في حين كان في الصين 312 مليار دولار، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي بلغ الناتج الإجمالي لروسيا في العام 1991 حوالي 517 مليار دولار، وكان في الصين 383 مليار دولار. وقد تساويا تقريبا عام 1993، إذ كان في روسيا 435 مليار دولار، في حين كان في الصين 444 مليار دولار. بعد ذلك، ومع دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية (2001)، بات الفارق كبيرا بين الطرفين، لصالح الصين، ففي حين كان الناتج الإجمالي لروسيا في العام 2001 حوالي 306 مليار دولار، بلغ في الصين 1.34 ترليون دولار، لكن في عام 2021 بلغ الناتج الإجمالي في روسيا إلى 1.78 ترليون دولار، في حين وصل في الصين إلى 17.77، أي أن الاقتصاد الصيني أقوى بقرابة عشرة أضعاف من الاقتصاد الروسي (كان اقوى منه بمقدار أربعة مرات في العام 2014، قبل حرب أوكرانيا الأولى).
لكن الفارق يبدو أكثر وضوحا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ففي حين كان في العام 2001 في الصين 1052 دولار، كان ضعفه في روسيا إذ كان 2100 دولار، لكنه في العام 2021 بلغ في الصين 12500 دولارا (عدد سكانها مليار وربع تقريبا)، في حين بلغ في روسيا 12200 دولارا (عدد سكانها 145 مليونا)، أي أن عدد سكان الصين أعلى بعشر مرات، ما يبين مدى الركود في اقتصاد روسيا مقابل حيوية الاقتصاد الصيني.
ويمكن تفسير تسارع التطور في الصين، وهو بالمناسبة حصل بعد انتهاء عالم الحرب الباردة، مقابل جمود الاقتصاد الروسي، باستثمارها الناجح في مسارات العولمة، وتحولها إلى دولة بمثابة مصنع للغرب (خاصة للولايات المتحدة والبلدان الأوروبية) الذي تخلى عن قطاعات من الأعمال، التي باتت متقادمة وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، لصالح قطاعات الاعمال الجديدة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والعلوم، وهو ما يفسر أيضا تردد الصين، بين أسباب أخرى، في عدم إبداء الدعم للموقف الروسي في أوكرانيا. وعن ذلك يقول هال براندز (خدمة بلومبيرغ): “قبل خمسين عاما، وجهت الولايات المتحدة ضربة إلى الاتحاد السوفياتي، ولكنها ساعدت أيضا في خلق وحش جيوسياسي جديد…في الوقت الذي تفترض فيه بسذاجة أن الوحش سوف يذوب تلقائياً…في الحقبة الأحادية القطبية دفعت الولايات المتحدة إلى مضاعفة مشاركتها مع الصين إلى ثلاثة أمثالها، على أمل أن تنجح قوى العولمة والتحرير في نهاية المطاف في تحول نظام حكم عنيد ووحشي لا مصلحة له في التحول.” (الشرق الأوسط، 21/7/2021)، أي إن الصين مدينة، بكثير من الأوجه، للغرب ولمسارات العولمة بتطورها الاقتصادي، وهما الأمران اللذان لا يمكنها التخلي عنهما.
لا تتعلق المسألة فقط بالقطيعة مع امدادات الطاقة الروسية، وعزل روسيا اقتصاديا، وإنما هي تتعلق، أيضا، بمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، في عصر باتت فيه العلوم والتكنولوجيا، هي قاطرة الاقتصادات الحديثة، وقاطرة التطور الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
ثالثا، في التجربة التاريخية فإن الاتحاد السوفييتي (سلف روسيا) لم ينهار بسبب حرب، ولم يطلق أحد على روسيا رصاصة واحدة، وإنما انهار بسبب انفصام القيادة الروسية عن الواقع، وعن العالم، وبسبب إنكار الثغرات والنواقص في النظام السياسي والاقتصادي للاتحاد السوفياتي (كما يحصل اليوم)، مع إنكار تخلفها في المباراة العلمية والتكنولوجية وفي إدارة الموارد مع الدول الغربية ـ الرأسمالية. هكذا فإن تلك الدول لم تنهار، كما كان يروج منظرو الاتحاد السوفياتي الشيوعيين، وإنما الذي انهار هو مع دول “المنظومة الاشتراكية”، وهذا ما تحدث عنه فؤاد مرسي، في كتابه: “الرأسمالية تجدد نفسها” (عالم المعرفة، 1990)، وهو انهيار كان تنبأ به في وقت مبكر زبينغيو بريجنسكي (1970)، وهو احد أهم المنظرين السياسية الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، في كتابه: “بين عصرين”، الذي تحدث عن انهيار الاتحاد السوفييتي بسبب نقص الحرية ونقص قوة النموذج والتخلف التكنولوجي.
رابعا، الآن، وعلى وقع حزم العقوبات الغربية، فإن المسألة لا تتعلق فقط بالقطيعة مع امدادات الطاقة الروسية، وعزل روسيا اقتصاديا، وإنما هي تتعلق، أيضا، بمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، في عصر باتت فيه العلوم والتكنولوجيا، هي قاطرة الاقتصادات الحديثة، وقاطرة التطور الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد، وهذه مسألة يمكن ملاحظة أخطارها او تأثيراتها بشكل أوضح على المدى البعيد.

أما في المعنى المباشر فإن عزل الاقتصاد الروسي يعني تجفيف موارده، ومثلا، فإن الخزينة الروسية تخسر يوميا 172 مليون دولار، بسبب تسقيف سعر النفط (60 دولارا للبرميل وهذا رقم مرجح للنقص)، أي حوالي 50 مليار دولار سنويا، وإذا أضيف إلى ذلك أن روسيا تبيع النفط بأقل من السقف بكثير لدول مثل الصين والهند، فإن ذلك يعني مبلغا إضافيا كبيرا.
ويمكن أن ندرك أثر ذلك، إذا علمنا أن موازنة روسيا العسكرية كانت حوالي 65 مليار دولار سنويا (قبل الغزو)، ما يعني أن هذا المبلغ الذي كان يأتي من الموارد المتأتية عن تصدير النفط والغاز بات غير متاح، الأمر الذي يفترض الضغط لتعويضه من مواضع أخرى. ومعلوم أن القيمة الاجمالية لصادرات روسيا من النفط والغاز كان تبلغ بين 180 ـ 188 مليار دولار، تشكل 40 بالمئة من موازنة حكومتها.
على أية حال من طبع نظام سياسي كهذا الانفصام عن الواقع، وإنكاره، وهو ما جرى في التجربة السوفييتية، ولكن إلى متى؟