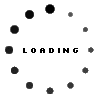قراءة أولية في التَحولّات “الإسرائيلية”
الحلقة السادسة والأخيرة
“خراب البيت الثالث”
بقلم الأسير: كميل أبو حنيش*
الحلقة الاولى اضغط هنا
الحلقة الثانية اضغط هتا
الحلقة الثالثة اضغط هنا
الحلقة الرابعة اضغط هنا
الحلقة الخامسة اضغط هنا
في خضم الأزمة المتفاقمة داخل المجتمع الصهيوني بسبب خطة الإصلاح القضائية التي يُصّر الائتلاف الحاكم على إقرارها، انطلقت مجموعة من المواقف المُنددة بالخطة والمُحذرة من إمكانية اندلاع “حرب أهلية”، كما صرح “بني غانتس” في بداية الأزمة، وشاطره آخرون في الرأي من مختلف الأحزاب والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، غير أن أبرز تلك المواقف، ما صرح به “أهارون براك” رئيس محكمة العدل العليا السابق، وأبرز رموز القضاء في “إسرائيل” حين قال “أن هذه الإصلاحات، تُعد انقلابًا جذريًا في بنية الدولة، وتُمثل بداية خراب البيت الثالث”، وهو التعبير الأقوى من بين تلك المواقف.
مع أن الحديث عن الحرب الأهلية وخراب البيت الثالث لم يبدأ في الأزمة الراهنة، وإنما يعود لعقودٍ، كلما برزت إشكالية أو أزمة عاصفة، فإن الجدل السياسي يقود إلى مثل هذه التعبيرات الحادة.
يشهد المجتمع الصهيوني أزمة عميقة وتَصدّعًا بنيويًا رافق تَشكّل (الدولة) منذ البداية، في ضوء الإخفاق في ترجمة فكرة “الشعب اليهودي”، ومع الوقت شهدت نظرية “بوتقة الصهر” فشلًا ذريعًا، وأدت إلى تمزق المجتمع، وإلى مزيدٍ من التنافر بين مختلف الجماعات اليهودية انطوت على صراعاتٍ سياسية واثنية وعرقية ودينية وطائفية وثقافية واجتماعية وطبقية، وجدت تعبيرها بأربعة انقسامات: الانقسام الديني – العلماني، الانقسام الشرقي – الاشكنازي، الروسي – “الإسرائيلي”، اليهودي – العربي، حيث كشفت أزمة فشل نظرية بوتقة الصهر، عن مجتمعاتٍ وليس مجتمعًا واحدًا.
وطوال العقود الماضية تزايد الحديث عن “الحرب الأهلية”، و”خراب البيت الثالث”، وذلك لما يحتله هذين التعبيرين من حيزٍ في الوجدان اليهودي الجمعي، وما يمثلانه من هواجسٍ كامنة، يجري استحضارها كلما تفاقمت أزمات المجتمع “الإسرائيلي”.
ومفهوم “البيت الثالث” هو كناية عن (الدولة) الحالية “إسرائيل” على اعتبار أن “البيت الأول” هو (الدولة) اليهودية الأولى التي بدأت زمن الملك “شاؤول” والملك داوود، ووصلت إلى ذروة مجدها وقوتها – حسب المزاعم التوراتية – زمن الملك سليمان والذي أقيم في عهده الهيكل الأول “البيت الأول” وبعد وفاته انقسمت الدولة إلى مملكتين شمالية (إسرائيل) وعاصمتها السامرة، والنوبية (يهودا) وعاصمتها (أورشالم)، واندلعت حرب أهلية بين المملكتين، وأدت هذه الحرب إلى ضعف الدولتين، وقادت إلى إسقاط المملكة الشمالية على يد الآشوريين سنة 722 ق.م، وسبي مجمل سكانها إلى شمال العراق، فيما سقطت مملكة يهودا على يد البابليين سنة 587 ق.م، وجرت عملية تدمير “الهيكل الأول” وسبي سكان يهودا إلى بابل.
ويرمز خراب الهيكل الأول أو “البيت الأول” إلى سقوط مجد اليهود، رغم إتاحة المجال أمامهم بعد سبعين عامًا للعودة إلى يهودا، تحت رعاية الدولة الفارسية، وبحكمٍ ذاتي وحسب، وأتيح لهم بناء “الهيكل الثاني” أو “البيت الثاني” المعروف “بهيكل هيرودتس” في زمن الاغريق.
ويزعم التاريخ اليهودي، الذي كُتب بعد الأسفار التوراتية أن اليهود استعادوا بناء مملكتهم في القرن الثاني قبل الميلاد بعد أن فجروا ثورة ضد الإغريق عُرفت بثورة “الحشمونائيم” أو “الميكابيين” وتوسعت لتشمل الجليل ومساحات من الضفة الشرقية لنهر الأردن، واستمرت لأكثر من سبعين عاماً قبل أن ينقسم اليهود إلى طوائفٍ متنازعةٍ كالصدوقيين والفريسيين والأسنييين، ومع الاحتلال الروماني لفلسطين سنة 63 ق.م جرى الإجهاز على دولتهم وبقائهم تحت الحكم الروماني، إلى أن قاموا بإحدى ثوراتهم وأدت إلى تهجيرهم عن فلسطين وتدمير هيكلهم “البيت الثاني” على يد الرومان سنة 70م.
وتُشكّل حادثتي “الخراب الأول للبيت” على يد البابليين، و”الخراب الثاني” على يد الرومان، واحدتين من أهم (المآسي) اليهودية وتُمثّل عقدةً تاريخية، كان يجري استحضارها، كلما وقعت حادثة لإحدى الجماعات اليهودية طوال التاريخ.
وبعد مرور قرابة ألفي عام، على الخراب الثاني، وظهور الصهيونية، ونجاحها في تجسيد الدولة، اعتبرت “إسرائيل” بمثابة “البيت الثالث” ولكن من دون أن تنجح في إعادة بناء الهيكل الثالث “البيت الثالث”، غير أن الاتجاه العلماني بمن فيهم القاضي براك، يعتبر الدولة هي بمثابة “هيكل الشعب اليهودي” أو “البيت الثالث” الذي يجب أن يُحمى ويُحرس بأيدي أبنائه، أي بأدواتٍ بشرية تعتمد على القوة المادية من الخارج، وليس القدرة الإلهية، أما سرّ قوة البيت من الداخل، كما يعتقد العلمانيون، فمرتبط بسيادة القانون والديمقراطية والحرية.. فيما يرى الاتجاه الديني، أنه لا بد من إعادة بناء “الهيكل الثالث” بالمعنى الديني، لا المجازي، وأن سر قوة الدولة، يرتبط بتطبيق الشريعة اليهودية.
ويعد القاضي “براك”، أحد أشهر رؤساء محكمة العدل العليا، ففي عهده عمدت المحكمة إلى تفسير قوانين الأساس (كرامة الإنسان وحريته، وقانون العمل) اللذين عرفا “إسرائيل” “كدولة يهودية وديمقراطية” سنة 1992، وعرف عن ذلك التفسير الواسع للقانونين من قبل المحكمة “بالثورة الدستورية” أو القضائية، حيث جرى توسيع الحيز الديمقراطي (حقوق الإنسان، حقوق المواطن، الحقوق الفردية، الحريات.. الخ) على حساب الحيز اليهودي وهو ما أثار حفيظة القوى اليمينية، لا سيما الدينية منها، التي انتظرت لثلاثة عقود حتى أتيح لها القيام “بثورتها الدستورية أو القضائية” الخاصة بها، والمضادة للثورة القضائية العلمانية في بدايات تسعينيات القرن الماضي.
وخراب “البيت الثالث” لدى “براك” ولدى قطاعات واسعة من المجتمع الصهيوني، هو الهاجس الذي يسكن اللاوعي “الإسرائيلي” العام من إمكانية نشوب حرب أهلية قد تقود إلى دمار الدولة والعودة إلى مربع المنفى، وبالتالي نهاية الصهيونية ودولتها.
وقد حذر رئيس الحكومة السابق “نفتالي بينيت” قبل أكثر من عام من هذا الانقسام الحاد الذي سيقود إلى دمار الدولة، كما حدث في الماضي، وكأن الدولة الحالية – حسب بينيت- هي امتداد للدولتين السابقتين قبل آلاف السنين.
غير أن هذا الهاجس الذي صار يجري الإكثار من ترديده في ضوء الأزمة الحالية، له ما يبرره، في ظل احتدام الصراع مع العرب والفلسطينيين ودول المنطقة، علاوةً على تفاقم أزمات المجتمع الصهيوني، التي يجري تأجيلها من دون حسم، ولعل أبرز إشكالية تواجه الدولة العبرية، هو إشكالية الهوية، حيث تتزايد الصراعات بين مختلف الجماعات اليهودية المتنافرة، على تشكيل هوية الدولة، ونظاميها السياسي والاجتماعي.
ويدرك القاضي “براك”، كغيره من “الإسرائيليين” أن الهوية اليهودية الغامضة التعريف، لا تكفي للحفاظ على تماسك المجتمع في ضوء الخلاف على تعريف: من هو اليهودي، وماهية اليهودية، وماهية الدولة اليهودية. وأن الاتفاق على “الهوية الاسرائيلية” يكاد يُمثّل حلاً مؤقتاً للأزمة، إذ تنطوي “الهوية الإسرائيلية” على الديمقراطية والعلمانية والقانون والقضاء والدولة المدنية، يخضع لها الجميع وتحافظ على قواعد اللعبة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين مختلف المكونات المتصارعة، علاوةً على احتوائها على تعريفات فضفاضة لليهود، بما يسمح لمختلف التيارات اليهودية (الأرثوذكسية، الإصلاحية، المحافظة، الصهيونية الدينية، ناطوري كارتا، العلمانيين، الروس، الأثيوبيون، اليهود اللايهود بسبب الزواج المختلط…) أن ينضووا تحت لواء “الهوية الإسرائيلية”، كما بإمكان حتى “العرب” أن يكتسبوا مثل تلك الهوية، ويعيشوا تحت لوائها.
ويُشكّل القانون والقضاء، القلب “للهوية الإسرائيلية” للحفاظ على التوازن بين تلك المكونات المتنافرة والمتصارعة، وينبع هاجس القاضي “براك” وسائل المحتجين على خطة الإصلاح القضائية من حقيقة أن الإخلال بعنصر القضاء أو بأي قانون من قوانين الأساس، من شأنه أن يؤدي إلى اختلال في التوازن في العلاقة ما بين تلك المكونات، ويخل كذلك بمبدأ الفصل بين السلطات، كما سيقود إلى انقلاب جذري في بنية الدولة ونظامها السياسي والقضائي.
وربما تحتاج “إسرائيل” إلى مبدأ الفصل بين السلطات، أكثر من أي دولة أخرى، لاعتبارات متعددة: لأنها أولًا: دولة تفتقد إلى دستور يُعرّف الدولة وهويتها وحدودها ونظامها السياسي والاجتماعي، وثانيًا: لأنها دولة يفتقد مجتمعها للتجانس العرقي وحتى الديني في ضوء تعدد التيارات الدينية ومرجعياتها، وثالثًا: لأنها دولة محكومة للنموذج الغربي في شكل تكوين نظامها السياسي ولا يمكنها الانزياح عن هذا النموذج، بسبب ارتباطها العميق بالمنظومة الغربية، وبوصفها مستعمرة أو جيبًا استيطانيًا تابعًا للغرب.
غير أن القوى اليمينية في “إسرائيل”، لا سيما الدينية منها، لها حساباتها الخاصة تلك المحكومة لتاريخ أسطوري مُتخّيل، وتعتقد بغباء أنها دولة مستقلة تُشكّل امتدادًا لدولة “يهودا” الغابرة، وأن ثمة شعب عضوي، اسمه “الشعب اليهودي”، وأن النموذج الغربي ليس قدرًا لها، ولا تجد بقواعد اللعبة السياسية والديمقراطية إلا وسيلة لتحقيق مآربها للوصول إلى الحكم، وإقصاء الآخرين باعتبارهم “علمانيين” و”يساريين” و”أغيار”. إذ أنها تفهم الديمقراطية كآلية توصلها إلى الحكم، ولا تؤمن بمضامينها القيمية والاجتماعية والسياسية.
هذا وتدرك قطاعات واسعة في الدولة الصهيونية، أن بقاء اليمين الديني في الحكومة لفترةٍ طويلة، من شأنه أن يتيح له فرض أجندته السياسية والأيديولوجية على مؤسسات الدولة وقراراتها المصيرية، الأمر الذي سيطمس وجه “إسرائيل” الذي تتباهى به أمام العالم، باعتبارها دولة تنتمي إلى النموذج الغربي، مما سينعكس على الاقتصاد، واختلال الثقة بالنظام السياسي “الإسرائيلي”، ويطيح بعلاقاتها الخارجية، وتصبح عندها “إسرائيل” في نظر العالم، دولة استبدادية بمضامين دينية وفاشية، وبهذا ستفقد مزايا كانت تتمتع بها أمام العالم.
لكن القاضي “براك” يرى بعين الفزع لما يمكن أن تحدثه تلك الإصلاحات، ومن زاويةٍ داخلية بالأساس، إذ أن هيمنة اليمين الديني على الدولة، وما يحمله من تصوراتٍ مشيمائية وغيبية وعنصرية، سيكون ضرره أولًا وأخيرًا على المجتمع العلماني الذي ينظر بعين العداء للأحزاب الدينية ويتهمها بالتخلف، وأن جمهور المتدينين العريض، يُشكّلون عبئاً على المجتمع والاقتصاد ولا يساهموا في تَحملّ العبء الأمني.
ويعتقد “براك” أن إضعاف المؤسسة القضائية، سيؤسس لصراعٍ داخلي، ويؤدي إلى انفجار أزمات كامنة، كان مؤجلًا حلها تاريخيًا، وأهمها أزمة هوية الدولة، والصراع بين التيارين العلماني والديني.
ولعل ما يثير القلق لدى التيار العلماني أنه تجري عملية تديين الصهيونية بدل علمنتها مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تَحوّل الصهيونية إلى أيديولوجيا وبنية، بعبارةٍ أخرى هيمنة تيار “الصهيونية الدينية” على الدولة والمجتمع إلى جانب هيمنة الأحزاب الأرثوذكسية كشاس ويهودت هتوراة، ومن ناحيةٍ ثانية، فإن الإخلال بالنظام القضائي، سيؤدي إلى الاجحاف بحقوق “العرب الإسرائيليين” وسيقود إلى انفجار الصراع القومي، وإلى تفاقم الصراع المشتعل أصلًا مع الفلسطينيين، وفقدان “اسرائيل” لعلاقات السلام مع بعض الدول العربية والعودة إلى مربع الحروب مع العرب.
أما من ناحية العلاقة مع الخارج، فقد تؤدي عملية إضعاف القضاء إلى انزياح “إسرائيل” عن النموذج الغربي – العلماني والديمقراطي، مما سيؤدي إلى تشوه صورتها في العالم، ويحد من تدفق رأس المال، ويضر بالعلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية، ويؤدي إلى تراجع الهجرة ويشجع على الهجرة المعاكسة، كما سيؤدي إلى تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، وسيحد من قدرة “إسرائيل” على تسويق نفسها على أنها “واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأنها دولة قانون وحقوق إنسان تنشد السلام والاستقرار، وعندها سيجري وصمها بالشمولية، والفاشية، ودولة الابارتهايد، مما سيؤدي إلى إضعاف صورتها في الرأي العام العالمي، ويحد من قدرتها على التأثير في الساحة الدولية، وسيؤثر على علاقاتها مع دول الغرب، وبالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هكذا يرى العلمانيون الصورة التي ستكون عليها “إسرائيل” في الداخل والخارج. أما اليمين الحاكم فلا يرى الصورة إلا من زاويته الأيديولوجية، ومصالح الفئات والقطاعات التي يُمثلها.
ويعتقد اليمين “الإسرائيلي”، أن توجهاته وسياساته هو النموذج الحقيقي للصهيونية، ويتهم الأطراف المعارضة بالانحراف عن الأهداف الصهيونية العليا، لذلك لن يتراجع عن خطته الانقلابية ضد السلطة القضائية، لأنها تتيح له البقاء في سدة الحكم.
أما من زاوية العلاقة مع الخارج، فيرى اليمين أن النموذج الغربي لا ينطوي فقط على المضامين الديمقراطية والليبرالية، وإنما أيضاً ثمة اتجاهات يمينية وفاشية في النموذج الغربي، تفوق حتى مواقف وتوجهات اليمين “الاسرائيلي” (ترامب مثلًا- وبعض الأحزاب والحركات اليمينية في أوروبا).
وقد وصلت الأزمة القائمة، إلى مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش والشرطة والأذرع الأمنية، التي انقسمت بشأن الخطة الإصلاحية، ما بين مؤيدين لها ومعارضين.
ويرى قادة هذه المؤسسات، أن الإصلاحات القضائية ستتيح لقوى اليمين تسييس الجيش والشرطة والأمن، مما سيقود إلى تآكل المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإضعافها وصولاً إلى تمزقها واندلاع صراعات في داخلها.
وفي المجمل، تُعتبر المؤسسة القضائية قلب الدولة العلمانية والحارسة على نظامها السياسي، وعلى التوازن بين المكونات الاجتماعية والسياسية المتنافرة. وإن أي تقييد في أسس النظام القضائي، سَيخّل بالضرورة بالنظام السياسي، وفي العلاقة المتوترة أصلاً بين المكونات الاجتماعية والدينية والعرقية والقومية، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية، وإلى خراب البيت الثالث، كما يرى المحتجون على خطة الإصلاح القضائية.
* عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كاتب وأديب وشاعر، ومفكر