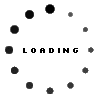مناورات الناتو «الظهيرة الصامدة»:
نظرة استراتيجية شاملة لتحول الدفاع الأوروبي

وحدة الدراسات الاستراتيجية – مركز “فيجن” للدراسات الاستراتيجية
13\10\2025
تنطلق اليوم مناورات «الظهيرة الصامدة» بقيادة هولندا، بمشاركة 14 دولة من أعضاء الحلف الأطلسي “ناتو”، بمشاركة نحو 71 طائرة متنوعة تشمل مقاتلات F-35 و F-16، وقاذفات استراتيجية بعيدة المدى، إضافة إلى طائرات للتزود بالوقود والدعم اللوجستي والقيادة الجوية. تجري هذه المناورات فوق بحر الشمال، انطلاقاً من قواعد عسكرية في هولندا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك، بما يعكس الطابع المتعدد الجنسيات والقدرة على التنسيق العملياتي عبر مسارح مختلفة. ورغم أنها مناورات سنوية روتينية في جدول الناتو، فإنها هذا العام تحمل دلالات استراتيجية أعمق، إذ تسعى إلى تثبيت مصداقية الردع النووي للحلف من خلال محاكاة دقيقة لعمليات نقل وتجهيز الأسلحة النووية المخزنة في أوروبا ضمن ترتيبات «المشاركة النووية»، مع التركيز على اختبار سرعة الاستجابة ومرونة القيادة والسيطرة.
وتتجاوز المناورات الطابع التقليدي لتشمل دمج طبقات حماية متقدمة ضد التهديدات الحديثة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة التي أثبتت فعاليتها في ساحات القتال المعاصرة، إضافة إلى محاكاة هجمات سيبرانية تستهدف شبكات القيادة والاتصالات، وتدريبات على مواجهة التشويش الإلكتروني الذي قد يعطل أنظمة الملاحة أو الاتصالات العسكرية. هذا الدمج بين الردع النووي التقليدي ومفاهيم الحرب الهجينة يعكس إدراك الحلف أن التهديدات لم تعد مقتصرة على المواجهة المباشرة، بل تشمل أيضاً محاولات الاختراق غير التقليدية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.
كما تلتزم المناورات بقواعد اشتباك صارمة تهدف إلى تقليص هامش “سوء الفهم” مع روسيا، وإدارة مخاطر التصعيد غير المقصود، خصوصاً في ظل الأجواء المشحونة على الجناح الشرقي للحلف. وبذلك، فإن مناورات «الظهيرة الصامدة» لا تمثل مجرد تدريب عسكري، بل هي رسالة سياسية وعسكرية مزدوجة: من جهة تأكيد وحدة الصف الأطلسي واستعداده لحماية أراضيه، ومن جهة أخرى إظهار قدرة الحلف على التكيّف مع طبيعة التهديدات الجديدة التي تمزج بين النووي والتقليدي والهجين في آن واحد.
يحمل اختيار بحر الشمال مسرحاً لمناورات «الظهيرة الصامدة» دلالات استراتيجية دقيقة، فهو فضاء بعيد نسبياً عن الحدود الروسية المباشرة، ما يتيح للحلف إرسال رسالة ردعية قوية دون الانزلاق إلى استفزاز ميداني قد يفاقم التوتر. هذا الانتشار في منطقة مزدحمة بالطيف الكهرومغناطيسي والأنشطة البحرية والجوية يوفّر فرصة لاختبار قدرات الإسناد الجوي–البحري، والتنسيق بين أنظمة الاتصالات والرصد في بيئة عملياتية معقدة تحاكي ظروف الحرب الحديثة.
أما اختيار هولندا وبلجيكا كمحاور رئيسية في المناورات، فيرتبط بوزن عملي وسياسي مزدوج. فهولندا تحتضن قاعدة «فولكل» النووية، وبلجيكا تضم قاعدة «كلاينه بروجل» إلى جانب مقري الحلف السياسي في بروكسل والعسكري في مونس، ما يجعلها قلب الناتو المؤسسي. هذا البعد الرمزي يعزز مصداقية التمرين ويؤكد أن الردع النووي ليس مجرد خطاب بل منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية قائمة. وفي السياق ذاته، تضيف بريطانيا قيمة عملياتية من خلال قدراتها الاستطلاعية بعيدة المدى، التي تتيح مراقبة المجال البحري والجوي وتوفير إنذار مبكر لأي تهديد محتمل.
أما إشراك الدنمارك، فجاء استجابة مباشرة للتهديدات الفعلية التي واجهتها خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت اختراقات متكررة لمجالها الجوي بطائرات مسيّرة فوق مطاراتها ومنشآتها الحيوية. مشاركة كوبنهاغن في هذه المناورات تمثل رسالة واضحة بأن الناتو يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وأنه مستعد لتأمين جناحه الشمالي عبر تعزيز جاهزية الدفاع القريب من البنى التحتية الحساسة. بهذا المعنى، فإن اختيار الدول المضيفة لا يعكس فقط اعتبارات جغرافية، بل يجسد أيضاً توازناً بين الرمزية السياسية، والجاهزية العملياتية، والاستجابة المباشرة للتحديات الأمنية الراهنة.
تشمل مناورات «الظهيرة الصامدة» لهذا العام مجموعة من السيناريوهات المعقدة التي تهدف إلى اختبار جاهزية الحلف في مواجهة طيف واسع من التهديدات، من النووي التقليدي إلى الهجين والرقمي.
أولاً – النقل والتجهيز النووي الافتراضي متعدد الوسائط: يتم التدريب على محاكاة قوافل جوية وبحرية تنقل ذخائر نووية افتراضية إلى قواعد محددة مثل «فولكل» في هولندا و«كلاينه بروجل» في بلجيكا. ويجري ذلك عبر تكامل بين المقاتلات والقاذفات وطائرات الاستطلاع، مع تدريب فرق الميدان على تأمين منصات التحميل والتفريغ تحت ضغط بيئة عملياتية معقدة تشمل التشويش الإلكتروني وتهديدات منخفضة الشدة. الهدف هو ضمان أن تبقى سلسلة النقل والتجهيز محمية وفعّالة حتى في ظروف اضطراب الاتصالات أو تعرضها لهجمات هجينة.
ثانياً – حماية المواقع من المسيّرات والتخريب: تُعطى أولوية خاصة لمواجهة الطائرات بدون طيار التي أصبحت أداة رئيسية في الحروب الحديثة. يتم نشر فرق مختصة مزودة بأنظمة اعتراض وتشويش، مع تفعيل حواجز إلكترونية واتصالات آمنة، إضافة إلى إجراءات إغلاق سريع للمحيط العملياتي عند رصد أهداف منخفضة البصمة. هذا السيناريو يعكس إدراك الحلف أن المسيّرات لم تعد تهديداً تكتيكياً فحسب، بل أداة استراتيجية لاختراق الدفاعات وإرباك البنى التحتية.
ثالثاً – الدفاع الإلكتروني والسيبراني: تتضمن المناورات محاكاة هجمات سيبرانية تستهدف شبكات القيادة والسيطرة، مع بروتوكولات لاستعادة الأنظمة بسرعة، وتعقّب مصدر الاختراق، ودمج تحليلات فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمييز الأهداف الصديقة من المعادية. الهدف هو تقليل الإنذارات الكاذبة وضمان استمرار تدفق المعلومات الحيوية في بيئة مشبعة بالتشويش والاختراقات.
رابعاً – الاستجابة النووية التكتيكية والإغاثة: يتم اختبار استعداد الوحدات للتعامل مع إنذارات وهمية باختراق قواعد نووية، بما يشمل إجراءات الإخلاء السريع، وتفعيل قنوات الاتصال الاستراتيجي للتفاوض أو التنسيق، إضافة إلى تشغيل ملاجئ محصنة ضد النبضات الكهرومغناطيسية (EMP). كما يتضمن السيناريو تدخلاً طبياً وإغاثياً بعد «حادث تسريب إشعاعي» رمزي، يشمل إنشاء مناطق عزل، وتوظيف طائرات بدون طيار لمسح ميداني وتقييم الأضرار.
هذه السيناريوهات تُظهر أن الناتو لم يعد يتعامل مع الردع النووي كعنصر منفصل، بل كجزء من منظومة دفاعية متكاملة تشمل الحماية من المسيّرات، الدفاع السيبراني، والاستجابة للأزمات النووية والإنسانية. وبذلك، تتحول المناورات من مجرد استعراض للقوة إلى مختبر عملي لاختبار جاهزية الحلف أمام التهديدات المركبة التي تمزج بين النووي والهجين في آن واحد.
ويشكّل الربط بين مناورات «الظهيرة الصامدة» وقرار قمة كوبنهاغن بإنشاء «جدار المسيّرات» خطوة نوعية في مسار الدفاع الأوروبي. فالمشروع الذي وُلد كفكرة سياسية لمواجهة التوغلات المتكررة للطائرات المسيّرة في أجواء الدنمارك وبولندا ودول البلطيق، يتحول اليوم إلى اختبار تشغيلي ميداني داخل المناورات. لم يعد الحديث عن شبكة دفاعية مجرد تصور نظري، بل أصبح جزءاً من سيناريوهات عملية تشمل طبقات الرصد المبكر، المستشعرات المتقدمة، أنظمة التشويش، ومنصات الاعتراض.
هذا الدمج يعكس إدراك الحلف أن التهديدات الحديثة لا يمكن مواجهتها إلا عبر منظومة متكاملة متعددة المستويات، تتناسق مع الدفاعات الثابتة مثل منظومات «آيجيس آشور» في بولندا ورومانيا، وتتكامل مع قدرات الدفاع الجوي القصير والمتوسط المدى المنتشرة في دول البلطيق وألمانيا. وبذلك، تتحول المناورات إلى مختبر عملي لاختبار التشغيل البيني بين الجيوش الأوروبية، وقدرتها على إدارة الطيف الكهرومغناطيسي بكفاءة، وضمان أمن الشبكات العسكرية في بيئة مشبعة بالتشويش والهجمات السيبرانية.
كما أن هذه التجربة العملية تكشف بشكل مباشر الفجوات التقنية والمالية التي تعيق بناء «جدار المسيّرات» على نطاق واسع. فالتباين في معايير الرادارات الوطنية، واختلاف بروتوكولات الاتصال، إضافة إلى الانقسام حول آليات التمويل المشترك، كلها تحديات تظهر بوضوح عند محاكاة سيناريوهات هجومية معقدة. ومن هنا، فإن المناورات لا تقتصر على إرسال رسالة ردعية لموسكو، بل تؤدي أيضاً وظيفة داخلية أساسية: تحديد نقاط الضعف قبل التوسيع إلى كامل الجناح الشرقي، وضمان أن المشروع لن يبقى حبراً على ورق، بل يتحول إلى قدرة دفاعية ملموسة وفعّالة.
إن الربط بين المناورات ومشروع «جدار المسيّرات» يوضح أن أوروبا بدأت بالفعل في الانتقال من القرارات السياسية الرمزية إلى الاختبارات التشغيلية الواقعية، في محاولة لبناء مظلة دفاعية موحدة قادرة على مواجهة التهديدات الهجينة الروسية، وتعزيز الردع الجماعي على حدودها الشرقية.
تحديات تنفيذ «جدار المسيّرات»
يمثل مشروع «جدار المسيّرات» أحد أكثر المبادرات الدفاعية الأوروبية طموحاً في العقد الأخير، لكنه يواجه عقبات معقدة قد تؤخر تنفيذه أو تحدّ من فعاليته.
أولاً – المعايير والتكامل التقني: تختلف مواصفات الرادارات الوطنية وأنظمة الرصد بين الدول الأوروبية، من ألمانيا وإيطاليا إلى بولندا ودول البلطيق، ما يخلق فجوة في التشغيل البيني. كما أن قيود توريد المعالجات عالية الأداء (GPUs) من الولايات المتحدة واليابان، في ظل قيود تصدير التكنولوجيا، تعرقل تطوير أنظمة معالجة الصور والذكاء الاصطناعي اللازمة لرصد المسيّرات منخفضة البصمة. هذا يفرض الحاجة إلى بروتوكولات موحدة وتدريب مشترك معمّق، يضمن أن تعمل الشبكات الدفاعية كمنظومة واحدة لا كمجموعة جزر منفصلة.
ثانياً – التمويل والحوكمة: الجدل السياسي حول آليات التمويل يشكل عقبة مركزية. فبينما تدعو المفوضية الأوروبية وبعض الدول إلى إصدار دين أوروبي مشترك لتمويل المشروع، تتمسك دول أخرى مثل ألمانيا وبعض دول شرق أوروبا بالتمويل الوطني المستقل، خشية فقدان سيادتها على قرارات المشتريات الدفاعية. يضاف إلى ذلك المخاوف من مركزية مفرطة في بروكسل قد تُبطئ سرعة الاستجابة. ومع وجود نافذة زمنية ضيقة لتخصيص التمويل قبل دورات الميزانية القادمة (2028)، يصبح المشروع مهدداً بالتأجيل أو التنفيذ الجزئي.
ثالثاً – الفجوة الصناعية والقدرات: تتمتع بعض دول الشرق، مثل بولندا والتشيك ودول البلطيق، بقدرات متقدمة في مجال مكافحة المسيّرات، بينما تعاني دول غربية من فجوات في الإنتاج والتطوير. هذا التفاوت يفرض الحاجة إلى خطوط إنتاج دقيقة ضمن برامج التعاون الدفاعي الدائم (PESCO)، ونقل سريع للتكنولوجيا، إضافة إلى بناء مخزون استراتيجي من قطع الغيار يضمن استدامة المنظومة وعدم تعطّلها في أوقات الأزمات.
وهذا يعني أن مشروع «جدار المسيّرات» ليس مجرد مبادرة تقنية، بل هو اختبار سياسي وصناعي وأمني لقدرة أوروبا على توحيد معاييرها، وتجاوز خلافاتها التمويلية، وبناء قاعدة صناعية مشتركة. نجاحه سيعني ولادة أول شبكة دفاعية أوروبية متكاملة ضد التهديدات الهجينة، أما فشله فسيكشف هشاشة البنية الدفاعية الأوروبية أمام التحديات الروسية المتصاعدة.
أثر المناورات على ديناميات الناتو–روسيا
تمثل مناورات «الظهيرة الصامدة» لحظة حساسة في معادلة الردع بين الناتو وروسيا، إذ تجمع بين إظهار القدرة العملياتية للحلف وبين الحرص على عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تُفسَّر كتصعيد مباشر. فالمناورات، رغم طابعها الروتيني، تُرسل رسالة واضحة لموسكو بأن الحلف يمتلك القدرة على تعبئة قواته الجوية والنووية التكتيكية بسرعة، وأن منظومة الردع لا تزال متماسكة وفعّالة. في المقابل، تدفع هذه الرسائل روسيا إلى تنظيم تدريبات مقابلة، وتعزيز وجودها العسكري في مناطق حساسة مثل كالينينغراد والبلطيق، عبر نشر أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل «إس-400» وصواريخ «إسكندر» التكتيكية، في محاولة لإظهار أن ميزان القوى لا يزال قائماً.
لكن في ظل هذا التصعيد المتبادل، يبقى خفض التصعيد صمام أمان أساسياً. فالحلف وروسيا يدركان أن أي حادث ملاحي أو تشويش غير منسّق قد يؤدي إلى أزمة غير مقصودة. لذلك، تُبقي الأطراف على قنوات الاتصال العسكرية المباشرة (Hotline) مفتوحة، مع تفاهم ضمني على تجنّب الاقتراب المتهوّر من الحدود الجوية والبحرية الحساسة. هذه الآليات لا تمنع التوتر، لكنها تقلل من احتمالية تحوله إلى مواجهة مفتوحة.
في الوقت نفسه، تساهم المناورات في تغذية سباق تسلح محدود، حيث تتزايد كثافة الأنشطة العسكرية شرقاً وشمالاً، سواء عبر تعزيز الدفاعات الجوية أو تكثيف الدوريات البحرية في بحري الشمال والبلطيق. غير أن هذا التصاعد يبقى مراقباً ومضبوط الإيقاع، إذ يسعى الطرفان إلى منع ما يمكن تسميته بـ«عدوى الأزمات» التي قد تمتد من حادث محلي إلى أزمة إقليمية شاملة.
وبذلك، يمكن القول إن أثر المناورات على ديناميات الناتو–روسيا مزدوج: فهي من جهة تعزز الردع وتؤكد الجاهزية، ومن جهة أخرى تفرض على الطرفين إدارة دقيقة للمخاطر، بما يضمن استمرار التوازن دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة قد تكون عواقبها غير محسوبة.
اتساع نطاق المناورات المشتركة في 2025
اتجه حلف شمال الأطلسي خلال عام 2025 إلى تنفيذ أكبر تمرين عسكري في تاريخه الحديث على الجناح الشرقي، حيث انطلقت فعالياته الرئيسية في 19 فبراير/شباط 2025 وتستمر على مراحل متتابعة طوال العام. يشارك في هذه المناورات 32 دولة عضو وشريكة، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً بأن التهديدات الروسية لم تعد محصورة في أوكرانيا، بل باتت تمسّ كامل البنية الأمنية الأوروبية. وتجري التدريبات في رومانيا وبلغاريا واليونان، متضمنة سيناريوهات حرب شاملة تشمل عمليات برية وجوية وبحرية، إلى جانب أنشطة هجينة مثل الهجمات السيبرانية، التشويش الإلكتروني، وحملات التضليل الإعلامي.
الهدف المركزي لهذه المناورات هو اختبار قدرة الناتو على الانتشار السريع، وضمان مرونة الإمداد اللوجستي من الوقود والذخائر إلى الدعم الطبي والاتصالات، وتعزيز تناسق القيادة متعددة المستويات، من القيادة العليا في بروكسل إلى الوحدات الميدانية المنتشرة على الأرض. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من تغير المزاج السياسي في واشنطن، ما يدفع القارة إلى توسيع قدراتها الذاتية وتقليص فجوات الاعتماد على الحليف الأمريكي، سواء عبر رفع الإنفاق الدفاعي، أو تعزيز الصناعات العسكرية المحلية، أو تطوير شبكات دفاع جوي وصاروخي مستقلة.
وبهذا المعنى، فإن اتساع نطاق المناورات المشتركة في 2025 يمثل تحولاً استراتيجياً مزدوجاً. من جهة، تأكيد وحدة الصف الأطلسي واستعداده لمواجهة أي تهديد مباشر، ومن جهة أخرى، بداية مسار أوروبي نحو بناء استقلالية دفاعية نسبية، تُمكّن القارة من الصمود حتى في حال تغيّرت أولويات الحليف الأمريكي أو تراجعت درجة التزامه الأمني.
الحرب الهجينة ومسارات الرد غير التقليدي
تتجلى طبيعة الحرب الهجينة التي تواجهها أوروبا في تعدد أدواتها وتشابكها. فالهجمات لم تعد مقتصرة على المجال العسكري التقليدي، بل تشمل مسيّرات منخفضة البصمة قادرة على اختراق الأجواء دون رصد مبكر، واختراقات سيبرانية تستهدف شبكات القيادة والسيطرة، إضافة إلى أضرار متعمدة بكابلات الاتصالات تحت البحر التي تمثل شرايين الاقتصاد الرقمي الأوروبي. وإلى جانب ذلك، تُشنّ حملات تضليل إعلامي تهدف إلى زعزعة الثقة بين الشعوب الأوروبية ومؤسساتها، وإضعاف القدرة على اتخاذ القرار الموحد داخل الحلف. هذه التهديدات، كما وصفتها مؤخراً رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ليست حوادث عشوائية بل «حملة متماسكة ومتصاعدة» تهدف إلى زرع الانقسام داخل أوروبا.
في مواجهة هذا النمط من التهديدات، يتجه الحلفاء إلى مسارات رد غير تقليدية. أولها تعزيز الأمن السيبراني المتقدم عبر إنشاء مراكز أوروبية متخصصة، مثل المركز الجديد في العاصمة الاستونية تالين، لتنسيق الدفاع الرقمي ورصد الاختراقات في الزمن الحقيقي. ثانيها استخدام الضغط الاقتصادي المرن من خلال حزم عقوبات متدرجة تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي، بما يتيح مرونة في الردع دون استنزاف شامل. ثالثها تطوير إعلام استراتيجي مضاد يواجه حملات التضليل عبر منصات رقمية موحدة، ويعزز الثقة المجتمعية في المؤسسات الأوروبية.
إلى جانب ذلك، يجري العمل على شراكات منظمة مع القطاع الخاص، خصوصاً في مجالات الطاقة والاتصالات، لضمان حماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية أو التخريب المادي. كما يتم تشكيل خلايا مشتركة عبر الحدود لرصد المؤشرات المبكرة لأي هجوم هجين، وتنسيق الردود بسرعة بين الدول الأعضاء، بما يقلل من فجوات القرار ويمنع استغلالها من قبل موسكو.
وهكذا نرى ان الحرب الهجينة الروسية في أوروبا تمثل تحدياً شاملاً يتجاوز حدود الجيوش، إذ تستهدف المجتمع والاقتصاد والبنية التحتية بنفس القدر الذي تستهدف فيه القوات المسلحة. لذلك، فإن الرد الأوروبي لم يعد محصوراً في المناورات العسكرية أو الردع النووي، بل أصبح يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الأمن السيبراني، الردع الاقتصادي، الإعلام الاستراتيجي، والشراكات المدنية–العسكرية، لضمان صمود الجبهة الداخلية الأوروبية بقدر صمود جبهاتها العسكرية.
الخلافات الداخلية والدعامة الصناعية
تُظهر التحديات الداخلية التي يواجهها الناتو والاتحاد الأوروبي أن التهديدات الخارجية ليست وحدها ما يعرقل بناء منظومة ردع فعّالة، بل إن الانقسامات بين العواصم الأوروبية تمثل عقبة لا تقل خطورة.
أولاً – الانقسام المالي والسيادي: الخلاف حول استخدام الأصول الروسية المجمدة يمثّل أحد أبرز مظاهر الانقسام. فبينما تدفع بعض الدول الكبرى نحو توظيف هذه الأصول لتمويل دعم أوكرانيا أو تعزيز الدفاعات الشرقية، تتحفظ دول أخرى مثل المجر وسلوفاكيا، خشية التداعيات القانونية والسياسية. يضاف إلى ذلك الجدل حول تمويل الدفاع المشترك. فالمفوضية الأوروبية تدعو إلى أدوات تمويل جماعية، بينما تتمسك بعض الحكومات بحقها في إدارة ميزانياتها الدفاعية بشكل مستقل، ما يؤدي إلى إبطاء القرارات وتأخير نشر الشبكات الدفاعية المتكاملة مثل مشروع «جدار المسيّرات».
ثانياً – قصور التمويل المشترك للحلف: رغم أن الناتو يمتلك ميزانية مشتركة تقارب 4.6 مليار يورو لعام 2025، فإن هذه الموارد تبدو محدودة للغاية مقارنة بحجم الاحتياجات الدفاعية المتزايدة. النتيجة أن العبء الأكبر يقع على المساهمات الوطنية غير المباشرة، أي القوات والقدرات التي توفرها كل دولة على حدة. هذا الوضع يخلق تفاوتاً واضحاً بين الدول القادرة على بلوغ عتبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي (الحالي) المقررة للإنفاق الدفاعي، وتلك التي لا تزال متأخرة عن هذا الهدف، ما يضعف التوازن داخل الحلف ويؤثر على مصداقية الردع الجماعي.
ثالثاً – تباطؤ التوحيد التشغيلي: إلى جانب التمويل، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في التباينات التقنية والعقود الوطنية. فاختلاف أنظمة التسليح والرادارات ومنصات القيادة بين الدول الأعضاء يطيل زمن توحيد المواصفات والمعايير، ويعرقل بناء منظومة تشغيلية موحدة قادرة على الانتشار السريع في حالات الطوارئ. كما أن العقود الدفاعية الوطنية، التي غالباً ما تُبرم بدوافع سياسية أو اقتصادية داخلية، تُضعف فرص التوحيد الصناعي وتؤخر تطوير قاعدة صناعية أوروبية مشتركة قادرة على تلبية متطلبات الحلف بشكل متكامل.
وهكذا، فإن الخلافات الداخلية والدعامة الصناعية تمثل نقطة ضعف استراتيجية في منظومة الدفاع الأوروبية–الأطلسية. فبدون حسم الجدل حول التمويل والسيادة، وزيادة الموارد المشتركة، وتسريع توحيد المواصفات والمعايير الصناعية والتشغيلية، سيبقى الحلف معرضاً لبطء الاستجابة في مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة. نجاح أوروبا في تجاوز هذه العقبات سيكون العامل الحاسم في تحويل الإرادة السياسية المعلنة إلى قدرات دفاعية ملموسة وفعّالة.
التحول الاستراتيجي الأوروبي
يشهد الدفاع الأوروبي تحولاً استراتيجياً عميقاً، مدفوعاً بتصاعد التهديدات الروسية وتنامي الحرب الهجينة. هذا التحول لا يقتصر على زيادة الإنفاق العسكري، بل يمتد إلى إعادة صياغة العقيدة الدفاعية لتشمل الأبعاد التقليدية والرقمية والمجتمعية في آن واحد.
تتبنى أوروبا مقاربة تدريجية لرفع الإنفاق الدفاعي، بحيث تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العقد، مع هدف طموح يبلغ 5% بحلول عام 2035. هذه الزيادة لا تقتصر على شراء الأسلحة التقليدية، بل تشمل الاستثمار في الأمن السيبراني، حماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز المرونة المجتمعية لمواجهة الهجمات الهجينة. هذا الربط بين الدفاع العسكري والأمن المدني يعكس إدراكاً بأن الحروب الحديثة تستهدف المجتمعات بقدر ما تستهدف الجيوش.
ويتجه الحلف كذلك إلى بناء منظومة دفاع جوي وصاروخي متكاملة، تربط بين أنظمة باتريوت، IRIS-T، وNASAMS، مع دمجها في شبكة موحدة من الرصد والتشويش والاعتراض. هذه الشبكة لا تقتصر على الدفاع الجوي فحسب، بل تمتد إلى تكامل الوحدات السيبرانية والإلكترونية ضمن تشكيلات البر والبحر والجو، بحيث يصبح الدفاع الأوروبي منظومة شبكية متكاملة قادرة على مواجهة التهديدات التقليدية والهجينة في وقت واحد.
بالإضافة الى ذلك، يُعد الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في هذا التحول، إذ يُستخدم لتمييز الأهداف تلقائياً، وتقليل الإنذارات الكاذبة التي قد تربك أنظمة الدفاع، وتوجيه التشويش أو الاعتراض وفق تحليل آني للبيانات. هذا التطور يرفع كثافة الغطاء الدفاعي ويُقلّص تكلفة الاعتراض، خصوصاً في مواجهة أسراب المسيّرات منخفضة التكلفة التي قد تُنهك الدفاعات التقليدية. كما أن تقنيات الاستشعار المتقدمة تتيح مراقبة المجال الجوي والبحري بدقة أعلى، ما يعزز القدرة على الردع المبكر.
إن هذا التحول الاستراتيجي الأوروبي يعكس انتقال القارة من الاعتماد على المظلة الأطلسية التقليدية إلى بناء قدرات مستقلة هجينة، تمزج بين القوة الصلبة (الإنفاق والتسليح) والقوة الذكية (الذكاء الاصطناعي والسيبرانية). هذا المسار، إذا اكتمل، سيجعل أوروبا أكثر قدرة على الصمود أمام التهديدات، وأكثر استقلالية في صياغة قراراتها الدفاعية على المدى الطويل.
آفاق الدفاع الأوروبي: مناورات اليوم ورهانات الغد
إن مستقبل الدفاع الأوروبي لم يعد يُقاس بمدى نجاح المناورات أو بقرارات سياسية آنية، بل بات يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تضمن الاستدامة والجاهزية في مواجهة التهديدات الروسية والهجينة. هذه الرؤية تقوم على مسارات متكاملة تتعاضد فيما بينها لتشكيل بنية دفاعية أكثر صلابة.
أحد أبرز هذه المسارات هو بناء سلاسل إنتاج قصيرة وآمنة، بعدما أثبتت الحرب في أوكرانيا خطورة الاعتماد المفرط على التوريد الخارجي في ظل قيود التصدير والتوترات الجيوسياسية. لذلك يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تطوير قدرات تصنيع داخلية تشمل المستشعرات والمشغلات والبرمجيات الدفاعية، بما يعزز الاستقلالية الاستراتيجية ويؤسس لقاعدة صناعية أوروبية قادرة على تلبية الاحتياجات بسرعة ومرونة.
في موازاة ذلك، يجري الاستثمار في منصات تدريب افتراضية مشتركة مع دول الجناح الشرقي، تتيح محاكاة سيناريوهات هجينة معقدة وتدريب القوات على التنسيق عبر الحدود قبل وقوع التهديدات الفعلية. هذه المنصات الرقمية توفر تجارب متكررة منخفضة التكلفة وتزيد من الجاهزية دون الحاجة إلى نشر واسع النطاق.
كما يبرز دور الحوار الاستراتيجي المنسّق بين الناتو والاتحاد الأوروبي، إذ إن تعدد مراكز القرار يفرض الحاجة إلى آلية دائمة تضمن مواءمة التمويل والقيادة، واستباق العقبات السياسية والبيروقراطية التي قد تعرقل الاستجابة للأزمات. هذا الحوار يسهم في تحديد أولويات الاستثمار ويحول دون الازدواجية في المشاريع الدفاعية.
ولا يكتمل هذا البناء من دون تمكين المجتمع وحشد الدعم السياسي. فنجاح أي مشروع دفاعي يتطلب تأييداً شعبياً واسعاً، وهو ما يستدعي توعية المجتمعات الأوروبية بالمخاطر وتقديم صورة شفافة عن الأهداف الدفاعية، بما يعزز الثقة ويمنع استغلال الثغرات من قبل حملات التضليل. كما أن حشد التأييد للإصلاحات الصناعية والمالية يضمن استدامة التمويل ويحافظ على الالتزام رغم تغير الحكومات أو تبدل الأولويات.
إن آفاق الدفاع الأوروبي تُبنى على قاعدة صناعية مرنة، وتدريب افتراضي متقدم، وحوار مؤسسي منسّق، مدعومة بوعي مجتمعي وسياسي واسع. هذه الركائز ستحدد ما إذا كانت أوروبا قادرة على تحويل قراراتها الدفاعية إلى قدرات عملية مستدامة، تُمكّنها من مواجهة التهديدات الروسية والهجينة حتى ما بعد عام 2030.
مناورات تفتح مرحلة جديدة في الردع الأوروبي–الأطلسي
مناورات «الظهيرة الصامدة» هذا العام ليست مجرد حدث رمزي أو استعراض للجاهزية، بل هي اختبار عملي شامل لمنظومة الردع النووي في تفاعل مباشر مع تحديات الحرب الهجينة التي باتت السمة الأبرز للصراع مع روسيا. فهي اليوم منصة لتجريب التكامل بين الردع النووي التقليدي والدفاعات متعددة الأبعاد: الجوية، السيبرانية، والإلكترونية، بما يعكس انتقال الحلف من الطابع الاستعراضي إلى التمرين التشغيلي المركّب.
تخضع أوروبا اليوم لإعادة تشكيل دفاعي شامل، يقوم على بناء شبكة متعددة الطبقات تمتد من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي إلى الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية. غير أن نجاح هذا التحول لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل يتوقف على قدرة الحلفاء على تجاوز الخلافات الداخلية حول التمويل وآليات القيادة، وتسريع خطوات توحيد المعايير والتشغيل البيني بين الأنظمة الوطنية المختلفة. كما يتطلب الأمر إنشاء قاعدة صناعية مرنة قادرة على تلبية احتياجات الطوارئ بسرعة، وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية قد تصبح غير مضمونة في أوقات الأزمات.
الهدف الاستراتيجي لهذه المرحلة واضح: إنشاء قدرات يصعب التشويش عليها أو تعطيلها، وتوفير مظلة ردع تقلّص هامش الخطأ الاستراتيجي في شمال وشرق أوروبا، حيث يبقى خطر الاحتكاك المباشر مع روسيا قائماً. وفي المقابل، يبقى الحفاظ على خطوط خفض التصعيد مفتوحة ضرورة قصوى، حتى لا تتحول رسائل الردع إلى أزمات غير مقصودة قد تخرج عن السيطرة.
بهذا المعنى، فإن «الظهيرة الصامدة» ليست مجرد مناورة عسكرية، بل إعلان عن مرحلة جديدة في العقيدة الدفاعية الأوروبية–الأطلسية، مرحلة تقوم على الدمج بين الردع النووي والجاهزية الهجينة، وعلى التوازن بين الحزم العسكري والانضباط السياسي، بما يضمن أن يبقى الردع أداة استقرار وردع محسوب، لا شرارة مواجهة غير مقصودة.