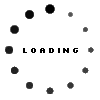“طوفان التحرير”.. المستحيل غدا ممكنًا!

د. وسام الفقعاوي
باحث وكاتب سياسي
16/11/2023
“الاستعمار تلميذٌ غبي”! جملة قالها القائد الفيتنامي فو نغوين جياب في خطاب له خلال زيارته للجزائر، وهي تُكثف قناعته وحصيلة تجربته العسكرية الغوارية التي مفادها أن مقولات التفوق وحدها، لا تُحسم على مستوى الاحصائيات والأفراد والعتاد، بل في ميدان المعركة، لأن الذكاء في الأخير هو الذي ينتصر على منطق القوة. هذا التأكيد على حتمية النصر، أتى رغم أن توازن القوى وقتها في ميدان المعركة؛ كان في صالح الجيشين الفرنسي والأميركي، لكن استطاعت مقاومة شعبية بقيادة ثورية أن تهزمهم؛ هزيمة ساحقة. ذات المقاربة، تصلُح لأن نضعها قيد النقاش، في الفتح/النصر الكبير الذي جرى يوم السابع من أكتوبر “طوفان الأقصى”.
“الجيش الذي لا يقهر”: انهيار الذاتية الصهيونية
خلال دقائق معدودة ودون معارك جدية، يُفترض أنه مجهز لها، كقوات وأفراد وتدريبات ولوجستيات واستخبارات؛ انهار أقوى جيش في المنطقة، ولم يصمد أمام تكتيكات المقاومة الشعبية التي لم يخطّها أبرع قادة حركات التحرر في العالم: جياب وماوتسي تونغ وهوشي منه وكاسترو وتشي جيفارا، لكنها استفادت من تجربتهم، وتفوقت عليهم في ميدان المعركة، من فوق الأرض وتحتها والجو والبحر، عملية لم تكن متكافئة بالمطلق بالحسابات العسكرية الاستراتيجية – ومتى كان هناك تكافؤ بين القوة الغاشمة للمُستعمِر والشعوب المستعمَرة؟ – لكن التفوق كان بالمطلق لأصحاب الحق الذين وعوا شروط استحقاقه بصناعة القوة، واستمرار سياسة الدفاع عن الحق والنفس، إلى أن تهيأ لهم الظرف المناسب للحظة الهجوم ومباغتة ومفاجأة العدو الذي لا يُقهر. هل بقي حقًا لا يقهر؟
منذ السادس من أكتوبر 1973، سقطت هذه الأسطورة التي حاولت البروباغندا الصهيونية زراعتها في الوعي العربي؛ مستفيدة من نتائج حربي/هزيمتي 1948 – 1967 التي لم تحارب فيها الجيوش “النظامية” العربية، والتي لم تكن مجهزة للقتال أصلًا، من حيث العقيدة والتدريب والامكانات، مما جعل الهزيمة واقعة لا محالة، مقابل العدو الذي تجهزت طلائعه “عصاباته” الأولى بالعقيدة والتدريب والامكانات، والاحتضان والدعم والحماية من المنظومة الغربية الاستعمارية.
ففي السادس من أكتوبر 1973، استطاع الجيش المصري منذ لحظة العبور والاشتباك مع جيش العدو على الضفة الغربية للقناة، أن يُسقط هذه الأسطورة/المقولة، ورغم الثغرة الاستراتيجية التي أحدثها “شارون”، إلا أن الحقيقة التي تجسدت هي انتصار الجندي المصري الذي التحم في ميدان المعركة، ورفع علم بلاده في آخر نقطة وصلت إليه قدماه. جولدامائير حينها استنفرت حلفها المعادي، الذي أمدها بجسور المساعدات، من البر والجو -كما يحصل اليوم بالضبط- لكن ما حطمته الحرب، حاولت ترميمه السياسة؛ فالحرب أحد أدوات السياسة العنيفة، فكانت “آخر الحروب”، بتعبير سادات مصر، فهل كان الأمر كذلك فعلًا؟
لقد جاءت 25 أيار 2000، لتقول: أنها لم تكن آخر الحروب، إلا إذا كان يُقصد على الجبهة المصرية، والأمر أيضًا، ليس كذلك؛ فما يزال الجندي الفدائي محمد صلاح شاهدًا ومعه (طبنجة) شرطي الإسكندرية. وضعنا أيار 2000، أمام حقيقة أن هذا الكيان “أوهن من بيت العنكبوت”، حيث استطاعت مقاومة شعبية؛ بتسليح وإمكانات بسيطة، أن تهز أركان أعتى دولة في المنطقة، بل أقواها على الإطلاق، والتي لجأ إليها الكثير من الأنظمة العربية طلبًا للأمن منها، وهنا بالضبط موقع كل ما سُميَّ باتفاقات السلام من كامب ديفيد إلى أبراهام، فالدولة التي صنعها سايكس بيكو – بلفور، مطلوب من الدول/الأجزاء من الوطن العربي، أن تُحصن مناعته، بأن تجعله طبيعيًا على حساب التاريخ والجغرافيا، وتُحصن ذاتها به!
وفقًا لقانون التراكم، فإن السابع من أكتوبر 2023، كان امتدادًا لخطط وتكتيكات قادة حركات التحرر العالمية الأفذاذ، وفدائية الجندي المصري، والعقيدة القتالية لرجال/مقولة: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، لكنه كان بنكهة/عبقرية فلسطينية خاصة، بجذورها الممتدة في فكرة هانوي العربية، التي أدرك العدو وحلفائه من الغرب والعرب خطورتها؛ فجرى وأدها مبكرًا في الانقضاض على قواتها وفصائلها في الأردن وصولًا لمجازر أيلول 70-1971. هذه المرة كانت هانوي الفلسطينية، وعلى أرض مبسوطة لا تتجاوز 360 كيلو مترًا مربعًا، وشريط ساحلي بعمق ضيق، لا تصلح لحرب الغوار، بالمفهوم التقليدي لحرب التحرير الشعبية، وكثافة سكانية هي الأعلى على مستوى العالم، يُضرب عليها حصار مُطبق منذ 17 سنة، وشُنَّ ضدها خمسة حروب مدمرة متتالية، وبينها عدوانات لا تتوقف، وتتجاوز نسبة الفقر بين سكانها 70% – الفقر حين وعي أسبابه حافز للثورة – وهنا كانت “لهانوي الفيتنامية” عبقريتها الفلسطينية الخاصة، وهذه استراتيجية وتكتيك قد تُدرّس لاحقًا في الكليات العسكرية المتخصصة، حيث ضربت في مقتل الذاتية الصهيونية التي كانت دومًا، تعمل إلى التحلق خلف روايتها “التوراتية” وعطاءات الرب لها، وتستل سيف “يهوه” لقتل أعدائه… أصيبت هذه الذاتية في مقتل نعم، بل تحطمت تمامًا، وإلا كيف يمكن أن نفهم تحول الكيان من قاعدة إلى محمية فجأة؟!
لقد استنفر الحلف المعادي أو معسكر الأعداء القديم – الجديد ذاته، حيث تحولت في رمشة عين؛ دولتهم/ربيبتهم/قاعدتهم المتقدمة في خدمة أهدافهم الاستعمارية، وتوفير الأمن لأنظمة سايكس بيكو العربية، إلى مكان يهرع جميعهم إلى حمايته، فهل يحق لنا اعتبار الحرب على غزة، هي حربهم على هانوي الفلسطينية؟!
لقد أجاب المهزوم نتنياهو على ذلك، بأن الانتصار على غزة، هو انتصار للعالم الحر وقيمه!
مجددًا.. المعركة مع من؟
قد يبدو لأي مراقب أو متابع لظاهر الأحداث بأن ما يجري فعليًا هو معركة بين “إسرائيل/الاحتلال” وبين قوى “المقاومة/الإرهاب”، وهذا بالمعنى العياني المباشر لمن يصطف مع الشعب الفلسطيني أو لمن يقف في صف العدو صحيحًا، لكن ما يجب لحظه بعمق أن الحلف المعادي/معسكر الأعداء، هو من يعيد تعريف ذاته في كل مرة، وفي هذه المرة بالذات عن غيرها، بكل وضوح؛ فلماذا إذًا؟
لقد قامت طوال الوقت استراتيجية معسكر الأعداء، على مجموعة عناوين، ليست إلا تطبيقات لاستنفار كافة موارد وإمكانات الحلف الاستعماري الإمبريالي وممارسة سياسة هجومية مباشرة في مواقع بعيدة عن فلسطين، وليست بعيدة عن قضيتها؛ العراق وأفغانستان وسوريا، حتى في حرب أكتوبر 1973، لم يتعدَ الدور الأمريكي؛ إمداد العدو بالقدرات العسكرية والدعم المالي، واحتفظ لنفسه بالدور السياسي الذي تكرّس باتفاقية كامب ديفيد. في هذه المرة كان الأمر مختلفًا؛ فإلى جانب الإمدادات العسكرية غير المنقطعة واستحضار البوارج الحربية، والسخاء المالي، وزيارات قيادات مختلفة من دول الحلف للكيان الصهيوني المهزوم؛ تُساهم قوى الحلف بالعمليات العسكرية الميدانية، حتى يبدو وكأن قادة الحلف وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود الحرب فعليًا على قطاع غزة/هانوي الفلسطينية، وتتحكم بتوقيتات العمليات على الأرض والتفاوض بشأن “الرهائن/الأسرى”، وحتى التحكم بدخول المواد الإغاثية. إنها إذًا معركة كبيرة لها عمقها في التاريخ والجغرافيا معًا، وقد لا تقف عند غزة فقط.
يبدو أن هنالك من بين المفكرين الإمبرياليين من أحسن قراءة رأي قديم لأحد الماركسيين الهنود الأفذاذ “مانا بندرا روي” الذي ارتأى أن الشمال، أي الغرب الرأسمالي الصناعي المتقدم، يمكن أن يُقلب من الجنوب. وفي ضوء تطورات ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن، هي عمر الكيان الصهيوني الفعلي، أتى من الإمبرياليين من يقرأ الأمثولة جيدًا ويقلبها. فهو إذا أدرك وزن الجنوب في توازن الشرق والغرب، فيجب أولًا؛ الحفاظ على الجنوب إذا أُريد للغرب أن يبقى غربًا. وثانيًا؛ عكس المعادلة، لتصبح: حصار الشرق وقلبه من الجنوب.
كانت الرؤية الإمبريالية – وما زالت – واستطرادًا الاستراتيجية الواجب اتباعها واضحة جدًا، هي الهجوم بكل قوة الحلف المعادي، من خلال الأطراف، من الجنوب الذي كان مهمًا بحد ذاته، ولدوره في حصار الشرق، الذي سيتحول دون جنوب ثوري، إلى جزيرة معزولة، وقلعة محاصرة بالكامل، بانتظار أن يكتمل تآكلها الداخلي؛ فيأكلها. أما على المستوى التكتيكي، فإن صفعه في الشرق كانت ستخفف إن لم نقل تعوض الهزيمة التي بدأت تلوح في الأفق الفيتنامي.. هنا تحضر تايوان وأفغانستان وطريق الحرير، كما تحضر روسيا وأوكرانيا وإيران والهند وقناة بن غوريون، حيث تصفع/تهزم “هانوي الفلسطينية”؛ مشروع المؤسس للدولة الذي تحمل القناة اسمه.
من المفيد التذكير هنا، بأنه لولا الصين بدرجة أساسية والاتحاد السوفييتي بدرجة أقل، لما كانت هانوي الفيتنامية، ويجب أن نقر بأنه لولا: إيران وسوريا وحزب الله وكل قوى محور المقاومة، لما كانت هانوي الفلسطينية بهذه القوة، ولنا أن نفخر، بل ونباهي بأنه في الوقت الذي تأكد سقوط النظام الرسمي العربي، بين العجز والتواطؤ والمشاركة، مع الحلف المعادي، هناك من يقف في معسكر مضاد، هو معسكر الأصدقاء الذي يقع على عاتقه؛ خلق قواعد للتحرر الذاتي المشترك للجنوب المتجه في عمقه شرقًا، وبالعكس، من ربقة الغرب الإمبريالي ومعسكره الاستعماري.
الأسئلة الكبرى: هل حان وقتها؟!
قد لا يرى بعض المتابعين لمجريات الحرب على غزة؛ بحكم حجم وهول العدوان، سوى التاريخ الذي يلي السابع من أكتوبر، من خلال عدم القدرة على ملاحقة عد أرقام الشهداء والبيوت المدمرة فوق ساكنيها، وعدم توفر اللغة المناسبة لوصف المعاناة المتفاقمة على مختلف مناحي الحياة، في قطاع غزة؛ فالشهداء ليسوا أرقامًا، كما البيوت ليست جدرانًا، كما أن قواميس اللغة ومصفوفات القوانين والشرائع الدولية؛ ستبقى عاجزة، بل قد تغدو متواطئة في لحظة ما، عندما لا يُحسن توظيفها؛ فهل يمكن أن يُعرَّف كل ما سبق دون الرجوع إلى السبب، الذي إذا ما استمر، سيستمر معه؛ الألم والوجع الجماعي؟
نعم، فلقد حان وقت طرح الأسئلة الكبرى، ارتباطًا بكِبر ما جرى يوم السابع من أكتوبر، وما حدده العدو أيضًا من أهداف كبيرة: (التهجير إلى سيناء، القضاء على حماس، القضاء على قدرات المقاومة… وصولا إلى حسم الصراع وتصفية القضية)، فما الذي يجعل الحلف المعادي/معسكر الأعداء يطرح هذه الأهداف الكبيرة، إلا إذا كانت الهزيمة التي لحقت بقاعدتهم أو محميتهم الآن، كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة؟! وهنا يحق لنا طرح سؤال كبير، يوازي كل ما سبق؛ هل نحن على موعد قريب مع النصر؟
دون بث تفاؤل تحت ضغط لحظة انفعالية أو انبهار بالصورة أو إرادوية مضرة، فإن، المؤكد أن النصر لا يتحقق إلا بالسعي له؛ إعدادًا وتخطيطًا وتجهيزًا ومثابرةً وفعلًا لا ينقطع، وهنا نجحت “كتائب القسام”، حيث فشلت حركة التحرر الوطني الفلسطيني مجتمعه، بحيث يمكن القول، دون أية مجازفة، بأن قدم آخر مقاوم فلسطيني، حطت في رمال البلاد التي دخل في عمقها عشرات الكيلو مترات، هي مناطق محررة، بانتظار استكمال البقية.