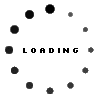أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة؟
عن كيفية تغطية الحرب على غزة في الإعلام الألماني
بقلم أية الأتاسي
٢٨/ ١١/ ٢٠٢٣
بداية عليَّ أن أعترف بأنني لست هناك ولست هنا، فأنا أوجد حالياً في منطقة محايدة بعيدة، لكن كيف يكون القلب محايداً! الحرب تجري هناك، الدم هناك، والموت هناك، لكننا نستطيع في الزمن الرقمي الحديث، أن نتابع مشاهد القتل والدمار على الهواء مباشرة، وكأننا في فيلم رعب لا ينتهي. في هذه الحرب الجهنمية يقتل الأبرياء، والكثير الكثير من الأطفال، الذين تنقل الشاشات قصصهم، فنتخيلهم أولادنا ونجهش بالبكاء. هي الأم التي نجت ولم تنج.
اسمه يوسف، شعره كيرلي، أبيضاني وحلو، كل الأولاد حلوين في عيون أمهاتهم، لكن هل هناك أقسى من أن تكون اليوم أماً في غزة، تجمع أشلاء صغيرها الحلو بين الأنقاض. ماتوا جوعانين، تقول الأم التي لم تنته بعد من طهي كبدها كي تطعم صغارها، لكنهم ماتوا قبل موعد الغداء، وكم هو ثقيل حمل تلك الأكفان الصغيرة. إنه زمن الجنون، كبر الأولاد، ولم يكبروا. يمسك الصغير بسرير أمه المستلقية كأنها نائمة بينما المسعفون يجرونها بعيداً، يد الصغير لا تترك حافة السرير، ولا خيط يلوح في ذيل الثوب، ولا حياة تلوح في وجه الأم. يحرس الصغير موت أمه وكأنه أبوها، يا الله، كبر الأولاد ولم يكبروا.
«هذا أخي الصغير بكنزته الزرقاء، جيبوه الله يخليكم» لكن الطفل بالكنزة الزرقاء يصرخ: بدي ماما. أخته ذات الخمس سنوات تمسك يده، الطفلة لا تنبس بكلمة، لكننا نعرف أنها صارت أماً. «ماما نائمة فوق» ينظر الصغيران إلى الأعلى، بينما جسد الأم مسجى وروحها تدق باب السماء. يقال إن إكرام الميت هو دفنه، لكن في زمن العار لا يستطيع الأحياء دفن أمواتهم، وغزة التي كانت يوماً سجناً كبيراً مفتوحاً، تحولت اليوم إلى مقبرة جماعية، ترتع فيها الكلاب الجائعة، ويطير الذباب فوق الجثث المتعفنة، إنها الحرب القذرة تنقل لنا مباشرة، ونحن على أرائكنا المريحة، يصلنا لهاث المراسل، الذي يلتقط أنفاسه، وقد تكون تلك هي أنفاسه الأخيرة، ففي غزة يسقط المصور والمراسل والمسعف قرب الضحية. وعلى طريق الخروج تجر الأمهات أبنائهن ورائهن في طريق النكبة الجديدة. إنها الحكايات التي سمعناها في ما مضى شفهياً، واليوم نشاهدها بكل أبعادها الوحشية. هي حكايات وحكايات، تعيدني إلى حكاية أبو أحمد، اللاجئ الفلسطيني في مخيم اليرموك، الذي لم يكن يكثر الحديث عن طريق خروجه حافياً من حيفا. لكنه كان يلمس قدمه مكان الألم، المكان الذي اخترقته شوكة على طريق النزوح، واخترقت قلبه نكبة. صحيح أنني لم أر بيت أم إبراهيم، لكنني أعرف مفتاحه المعلق بسلسة فضية أكلها الصدأ، في صدر المرأة الفلسطينية الكهلة. ماتت أم إبراهيم في دمشق ودفن معها مفتاح البيت، فالبيت والقرية والبلاد سرقت ولم يبق إلا الحكاية يتوارثها الأبناء والأحفاد إلى ما لا نهاية.
قالت غولدا مائير يوماً: سينسى الأولاد، لكن الحقيقة إن إسرائيل لا تتوقف عن تذكير الأولاد بما عاشه أهلهم من إبادة وتهجير، كذلك لا يتوقف المستوطنون في الضفة الغربية عن تذكير أصحاب الأرض بما قاله محمود درويش.
لو يذكر الزيتون غارسه، لصار الزيت دمعاً.
ولعله اليوم صار دماً، فالدم يسد مسام الهواء، والسخام يلتصق بالوجوه الناجية، كما تلتصق المجازر بالذاكرة. الذاكرة التي يخافها الغزاة، لأن المنتصر هو من يكتب روايته، ويرث أرض الكلام. لكن الكلام يبدو مصادراً اليوم لصالح الرواية الإسرائيلية، والعالم أعور لا يرى إلا بعين واحدة. في فيلم «موسيقانا» للمخرج الفرنسي غودار، يخاطب درويش صحافية إسرائيلية، قائلاً:
شهرتنا تنبع من أنكم أعداءنا.
ولعل شهرة الفلسطينيين، أو لعنتهم تنبع من أنهم ضحايا للضحية المطلقة، ولا بد من التضحية بهم للتخلص من عقدة الذنب النازية، والتعويض عن وخز الضمير العالمي، سليل الحرب العالمية الثانية. سأسعى في الأسطر المقبلة إلى الابتعاد عن اللغة العاطفية ومجاز الشعر، وسأستعين بلغة العقل لفهم آلية عمل الإعلام الغربي، والألماني على وجه الخصوص.
محرقتكم نكبتنا
قد يتفهم المرء للوهلة الأولى الحذر الألماني في ما يتعلق بالمسألة اليهودية، بسبب ثقل تاريخ النازية، لكن حقيقة يستعصي على الفهم، أن مجرد نقد السياسة الإسرائيلية، قد يتحول إلى تهمة «معاداة السامية» في ألمانيا. مؤخراً شبه لي صديق سوري يعيش في ألمانيا، الوضع في سوريا الأسد في ثمانينيات القرن الماضي. أهلاً بك في دولة الأمن الألمانية الجديدة، حيث يولد عنصر أمن داخلي يراقب أفكارك. وبهذا المعنى لا صوت يعلو فوق صوت الرواية الإسرائيلية في الإعلام الألماني، وحتى الأصوات العربية القليلة الحاضرة في الإعلام، يطلب منها تقديم صك براءتها عبر إدانة حماس بادئ ذي بدء، ثم تبني الخطاب الرسمي الألماني، وقد يصل الأمر بالبعض إلى المزاودة، فلكي تكون عربياً أبيض، عليك أن تخلع جلدك كي نقبل بك بيننا. والحال هكذا قد لا يفاجئك كلام حسنين كاظم، الصحافي الألماني من أصول باكستانية، عن وجوب ترحيل اللاجئين المشكوك في «معاداتهم للسامية». وربما سيبدو عبثياً في هذه الأجواء، القول بأن معاداة سياسة الاحتلال لا علاقة لها بالسامية، وأن مقاومة الاحتلال حق تضمنه الشرائع الدولية، أضف إلى ذلك أن معاداة السامية مفهوم غربي بامتياز وجذوره متأصلة في الغرب. في هذا السياق يحضر صوت الصحافية الألمانية من أصول مغربية، سميرة الوسيل، ويجب أن لا يخدعك الاسم، فلا شيء في مواقف هذه السيدة يشي بأي مشاعر تضامنية مع الغزاويين. تكتب الوسيل في صحيفة «شبيغل» بقلق عن هاجس معاداة السامية ولا شيء سواه، أي بمعنى كيف تكون ملكياً أكثر من الملكيين، وربما لن يكون غريباً هنا أن تدعي لمياء خضور عضو مجلس الشعب عن حزب الخضر، إن معاداة السامية أصبحت في كل مكان، حتى لدى المهاجرين الجدد، أو ما يسمى «معاداة السامية المستوردة» بل ستذهب أبعد من هذا، وتقدم شهادة براءتها إلى حد وضع أبنائها في حضانة يهودية، وهنا يقتضي التنويه بأن خضور من أصول سورية.
أما دنيا حيالي المذيعة من أصول عراقية، والمعروف عنها دعمها للاجئين في ألمانيا، فستأخذها أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الضفة الأخرى، وستتحول إلى محقق جنائي مع السفير الفلسطيني في النمسا، حيث اتهمته خلال المقابلة بالكذب، بعد أن طالبته مراراً وتكراراً بإدانة إرهاب حماس، وحين طالبها السفير بالمقابل بإدانة إرهاب دولة إسرائيل، أجابت بأنها تتعامل فقط مع الوقائع، ولأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، لم تستطع حيالي بعد فترة وجيزة من تلك المقابلة، إلا إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل، وفقاً للوقائع دون شك. وغني عن القول إن الكثير من الصحافيين من أصول عربية في ألمانيا، يتعرضون لضغوطات كثيرة في جو ثقافي أحادي الصوت، وفي ظل شبه غياب للأصوات الفلسطينية، التي لا يتم دعوتها وفي حال تمت دعوتها تحجب مداخلتها، ولا تبث على الهواء، كما حدث مع المترجم والكاتب الفلسطيني عارف حجاج.
ولعل الفضيحة الكبرى هي التي وقعت في معرض فرانكفورت للكتاب، عندما حجبت الجائزة عن الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، وشنت حملة شعواء على الفيلسوف جيجيك بسبب وقوفه مع معاناة الفلسطينيين. وهكذا، في آخر المطاف لم يبق للحديث عن المعاناة الفلسطينية في وسائل الإعلام الألمانية، سوى عدد قليل من خبراء الشرق الأوسط، ألماني الجنسية وإنساني الانتماء، كحال الصحافية كريستين هيلبرغ، التي ظلت تمسك بيدها بوصلة الإنسانية، وقد حذرت هيلبرغ من شرخ عميق بدأ يصيب المجتمع الألماني، ودعت إلى التعاطف مع الضحايا بغض النظر عن انتمائهم، حتى لا يتحول الشرخ إلى هاوية سحيقة. وللمفارقة فإن الصوت الأكثر دفاعاً عن مشروعية الحق الفلسطيني في ألمانيا، هي الكاتبة اليهودية من أصول أمريكية ديبورا فيلدمان، التي تحولت إلى صوت الفلسطينيين الغائب في الإعلام الألماني، وقد صرحت مؤخراً بأنها تتحدث باسم الغائبين، الذين يملكون الحق في الكلام أكثر منها، لكنهم مغيبين خلف قناع الإرهاب، ورغم إصرار فيلدمان على تقديم نفسها كإنسانة بالدرجة الأولى، إلا أن يهوديتها شفعت لها بالحديث في التلفزيون الألماني، رغم كل المضايقات التي تتعرض لها.
وحسب قولها فإن ألمانيا اليوم بلد مثالي لليهود، لكن ليس ليهودية تنتقد سياسة إسرائيل، وقد رفضت فيلدمان بوجود سياق تاريخي واحد لتبرير عنف إسرائيل، وطالبت بدلاً من منع استخدام كلمة «لكن» عند الحديث عن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» بأنه يتوجب ربما إضافة حرف العطف «الواو» للحديث عن الواقع الفلسطيني المأساوي، ولهذا قد لا يبدو غريبا أن يتصدر اسم فيلدمان عريضة وقع عليها يهود ألمان، ودافعوا فيها عن حق الاختلاف وطالبوا بمنح الفلسطينيين الحق في الاحتجاج، ولعله يصح أن نستعيد هنا تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية فوندلاين، بأن الاعتداء على المستشفيات وقطع الماء والكهرباء، هو عمل إرهابي، مع وجود تفصيل صغير بأن فوندلاين لم تكن تتحدث حينها عن فلسطين، بل عن أوكرانيا.
خارج المكان
يمكن القول إن معاداة السامية في أوروبا اليوم، تحولت إلى معاداة الإسلام، أي إسلاموفوبيا، وكأن المصطلحين وجهان لتمييز عنصري واحد، يمارسه الرجل الأوروبي الأبيض ضد الآخر المختلف. وكأن أكباش الفداء، التي كانت يهودية في ما مضى، أصبحت اليوم إسلامية في أوروبا. وواقع الحال أن نقاط التقاطع بين اليهودية والإسلام كثيرة، ابتداءً بالجذور السامية للغتين العربية والعبرية، مروراً بتحريم لحم الخنزير، وختان الذكور، بل يمكن القول إن اليهود والمسلمين استطاعوا عبر التاريخ التعايش بسلام، حتى إن محاكم التفتيش الإسبانية في القرن الخامس عشر، هجرت من الأندلس اليهود والعرب على حد سواء، ولم يكن اليهود العرب يعانون من العداء، حتى اعلان قيام دولة إسرائيل في 1948. وقد روى آفي شلايم هذا في مذكراته، وهو يهودي من أصل عراقي، وقد غادر العراق طفلاً مع عائلته، وذهب إلى إسرائيل في سنة 1950، ولم يكن شلايم حينها يتحدث العبرية بل العربية باللكنة العراقية، وفي إسرائيل سيمضي شبابه، لكنه سيغادرها في 1967، عندما ستتحول الأرض الموعودة بنظره، إلى دولة احتلال مدججة بالسلاح والعنصرية. ولاحقاً سيصبح شلايم أستاذاً في جامعة أكسفورد، وسيشرف على رسالة الدكتوراه للمؤرخ الإسرائيلي أيلان بابه، حول التطهير العرقي الذي ارتكبته إسرائيل في 1948. وغني عن القول إن بابه بعدها سيتعرض للهجوم بسبب كشفه زيف السردية الإسرائيلية، وسيضطر أيضاً إلى مغادرة إسرائيل في نهاية المطاف. وقد شبه شلايم حياته بحياة الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد، فهي حياة خارج المكان. حيث عرف كلاهما المنفى، وتغيرت خريطتهما الشخصية إثر هزيمة 1967، كما تغيرت خريطة فلسطين والعالم.
اليوم في 2023 يعيد الزمن نفسه، وها نحن نشهد على الترانسفير الفلسطيني بنسخته الجديدة، كما شهد أجدادنا النكبة، وكما شهد أهلنا النكسة، لكن بعيداً عن الخرافات الإسرائيلية فالفلسطينيون لم يرموا اليهود في البحر، ولم يركبوا البحر بقوارب مثلما غادروا بيروت يوماً، فالبحر في غزة اليوم هو جدار آخر. اليوم يشرب الفلسطينيون في غزة ماء البحر المالح، ويكبسون الملح على الجرح، ويتابعون… بعضهم يقاتل، والبعض الآخر يتبع ظل أجداده سيراً على الأقدام أو تحليقاً نحو السماء.
أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة؟
أين تنام النباتات بعد الهواء الأخير
هنا سنموت، هنا في الممر الأخير.
هنا أو هنا سوف يغرس زيتونه دمنا.