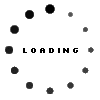قراءة أولية في التَحولّات “الإسرائيلية”
الحلقة الثانية
تلاشي ثنائية اليمين واليسار
 بقلم الأسير: كميل أبو حنيش*
بقلم الأسير: كميل أبو حنيش*
للاطلاع على الحلقة الاولى اضغط هنا
منذ سنوات “اليشوف” أي (الوجود اليهودي في فلسطين)، التي سبقت الإعلان عن الدولة الصهيونية، وحتى نهايات تسعينيات القرن الماضي على الأقل، تجاذبت ثنائية اليمين واليسار، الصراع السياسي الداخلي، لتشكيل الدولة والهيمنة على مؤسساتها، وتشكيل حكوماتها المتعاقبة قبل أن تنشأ ظروف تسمح بتلاشي اليسار الصهيوني، وانتصار ساحقٍ أحرزه اليمين بأحزابه وتياراته المختلفة، وإفلاحه بالسيطرة على سدة الحكم في العقدين الأخيرين.
وقبل الشروع في معالجة التَحوّلات التي أفضت إلى هذه النتيجة ينبغي التدقيق بمقولة “اليسار الإسرائيلي” وإزالة القشور اليسارية التي تغلق بها ذلك “اليسار الاستعماري العنصري” وتقويض المفهوم من أساسه ذلك لأن المشاريع الاستعمارية الاستيطانية بأنماطها المختلفة لا يمكن من حيث المبدأ، أن تقودها قوىً وحركات يسارية أو ماركسية، ولا يمكنها أن تنتج ظاهرة ثورية أو يسارية؛ لأن تلك المشاريع تظل محكومة لطبيعتها العدوانية والتوسعية والاستغلالية، وتقوم على أنقاض الشعوب بعد إبادتها أو تهجيرها أو استعبادها واستغلالها، وتسعى لنهب ثرواتها وتستعبد سكانها الأصليين، وهو ما يتنافى تمامًا مع الفكر اليساري أو الاشتراكي الذي يتخذ من الفكر الماركسي مرجعيته الأساسية، ومن ناحيةٍ ثانية، لأن المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري بالأساس، أشرفت عليه ولا تزال المنظومة الاستعمارية العالمية، ومن ناحيةٍ ثالثة، لأن ما يُسمى “اليسار الإسرائيلي” وهو في ذروة قوته وهيمنته الشاملة على الدولة والمجتمع كان متحالفًا مع القوى الإمبريالية العالمية، وكان أيضًا في ذات الوقت معاديًا للمنظومة الاشتراكية طوال حقبة الحرب الباردة، ومن ناحيةٍ رابعة، لم يكن هذا اليسار المزعوم يُعبّر في ممارساته وشعاراته عن أي انتماء لليسار بمضامينه الاجتماعية والسياسية والتقدمية والإنسانية.
لهذه الأسباب وغيرها، لا يمكننا قبول مقولة “اليسار الإسرائيلي” وريثًا للتجربة العمالية الصهيونية منذ سنوات “اليشوف”، فمع توالي الهجرات الصهيونية إلى فلسطين في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حمل الآلاف منهم أفكارًا اشتراكيةً وعمالية لا سيما من روسيا، وبعضهم كان ينتمي إلى أحزابٍ عماليةٍ واشتراكية، سعت إلى تشكيل أحزابها المتأثرة بالفكر الاشتراكي، ودمجت الأفكار الصهيونية بأيديولوجية اشتراكية باهتة وعرف منها حزبي (هبوعيل هتسيون) و (هبوعيل هتسيق) والتي تطور عنها لاحقًا حزب “احدوت هعافودا” لتتولى هذه التجربة الإشراف على الاستيطان اليهودي، وتُشكّل رأس الحربة في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، لتتطور إلى حزب “مباي” الذي سيتولى قيادة التجمع الاستيطاني والسيطرة فيما بعد على الحركة الصهيونية، وينشأ من رحمه “قوات الهاغانا”، ويتولى ويشرف على إقامة وتأسيس المؤسسات الصهيونية ولاحقًاً بناء الدولة وحكمها لسنواتٍ طويلة.
شَكّل حزب “المباي” وشريكه المنشق عنه حزب “المابام” واللذين نتج عنهما لاحقًا حزبي “العمل” و “ميرتس”، شكلا الأساس في بناء الدولة وقيادتها خلال العقود الأولى، واعتبرت هذه الأحزاب وفقاً للتصنيف السياسي “الإسرائيلي” الداخلي، أحزابًا تنتمي “لمعسكر اليسار” مع أن قيادتها للدولة الصهيونية وسياساتها العدوانية في الداخل والخارج، وارتباطها بالقوى الاستعمارية المناوئة للمعسكر الاشتراكي العالمي، ينفي عنها تمامًا صفة اليسارية.
مثلت إقامة “الهستدروت” في عشرينيات القرن الماضي، على أيدي قادة وزعماء الأحزاب العمالية الصهيونية أهم المؤسسات في السيطرة على الأرض عبر تنظيم كافة العمال اليهود، والإشراف على إقامة عشرات المؤسسات الإنتاجية الكبرى التي تَحولّت إلى أساساتٍ في بناء الدولة، وأثمرت سياساتها المعادية للعرب عن مزاحمة العمال العرب وطردهم من أماكن عملهم في الأرض والحراسة، من خلال الشعارات التي أطلقها: احتلال الأرض – احتلال العمل – احتلال الحراسة).
وقد شَكلّت تجربتي “الكيبوتس” وإلى حدٍ ما “الموشاف” اللذين اجتمعا على أسسٍ تعاونية، وعلى شكلٍ من أشكال الاشتراكية، ومثلًا قاعدة مهمة لهذه الأحزاب وتناميها في العقود الأولى من بناء الدولة، وربما كانت هذه المستعمرات وشكل الملكية والعمل فيها، قد أعطت الانطباع بأن الدولة والأحزاب العمالية التي تقودها ماضية في الطريق الاشتراكي غير أن هذه الصيغة من العمل التعاوني ليست دليلًا على ماركسية أو اشتراكية هذه الأحزاب أو الدولة، فالكيانات الاستعمارية الاستيطانية في مختلف التجارب الاستيطانية، تبنت وانتهجت مثل هذا الشكل التعاوني حتى قبل ظهور الماركسية والاشتراكية بقرون.
فهذه الكيانات مع بدايات تجربتها الاستيطانية، وتشكيل مجتمعها كانت عادة ما تبدأ كمستعمراتٍ زراعية تسعى إلى نهب أراضي السكان الأصليين، وإبادة أو طرد سكانها وتضطر لانتهاج الشكل التعاوني والحياة الجماعية، لاعتبارات وضرورات استيطانية وأمنية وعسكرية وتوسيعه بالأساس، وهو ما حدث في مختلف التجارب الاستيطانية كالقارة الأمريكية الشمالية واستراليا وجنوب أفريقيا ونيوزلندا وزيمبابوي، قبل أن تبدأ تلك التجارب في التَحوّل إلى الأسلوب الإنتاجي الرأسمالي، بعد أن تكون قد أتمت مهمتها في القضاء على السكان الأصليين أو طردهم، والسيطرة على أراضيهم وثرواتهم، وهو ما ينطبق أيضًا على المشروع الاستيطاني الصهيوني. كما أن اشتراكية الدولة وسيادة القطاع العام فيها، ليست دليلًا على انتمائها لليسار، وقد عُرف هذا الشكل من الاقتصاد في ألمانيا في عهد النازية، فلقد قام الاقتصاد الصهيوني في بدايات المشروع الصهيوني على أساس الملكية الجماعية لأن ضرورات بناء الدولة تقتضي مثل هذا الشكل من الاقتصاد، وهذا لا يعني تَحوّل المشروع إلى اشتراكي، فمنذ البدايات الأولى قام المستعمرون الصهاينة بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وطرد الفلاحين منها بالتمييز والعنصرية بين العمال اليهود ونظرائهم من العرب. وبعد الإعلان عن الدولة، اقتضت الضرورة أن يتولى القطاع العام القيام بمهمة بناء الدولة، ونتيجة لهذه السياسات التي اقتضتها غايات الاستيطان والأمن والحرب، أُطلق على المعسكر الذي كان يتولى تشكيل الائتلافات الحكومية بـ “اليسار الإسرائيلي” ولاحقًا صار كل من يؤيد التسوية والسلام مع العرب، يجري إلحاقه بهذا المعسكر.
إن هذه الدولة وفي ذروة حكم “اليسار” لها وهيمنته عليها، كانت متحالفة مع الإمبريالية ومعادية للشيوعية، وفي عهد هذا “اليسار” خاضت دولة الكيان معظم حروبها، وارُتكبت المذابح والتطهير العرقي، وكانت قوى “اليسار” صاحبة مشروع الاستيطان في أراضي الضفة وقطاع غزة والجولان بعد احتلال العام 1967.
وقد تراجع “اليسار الإسرائيلي” في العقود الثلاثة الأخيرة بصورةٍ ملحوظة، وهذا التراجع له أسبابه الخاصة، بتغيير المجتمع الصهيوني وانزياحه باتجاه اليمين، وبتَحوّلات الاقتصاد “الإسرائيلي”، وانتهاجه الطريق الليبرالي، علاوةً على موجات الهجرات المتلاحقة التي أخذت تندمج سريعًا مع توجهات الاقتصاد الجديدة، فضلًا عن جفاف قواعد حزبي العمل وميرتس، بعد تراجع أهمية “الكيبوتس والموشاف” في الاقتصاد والمجتمع والثقافة الصهيونية، لصالح المدن الكبرى واقتصاد السوق والحياة الفردية، والثقافة الاستهلاكية، وتراجع قطاع الزراعة ومساهمته في الدخل القومي الذي كان يُشكّل العمود الفقري لاقتصاد الكيبوتس والموشاف لصالح الصناعات التقنية والمتطورة.
وأخيرًا، لا يُعبّر “اليسار الإسرائيلي” عن أيديولوجيات متماسكة ولا يُمثل طبقات محددة، كما يحاول حزب العمل أن يزعم بأنه يمُثل طبقة العمال والفقراء، وكانت نتيجة الانتخابات الأخيرة كارثية بالنسبة لهذا الحزب، حيث حصل على ستة مقاعد، وهو ما ينذر بتلاشيه واندثاره في المستقبل.
أما حزب ميرتس الذي يعتبر نفسه ممثلًا لليسار الحقيقي في “إسرائيل”، فهو في الواقع يُعتبر ممثلًا لشرائح من الطبقة المتوسطة العلمانية، ويحمل أيديولوجيا هلامية تًشكّل مزيجًا من أفكارٍ علمانيةٍ وليبرالية، وهو حزب أقرب إلى أحزاب الوسط السائدة في بعض البلدان الأوروبية. ولعل أبرز ما يميزه عن بقية الأحزاب الصهيونية، دعوته المثابرة لإحراز السلام مع العرب والفلسطينيين، مع أن رؤيته للسلام والتسوية، لا تخرج عن سقف الإجماع الصهيوني في قضايا الحل النهائي. ولم يحظَ حزب ميرتس بأي مقعدٍ لأول مرة في تاريخه في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني نهاية ما يُعرف “باليسار الإسرائيلي”.
وفي المجمل، فإن هذه الحركات المصنفة على اليسار، لا تتبنى أيديولوجيا محددة، ولا رؤية فكرية متماسكة، باستثناء ما يُسجل في برامجها عن انحيازها للطبقات العمالية والفقيرة، إلى جانب شعاراتها الليبرالية، وبراغماتيتها السياسية إزاء الصراع مع العرب والفلسطينيين.
وفي المحصلة لم يكن ثمة يسار في “إسرائيل” لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، باستثناء بعض الشخصيات المعادية للصهيونية من حيث المبدأ، والمنحازة للحقوق الفلسطينية.
ويمكننا الادعاء أن الكيانات الاستيطانية، في مجملها يمينية التوجهات في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلاقة مع الخارج. أما أحزابها فيمكن اعتبارهم أحزاباً يمينية وحسب هذه المقاربة يمكننا اعتبار ما يُسمى “اليسار الإسرائيلي” بيسار اليمين، أو القوى والأحزاب ذات الديباجات الديمقراطية واليسارية. وقد وقع على عاتق هذا الاتجاه الصهيوني، مهمة بناء الأساس الاستعماري للدولة، وقيادة العملية التاريخية في بناء الدولة وخوض حروبها وصبغ مؤسساتها وثقافة مجتمعها بالصبغة الأوروبية العلمانية وديباجاتها الديمقراطية، ولعل الإرث الأبرز الذي تركته تلك التجربة يَتمّثل في شكل تقاسم السلطات الثلاث، وإضفاء نوع من التوازن بينها. وكان لسلطة القضاء تاريخيًا دورًا في شرعنة ممارسات الاحتلال، وتسهيل مهمة نهب الأرض وتضييق الخناق على الفلسطينيين، وبتجميل صورة الدولة وعلاقتها مع الخارج، بوصفها دولة قانون حسب المعايير الغربية، بالإضافة إلى أن مؤسسة القضاء حافظت على التوازن في الصراعات السياسية الداخلية، وعلى الحقوق الفردية والحريات السياسية والمدنية، وباتت محكمة العدل العليا، درة التاج في تباهي الدولة الصهيونية بسلطتها القضائية، والملاذ الأخير في الاحتكام، وحل الاشكاليات المتفاقمة بين مركبات وأفراد المجتمع الصهيوني.
وفي خضم الصراع السياسي التاريخي المحتدم، بين معسكري اليمين واليسار، مَثلّت سلطة القضاء، إحدى العناوين الهامة في هذا الصراع، واعتبرتها قوى اليمين، إحدى معاقل قوى اليسار التي يتسلح بها في استمرار الامساك بزمام السلطة، ولاحقًا في عرقلة السياسات اليمينية المنفلتة من عقالها، التي تَحدّ من رغبته في الهيمنة الشاملة على الدولة ومؤسساتها، ومن زاويةٍ ثانية شَكّل الصراع على هوية الدولة أحد العناوين الأخرى، بل هو العنوان الأهم في الصراع التاريخي بين المعسكرين، الذي أسفر في نهاية المطاف عن انتصار قوى اليمين بأحزابها المختلفة في الانتخابات الأخيرة، ونجاحها بتشكيل حكومة يمينية بالكامل فرصتها السانحة للإمساك بزمام السلطة من خلال تغيير بنية الدولة، بما فيها مؤسسة القضاء، والقضاء على إرث ما يُسمى “اليسار”.
وتعتقد قوى اليمين أن ما تبقى من جيوب اليسار، المتغلغلة في مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة القضاء، تُمثّل عائقاً أمامها، وتحدياً للسلطة وسياساتها، وإن هذه الجيوب أشبه بالدولة العميقة التي تمنع قوى اليمين من تمرير سياساتها وترجمة توجهاتها، ومن زاويةٍ ثانية ترى هذه القوى بالمعسكر المناوئ لمعسكر “نتنياهو”، بأنه معسكر يساري؛ حتى وإن هيمنت عليه قوى المركز، وانضوى فيه بعض القوى اليمينية كحزب “يسرائيل بيتنو” الذي يقوده “افيغدور ليبرمان”، وبعض القوى العربية، وهامشية قوى “اليسار”.
ومن اللافت للانتباه أن اليسارية تَحوّلت إلى شتيمةٍ وإلى تهمةٍ في العقدين الأخيرين، وكان “نتنياهو” هو من دشن هذا العهد، بعد أن دأب على اتهام الصحافة والقضاء وخصومه السياسيين وكل من ينتقد سياساته باليسارية، وطالت هذه التهمة أو “الشتيمة السياسية” عشرات الصحافيين والأكاديميين والقضاة والمثقفين والقادة والسياسيين. ففي انتخابات العام 2009 اتهم “نتنياهو” “حزب كاديما” ورئيسته “تشيفي ليفني” باليسارية، وكذلك في انتخابات عامي 2013 و2015 اتهم خصومه ومناوشيه باليسارية.
ومنذ العام 2019 ودخول الدولة العبرية في أزمتها الحالية امتدت تلك الشتيمة والتهمة لتشمل بعض القوى والشخصيات اليمينية. فقد اتهم “نتنياهو” حزب “أزرق أبيض” وزعماؤه بما فيهم “يائير لبيد وموشي يعلون وبني غانتس” باليسارية، وانتقلت تلك التهمة في سلسلة الانتخابات المتتابعة منذ العام 2019 وحتى اليوم، إلى معسكر اليمين ذاته، حيث اتهم قادة معسكر اليمين بعضهم بعضًا باليسارية. فقد اتهم “نتنياهو ليبرمان” باليسارية، واتُهم نتنياهو ذاته باليسارية من قبل أحد مناوئيه داخل المعسكر. ومؤخرًا اتهم “باروخ مارزيل” أحد قادة “عوتسما يهوديت” قائد الحركة “ايتمار بن غفير” باليسارية، لأنه حاول أن يبدي نوعًا من الاعتدال أمام وسائل الإعلام.
وباختصار، يرى معسكر اليمين الذي يقوده “نتنياهو” حتى في ضوء تلاشي قوى اليسار بأن المعسكر المناوئ لهم يحمل توجهًا يساريًا، طالما يُصّر على إقصاء “نتنياهو” عن الحكم. لذا يجد “نتنياهو” بعد عودته للحكم، الفرصة مواتية أمامه لإحداث انقلاب جذري في الدولة من خلال إلغاء بعض القوانين، وسن قوانين أخرى مكانها، تسمح له بالإفلات من المحاكمة، وتقُلص من صلاحيات سلطة القضاء التي تعرقل سياساته وتوجهاته اليمينية، وتضييق الخناق على الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والمدنية والسياسية المناوئة لليمين، وتطهير مؤسسات الدولة من “اليساريين” الذي يحتلون مواقع بارزة في القضاء والإعلام والثقافة والتعليم وحتى في المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وقد وجدت الأحزاب الدينية الثلاث الشريكة لحزب الليكود في الائتلاف الحكومي، الفرصة في ابتزاز “نتنياهو”، وقدمت بدورها بعض القوانين التي من شأنها إحداث تغييرات جذرية، قد تصل إلى تغيير هوية الدولة، وتوسيع يهوديتها على حساب ديمقراطيتها، وتقليص الحريات العامة، وتضييق الخناق على العرب، وإقرار بعض السياسات ذات الصبغة الدينية. وقد أدى الإعلان عن خطة الإصلاح القضائية إلى انفجار الأزمة الحالية، ويعكس حجم التظاهرات والاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة تخوفات المجتمع الصهيوني، من تَحولّ “اسرائيل” إلى دولةٍ ديكتاتورية أو دينية، مما يهدد طابعها العلماني – الديمقراطي، وهو ما سيقود إلى حربٍ أهلية كما يرى العديد من القادة والتيارات، ستظهر “إسرائيل” بوجهها الحقيقي – الوجه الاستعماري العنصري الفاشي من دون ديباجات وخطابات مراوغة عن الديمقراطية والعلمانية والحريات والسلام.
ومن المفارقات أننا ومنذ الأزمة الحالية المتفاقمة منذ ثلاثة أشهر لم نعد نسمع بشتيمة “اليسارية” أو “اليساريين” وحل مكانها مصطلح الفوضوية أو الفوضويين، حيث أصبحت هذه التسمية الجديدة مصطلحًا دارجًا في وصف المتظاهرين، ووصل الأمر بابن رئيس الحكومة “يائير نتنياهو” بوصفهم بالإرهابيين، وبعضهم وصفهم بالمخربين. ولا نستبعد في ظل الثقافة اليمينية الشعبوية المتفشية، أن تَتحوّل “اليسارية” في الدولة الصهيونية، إلى تهمةٍ، يجري سن قوانين خاصة لتجريمها ومحاكمة من ينتمون إليها.
وفي المجمل، كشفت الأزمة المتفاقمة منذ العام 2019 عن هامشية قوى “اليسار الصهيوني” وتلاشيه التدريجي، وصولًا إلى اندثاره النهائي، كما تنبأت استطلاعات الرأي الأخيرة، وبهذا تلاشت ثنائية اليمين – اليسار لصالح ثنائية أخرى (اليمين – المركز)، وبهذا تدخل الدولة العبرية مرحلةٍ جديدة، في الصراع السياسي الداخلي، وهذه المرة بين القوى اليمينية، التي تسعى إلى تقويض الأسس التي قامت عليها الدولة، وبين القوى التي تقاتل من أجل الحفاظ على ما تبقى من مساحيق تُجمّل وجه الدولة أمام العالم.
* عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كاتب وأديب وشاعر، ومفكر فلسطيني