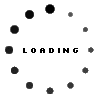Палестинці не досягли успіху ні в збройному опорі... ні в переговорах
أكثر ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم إدراك واقعهم وقدراتهم

Маджид Каялі - كاتب فلسطيني*
26/5/2023
لم يترك الفلسطينيون طريقة لمصارعة إسرائيل إلا وجرّبوها، منذ إقامتها قبل 75 عاما، في سعيهم العنيد لانتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة، من العمليات الفدائية، إلى الانتفاضات الشعبية، وصولاً إلى الحروب الصاروخية، مرورا بالعمليات التفجيرية، وخطف الطائرات، إلى جانب السير في طرق الدبلوماسية والمفاوضات والاتفاقيات وتقديم التنازلات.
لكنهم في كل ذلك، ومع التقدير لتضحياتهم وبطولاتهم، لم ينجحوا، بل وظلّوا خاسرين.
وفي المقابل فإن إسرائيل ظلّت قادرة على امتصاص، أو استيعاب، كل أشكال الكفاح الفلسطينية، السلمية والعسكرية، الشعبية والفدائية، وتفويتها، بحيث إنها كانت تسبق الفلسطينيين، ولا تمكّنهم من استثمار أي خيار، في حين تقوم بتدفيعهم الأثمان الباهظة.
إذن، الحديث هنا لا يفيد بالانحياز إلى خيار كفاحي دون غيره، وإنما يفيد بمناقشة واقع عجز حركة التحرر الفلسطينية المعاصرة، وعمرها 58 عاما، عن تحقيق إنجازات توازي- ولو بشكل نسبي- التضحيات التي بذلت، فهي عوضاً عن ذلك ظلّت تأكل، أو تبدّد، الإنجازات التي حقّقتها في أواسط السبعينات، في السنين العشر الأولى لانطلاقها، بمعنى أنها كفّت عن إضافة أي انجاز حقيقي، منذ الـ 48 عاماً الماضية. ومثلا: أين وحدة الشعب الفلسطيني اليوم؟ وأين منظمة التحرير الفلسطينية؟ وأين الهدف الوطني الجامع للفلسطينيين؟
والمعنى أن الفلسطينيين غير قادرين، في الظروف الدولية والإقليمية السائدة، على تثمير تضحياتهم وبطولاتهم، لا بالوسائل العسكرية، ولا الشعبية، لا بالانتفاضات، ولا بالمفاوضات، لكن ذلك لا يعني أنه ليس لديهم ما يفعلونه. على العكس، فتلك الحال تتطلب منهم أشياء كثيرة، لكن على أساس إدراكات سياسية وكفاحية جديدة، ومغايرة، تتأسّس على:
أولا، نبذ الأوهام والمراهنات، في هذه الظروف، سواء على أطراف خارجية، أو على خيار كفاحي أو سياسي معيّن، مهما كان، وعدم المبالغة في قدراتهم، وإدراك حال الضعف العضوي في أوضاعهم كشعب مجزّأ، ويخضع لسيادات عدة دول، ويفتقد للموارد، ويعيش في الداخل في نطاق الهيمنة الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال، ما معنى التناقض بين فلسطينيين يقاتلون إسرائيل، وفلسطينيين يعملون فيها؟! وبين غزة التي تقصف إسرائيل وتقصف من قبلها، وغزة التي تحتاج للمعابر مع إسرائيل لتأمين حاجاتها الأساسية منها؟ ثم ما معنى التهدئة، أو الهدنة إذن؟ وكيف يمكن الحديث عن “شعب الجبارين”، وعن “زلزلة الأرض تحت اقدام إسرائيل”، في حين لا يمكن اقتلاع مستوطنة، أو تجاوز معبر قلنديا (بين رام الله والقدس، أو الاستغناء عن معبري إيريتز وكرم أبو سالم (مع غزة)؟ والفكرة هنا أن الشعب الضعيف، يحاول تعويض ضعفه بالتوهمات، والشعارات، وهو الذي تشتغل عليه الفصائل، كجزء من عدّة شغلها.
إسرائيل ظلّت قادرة على امتصاص، أو استيعاب، كل أشكال الكفاح الفلسطينية، السلمية والعسكرية، الشعبية والفدائية، وتفويتها، بحيث إنها كانت تسبق الفلسطينيين، ولا تمكّنهم من استثمار أي خيار، في حين تقوم بتدفيعهم الأثمان الباهظة
ثانيا، منذ البداية انطلقت فكرة الكفاح المسلح، في منتصف الستينات، من فرضية خاطئة قوامها أهلية الأنظمة العربية، سيما “دول الطوق”، لخوض معركة تحرير فلسطين، أو مصارعة إسرائيل، لكن تبين، مبكرا، عقم تلك المراهنة، الوهم، إذ الأنظمة لا تلق بالاً لذلك، ثم هي ضعيفة، فضلا عن أنها مختلفة فيما بينها، بما يستنتج منه أن الحركة الوطنية الفلسطينية تفتقد إلى الحاضنة اللازمة لتمكينها من تثمير كفاحها، بهذه الدرجة أو تلك.
ثالثا، تتمتّع إسرائيل، إزاء الفلسطينيين، بقوة مضافة، فهي أقوى (حتى إزاء “دول الطوق”)، سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا، وليس فقط عسكريا، وتتمتع بحماية ودعم الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، ثم هي تمتلك السلاح النووي. ومثلا فإن النظام الدولي الذي منع نظام صدام من أخذ الكويت، ويمنع روسيا من أخذ أوكرانيا، لن يسمح بتهديد إسرائيل، بل إنه ربما يسمح لها القيام بخطوات خطيرة قد تؤذي الفلسطينيين، بدعوى الدفاع عن النفس.
رابعا، على الصعيد الدولي باتت إسرائيل تحظى بعلاقات وثيقة ومتميزة مع الدول الكبرى في العالم، التي كانت صديقة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند، وهذا يشمل دولا أخرى في مختلف القارات، بسبب تميزها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
هكذا فإن مشكلة الحركة الوطنية الفلسطينية أنها لا تدرك إمكانياتها، ولا العالم المحيط بها، وتبالغ في قدراتها، وأنها تخوض كفاحها بالوسائل العسكرية أو بالمفاوضات، منذ ستة عقود تقريبا، من دون أي استراتيجية عسكرية واضحة، وممكنة، ومستدامة، ويمكن استثمارها.
على ذلك، وبصراحة مؤلمة، لا معنى للجدال، أو للخلاف، بين الفلسطينيين حول أشكال النضال الأجدى، والأنسب، لأنهم يفتقدون الأساسيات، أي الاستراتيجية، والحاضنة العربية، والظرف الدولي المواتي، فكل ما هو موجود، مع التقدير للجهود وللمعاناة والتضحيات والبطولات، أن كفاحهم المسلح، ومفاوضاتهم، تأسست على التجريب، والرغبات، والمراهنات الخطأ، باستنادهم فقط إلى حقوقهم، وعنادهم، واستعدادهم للتضحية، من دون حساب الإنجازات، والكلفة والمردود النسبيين، في السياسة وفي العسكرة، ومن دون الإجابة على سؤال: أين كنا وأين صرنا؟ وما الذي تحقق بعد هذه التجربة أو تلك؟ وما الذي حصل في الأردن ولبنان وغزة والضفة؟ ومن المسؤول؟ إذ لا نقاشات، ولا مراكز دراسات؟ ولا مراكز صنع قرار، إذ تشتغل الفصائل كقبيلة منغلقة على نفسها، فارضة سطوتها حيث تستطيع، مع منع النقد، الذي يكشف ضيق أفقها، وتهربها من المساءلة والمحاسبة، إضافة إلى أنها، بأجهزتها الأمنية والميليشياوية، قوضت حيوية المجتمع المدني وأضعفته إزاءها وإزاء إسرائيل.
النظام الدولي الذي منع نظام صدام من أخذ الكويت، ويمنع روسيا من أخذ أوكرانيا، لن يسمح بتهديد إسرائيل، بل إنه ربما يسمح لها القيام بخطوات خطيرة قد تؤذي الفلسطينيين، بدعوى الدفاع عن النفس
أيضا، لا معنى للجدال حول أشكال النضال، الأجدى، والأفضل، والممكنة، أولاً، لأن الفلسطينيين باتوا يفتقدون للإجماعات الوطنية، التي يتأسس عليها مشروعهم الوطني، سيما بعد تحولهم إلى سلطة، وبعد تجزئة شعب وأرض فلسطين، وتفكيك قضيته، في حين يفترض في أي مشروع وطني جامع الانطلاق من التطابق بين الشعب والأرض والقضية. وثانياً، لأن الفلسطينيين باتوا يفتقدون لكيان سياسي جامع، كالذي كانته منظمة التحرير الفلسطينية في أواسط السبعينات، ككيان سياسي يحاول التعويض عن افتقاد الفلسطينيين لإقليم موحد.
والفكرة أن الأولوية في هذه الظروف للاقتصاد من خلال طاقات الشعب الفلسطيني، وعدم التفريط فيها، أو تبديدها، في أشكال كفاحية لا يمكن استثمارها بانتظار توفر معطيات أفضل تفيد بتمكينه من تحقيق نوع من التوازي، ولو كان نسبيا، بين تضحياته وبطولاته ومعاناته، والإنجازات السياسية. فإذا كان صحيحا أن المفاوضات والمظاهرات والبيانات لا تحرّر شبرا من فلسطين، في هذه الظروف، فهذا ينطبق على الكفاح المسلح والحروب الصاروخية والعمليات التفجيرية أيضا، لذا فإن الأجدى للفلسطينيين، وفي استطاعتهم، التركيز على بناء بيتهم الوطني، وفق رؤية وطنية جامعة، تنطلق من وحدانية الشعب والأرض والقضية، وبناء كيانهم الوطني الجامع، على أسس تمثيلية وكفاحية ومؤسسية، وانتهاج نمط الانتفاضة الشعبية، وفقا لإمكانيات الشعب، وقدرته على التحمل، على نمط الانتفاضة الأولى، التي أثبتت فاعليتها، وأي طريق أو ادعاء آخر لن يوصل إلى نتيجة، اليوم، بحسب التجارب المرة والباهظة، وليس بحسب التحليل فقط.
الأولوية في هذه الظروف للاقتصاد من خلال طاقات الشعب الفلسطيني، وعدم التفريط فيها، أو تبديدها، في أشكال كفاحية لا يمكن استثمارها بانتظار توفر معطيات أفضل تفيد بتمكينه
ما يفترض إدراكه، أيضا، أن إسرائيل التي نشأت في ظروف دولية وعربية مواتية لها، لا يمكن أن تنتهي، أو أن تتحول، إلا في ظروف دولية وعربية غير مواتية لها، ومواتية للفلسطينيين، أما “الحرب بين الحروب”، فهي لعبة إسرائيل، لجرّ الفلسطينيين إلى المربع الذي تتفوق فيه، وإلى المربع الذي يعرضها كضحية، والمربع الذي يضمن وحدة المجتمع الإسرائيلي ويشدّ عصبه ضد ما يسمونه الخطر الخارجي، لأن إسرائيل من دون ذلك ستكون مجرد دولة عادية تعيش وتكابد تناقضاتها، والضغوط الخارجية عليها.
باختصار، فإن أكثر ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم إدراك واقعهم وقدراتهم، وصوغ استراتيجية مقاومة شعبية، واضحة وممكنة ومستدامة ويمكن استثمارها، وتستنزف عدوها ولا تسهّل له استنزاف شعبها. مقاومة من دون ادعاءات، كـ”قواعد الاشتباك”، و”توازن الردع”، و”وحدة الساحات”، و”زلزلة الأرض”، لم تثبت عمليا، كما شهدنا في مسيرة الأعلام في القدس (18 مايو/أيار)، وما قبلها من تجارب وشروط على التهدئة والهدن، ظلت حبرا على ورق.