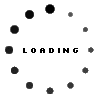تأثير الانشقاقات الداخلية على قوة ومناعة الحركة الوطنية الفلسطينية
ومسارات الوحدة الاستراتيجية المفقودة

وديع أبو هاني – إعلامي فلسطيني
15\7\2025
القلاع تسقط من الداخل
في خضم مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني، واستلهاماً من تجارب الثورات العالمية، تبرز أهمية توحيد الصفوف ورصّها في الميدان، والبحث عن قواسم مشتركة سياسية ووطنية تُشكل أساساً صلباً للمواجهة. هذه الضرورة تزداد إلحاحاً ونحن نخوض حرباً وجودية مع المشروع الصهيوني الإحلالي العنصري الذي يمتد لأكثر من 77 عاماً، جراء النكبة الكبرى عام 1948 التي حلت بشعبنا، وتشريده إلى دول الطوق وعمق الشتات على يد العصابات الصهيونية المتطرفة. إن الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة وتدخلات الأنظمة العربية المؤثرة، إضافة إلى عوامل داخلية متراكمة، لعبت تاريخياً دوراً حاسماً في تأجيج ودعم عدد من الخلافات الداخلية الفلسطينية، بل وحتى في خلق بعضها من العدم. للأسف، وبدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية في إطار جبهة فلسطينية عريضة، وتقوية المناعة الداخلية في وجه التحديات الوجودية، شهدت الساحة الفلسطينية تاريخياً مجموعة من الانشقاقات الداخلية وأشكالاً من التشظي والتكتلات التي شملت العديد من القوى الفلسطينية الكبرى. وقد أدت هذه الانقسامات إلى أن يصبح جزء كبير من هذه القوى “طاردًا” أو “خارج الخدمة”، بمعنى تراجع تأثيرها وفعاليتها بشكل كبير على مسار الصراع.
نتناول هذا الموضوع الشائك بموضوعية تامة؛ لأن كل تفصيل فيه ربما يحتاج إلى دراسة مستقلة ومعمقة، خاصة إذا تناولنا كل فصيل فلسطيني على حدة. إن تناول هذه الظاهرة لا يعني بحال من الأحوال التقليل أو الانتقاص من تاريخ وتضحيات الفصائل الوطنية الفلسطينية التي قدمت وما زالت تقدم تضحيات جسام. حيث إن التجارب التاريخية للشعوب التي ناضلت لاستقلالها أثبتت أن القانون الثابت لها هو “أينما يوجد احتلال وظلم يوجد مقاومة”، وأي مقاومة لا بد أن تنظم طاقات شعبها من خلال أطر وصيغ وطنية ونقابية واجتماعية ومدنية لمواجهة العدو المشترك. ولا يخلو بيت فلسطيني إلا وقدم شهيداً أو أسيراً أو جريحاً أو معاقاً على مذبح الحرية والاستقلال والعودة، في كفاح ما زال مستمراً لأكثر من 77 عاماً.
بالتالي، عندما نتناول ظاهرة الانشقاقات كظاهرة سلبية، لا يجوز بحال من الأحوال تغييب النقد الموجه للقوى والفصائل الفلسطينية. بل يجب أن يجري تفحص نواقص وعيوب الحالة الوطنية بعمق، بهدف تمتين وتقوية الجبهة الداخلية على طريق استمرار المواجهة مع المشروع الصهيوني وهزيمته الشاملة، وإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
بغض النظر عن المبررات والظروف الموضوعية التي أدت إلى نشوء وتعدد القوى الوطنية المكافحة ضد الاحتلال والدفاع عن الأرض والإنسان، يبقى السؤال الجوهري معلقاً: هل هذا العدد الكبير من الفصائل كان ضرورة موضوعية تستجيب لمتطلبات النضال الفلسطيني وتمثيلاً أميناً لقوى وشرائح مجتمعنا المتنوعة؟ والآن، هل ما زالت الحالة الفلسطينية تتفهم وتتحمل وتقبل حالة التشظي القائمة دون مبررات موضوعية وذاتية قاهرة؟ أم أن ولادة ونشأة بعض الفصائل لم تكن طبيعية، وربما كانت قسرية، وتحت تأثير عوامل خارجية رافقت تشكلها منذ البداية؟
إن الحقيقة والظروف الموضوعية والذاتية الراهنة للفصائل تستدعي إعادة تفكير وتحليل عميقين لمجمل المشهد، بما يمكّن شعبنا مجدداً من توحيد الجهود ورص الصفوف على طريق استمرار كفاحه الوطني حتى الظفر بالحرية الكاملة والاستقلال والعودة الشاملة.
جذور الانقسام في الحركة الوطنية الفلسطينية: عوامل مؤثرة وتداعيات تاريخية
لم تحظَ ظاهرة الانشقاقات في الساحة الفلسطينية بالقدر الكافي من التحليل والتقييم الموضوعي واستخلاص الدروس والعبر اللازمة، باستثناء ربما الوقفات والمؤتمرات الفصائلية التي عقدها كل فصيل على حدة، وما صدر عنها من وثائق وبيانات خاصة بهذا الفصيل أو ذاك، والتي غالباً ما تتسم بالدفاعية والتبريرية عوضاً عن النقد الذاتي الحقيقي. إن الاختلافات السياسية ظاهرة طبيعية وصحية بل وضرورية بين القوى والتيارات السياسية في أي مجتمع تعددي ديمقراطي، شريطة توفر بيئة داخلية ديمقراطية تضمن وتسمح بالحوار البناء، والنقد الموضوعي الجريء، والمحاسبة الشفافة، كي تؤسس هذه الاختلافات للتماسك والتطور والتقدم بدلاً من التفتت والتلاشي. بذلك، يمكن أن نكون أمام قوى مؤثرة تستطيع أن تضيف شيئاً نوعياً وإيجابياً للحركة الوطنية الفلسطينية في مراحلها المختلفة. تتعدد الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الانشقاقات في الساحة الفلسطينية، وهي تتداخل وتتشابك لتشكل نسيجاً معقداً من العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت بعمق على تماسك الحركة الوطنية ومسارها.
يُعد الخروج عن البرنامج الوطني الفلسطيني المشترك، الذي يمثل القاسم المشترك الأكبر، وتغييب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، سبباً جوهرياً ورئيسياً في إضعاف وتراجع العديد من الفصائل الفلسطينية، وحدوث انشقاقات داخلية وخارجية مدمرة. فمنذ عقود، ظهرت رؤيتان متناقضتان داخل الحركة الوطنية: الأولى تتمسك بالمقاومة الشاملة لتحرير فلسطين بالكامل من النهر إلى البحر، والثانية تميل إلى التسوية السياسية مع الاحتلال عبر المفاوضات. بدأت بعض القوى الكبرى، وعلى رأسها القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الانخراط الجاد في مسار التسوية السياسية الذي توج باتفاقات أوسلو عام 1993، وهو ما اعتُبر خروجاً صارخاً عن الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج الوطني المتوافق عليه تاريخياً، والذي كان يرفض الاعتراف بالاحتلال والتنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف. هذه الاختلافات العميقة حول طبيعة الهدف (التحرير الكامل مقابل إقامة دولة على حدود 1967) وأدوات تحقيقه (المقاومة المسلحة الشاملة مقابل المفاوضات) أدت إلى انشقاقات مباشرة وغير مباشرة، وعمّقت الشرخ السياسي والأيديولوجي بين القوى. كما أدت إلى تغييب شبه كامل لدور مؤسسات المنظمة الديمقراطية كالمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، التي كان يفترض أن تكون المرجع الشرعي للقرار الوطني المستقل، مع طغيان فردية القيادة الذي أدى إلى التفرد بالقرارات الوطنية المصيرية. هذا الانفصال في الرؤى لا يزال مؤثراً حتى اليوم، خاصة في ضوء استمرار عدوان الاحتلال اليومي وحرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، وما يرافقها من تداعيات كارثية، مما يؤكد أن مسار التسوية لم يؤدِ إلى تحقيق إنجازات وطنية ملموسة، بل زاد من تعقيد المشهد وكرس الانقسام بشكل أعمق.
كذلك لم تكن الفصائل الفلسطينية بمعزل عن التحولات الفكرية والأيديولوجية والسياسية التي عصفت بالعالم والمنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالماركسية، القومية العربية، والإسلام السياسي. ففي أوساط التيارين الشيوعي والقومي، أدت خلافات عميقة حول فهم وتطبيق هذه الأيديولوجيات إلى انشقاقات عديدة. على سبيل المثال، تسببت التباينات حول “المراهقة اليسارية” و”التطرف الثوري” أو “التفسيرات المختلفة للماركسية” داخل التنظيمات الشيوعية والقومية في انقسامات حادة أثرت على تماسكها. تفاقمت هذه الخلافات بسبب غياب الحوار الهادئ والموضوعي، وعدم وجود بيئة ديمقراطية داخلية كافية لإدارة الاختلافات بشكل صحي. فعندما تغيب آليات التداول السلمي للسلطة، أو النقاش الحر والمفتوح، أو مبدأ المحاسبة والمساءلة، يصبح الانشقاق للأسف المخرج الوحيد للتعبير عن الرأي المخالف أو الطموحات القيادية. كما لعبت سيطرة الفرد ونزعة الأنا والنرجسية القيادية لدى بعض القيادات دوراً سلبياً كبيراً، حيث طغت المصالح الشخصية والطموحات الفردية على المصلحة العامة للحركة الوطنية، مما زاد من حدة الانقسامات وأضعف فعالية وقوة ومناعة الجميع. هذا بالإضافة إلى الترهل التنظيمي الداخلي الذي أصاب العديد من الفصائل بفعل طول الزمن والجمود، مما أثر سلباً على الحياة التنظيمية وعلى الوعي التنظيمي والجماهيري.
بالإضافة الى أن الساحة الفلسطينية لطالما كانت مسرحاً للعديد من التدخلات الخارجية من أنظمة عربية وإقليمية ودولية. هذه التدخلات هدفت للتأثير على القرار الفلسطيني وتوجيه مسار الحركة الوطنية بما يخدم مصالح تلك الأطراف، بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وقد اتخذت هذه التدخلات أشكالاً متعددة، مثل الدعم المالي المشروط الذي يصبح أداة للتحكم، وتوفير الملاذ الآمن للمجموعات المنشقة، أو تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لها لتقوية انقساماتها. هذه التدخلات أججت نار الخلافات الداخلية القائمة، وحولت التباينات الفكرية والسياسية إلى صراعات مفتوحة، بل وحروب واقتتال داخلي في بعض الأحيان، كما حدث في “أيلول الأسود” عام 1970 أو في لبنان خلال الحرب الأهلية الدامية. أثرت هذه التدخلات مباشرة على القرار الداخلي للعديد من الفصائل، وقوضت مبدأ القرار الوطني المستقل الذي لطالما نادت به الحركة الوطنية، مما جعل بعض الفصائل رهينة لأجندات خارجية تتعارض أحياناً بشكل صريح مع المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا.
يُلاحظ ذلك بوضوح منذ نشأة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، حيث ترك النظام الرسمي العربي بصماته الواضحة على نشأة ومواقف وسياسات العديد من القوى والفصائل، خاصة في الحقبة الناصرية وتأثير شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على التيار القومي. كذلك، في مرحلة قيادة المرحوم أحمد الشقيري والراحل ياسر عرفات للمنظمة، كانت التدخلات الخارجية ضاغطة بقوة باتجاه تشكيل وتركيب القيادة الفلسطينية أو حتى رسم البرنامج السياسي والسياسات التي اعتمدتها منظمة التحرير الفلسطينية. هذا التأثير بدأ من مرحلة الميثاق القومي الفلسطيني (1964) ثم الميثاق الوطني الفلسطيني (1968)، مروراً بالتوجهات القومية، وصولاً إلى مرحلة انخراط قيادة المنظمة في مسار التسوية السياسية بعد حرب تشرين (أكتوبر) عام 1973 وبرنامج النقاط العشر عام 1974، وبعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، وصولاً لمؤتمر مدريد عام 1991، ثم توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993.
كما لعب المال العربي (خاصة البترودولار السعودي) الذي أغدق بسخاء على بعض الفصائل الكبرى، دوراً حاسماً في تشكيل وتوجيه سياسة هذه الفصائل في منعطفات حادة، وما زال تأثيره ممتداً حتى يومنا هذا. من منا يغفل تأثير الحقبة المصرية (الناصرية وما بعدها)، والبعثية في سوريا والعراق، ولاحقاً الليبية، على الجسم الوطني الفلسطيني، وعلى استقلالية القرار الوطني، وغيرها من الأنظمة العربية من خلال ضغوطها وتدخلاتها بأشكال مختلفة ومتعددة؟ وهنا نتذكر الدور المأساوي للنظام الأردني في مجازر أيلول الأسود عام 1970، الذي أثر بشكل عميق على العلاقة الفلسطينية الأردنية. وأبعد من ذلك، فإن الدول الاشتراكية الكبرى، وخاصة منها الاتحاد السوفيتي والصين، لعبت دوراً في التأثير على مواقف العديد من الفصائل الفلسطينية، خاصة على التيار الشيوعي الفلسطيني، الذي اتجه بفعل هذا التأثير نحو الاعتراف بكيان الاحتلال وقبول التسوية السياسية. لعب المال السياسي، سواء من دول داعمة أو مصادر مشبوهة، دوراً كارثياً في تغذية الانشقاقات وتعميقها. فالدعم المالي المشروط بولاءات معينة أو تبني أجندات خاصة يخلق بيئة خصبة للفساد والانتهازية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب آليات المحاسبة والمساءلة الفعالة داخل الفصائل سمح لهذه الظواهر بالانتشار، مما أدى إلى تآكل الثقة الداخلية، إضعاف الأطر التنظيمية، وفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الخارجية التي استغلت نقاط الضعف هذه لتعميق الانقسامات.
ولا يجب تجاهل الدور الذي لعبه الانتشار الجغرافي الواسع للشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم (الشتات)، والذي أدى إلى تنوع في الأولويات والخصوصيات والظروف المعيشية والسياسية لكل تجمُّع، مما انعكس على الرؤى الوطنية وساهم في تباعد الفصائل عن بعضها البعض. هذا التشتت خلق بيئات مختلفة لنشأة الفصائل وتطورها، وسمح للتدخلات الخارجية بإيجاد نقاط نفوذ متعددة، وبالتالي سهولة دعم وتغذية الانشقاقات لخدمة أجندات مشبوهة لا تخدم القضية الفلسطينية. كما أدى هذا التشتت إلى الفشل في تأطير فلسطينيي الشتات بشكل فعال ضمن الأطر الوطنية، وتهميش دورهم الكبير والمهم في صناعة القرار الوطني.
نتيجة لكل العوامل السابقة، وخاصة الترهل التنظيمي وغياب الديمقراطية الداخلية الفاعلة، غاب العمل الجماهيري التعبوي الفعال والمنظم الذي كان سمة مميزة للثورة الفلسطينية في مراحلها الأولى. هذا الغياب أثر سلباً على الوعي المجتمعي العام، وجعله يتجه نحو اللامبالاة أو التشتت، وأدى إلى عزوف قطاعات واسعة من الجماهير، بمن فيهم المثقفون والمناضلون، عن المشاركة بفعالية في النضال الوطني، وشعورهم باليأس والإحباط العميق من هذه الفصائل التي لم تستطع تحقيق آمالهم أو توحيد صفوفهم، أو تقديم نموذج قيادي ملهم قادر على استنهاض الطاقات.
٧٦ عاماً على النكبة .. أعمدة قضية اللاجئين تتعرض للتدمير الممنهج!
الانشقاقات الحزبية والوطنية: جروح في الجسد الواحد (أمثلة تاريخية محددة)
لقد أضعفت هذه الانقسامات في الحالة الوطنية، وما تبعها أحياناً من احتراب عسكري واقتتال داخلي، معظم الفصائل الفلسطينية أمام أعين شعبنا، وأثرت على مسيرتها الكفاحية. ولم تكن تلك الانشقاقات بعيدة عن تدخل ودعم أنظمة بعينها في الشؤون الداخلية الفلسطينية في مراحل تاريخية مختلفة، وتبني بعض الانشقاقات و”صب الزيت على النار”، حيث تعرضت الأوضاع التنظيمية لبعض الفصائل لإضعاف أجنحة أو انشقاقات وانقلابات مدعومة بتدخلات خارجية قوضت استقلاليتها.
حيث تعرضت حركة فتح، التي تُعتبر العمود الفقري للثورة الفلسطينية، لانشقاقات كثيرة ولخروج أجنحة متعددة منها منذ السبعينات. من أبرزها تشكيل جماعة أبو نضال (صبري البنا) عام 1974، والتي تحولت لاحقاً إلى فصيل مرتزق تورط في عمليات اغتيال وتصفيات دموية بعيداً كل البعد عن أهداف الثورة الوطنية. وبعد الاجتياح الصهيوني لبيروت عام 1982 وتوقيع اتفاق فيليب حبيب (الذي أدى إلى تشتيت قوى الثورة الفلسطينية خارج دول الطوق المحيطة بفلسطين)، حدث انشقاق حركة فتح الانتفاضة عام 1983 كاستجابة لتلك التطورات الإقليمية. كذلك ساهمت الخلافات السياسية الحادة في أوساط حركة فتح في إضعافها حيال الموقف من اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث عارضت فصائل وقيادات داخلها مسار التسوية هذا.
لم يكن التيار القومي الفلسطيني بمعزل عن هذه الانقسامات؛ فقد واجه، بعد التحولات الفكرية اليسارية التي طرأت في مؤتمراته، انشقاقات عميقة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تأسست عام 1967 كخليفة للفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب، شهدت سلسلة من الانشقاقات الهامة. من ذلك خروج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة عام 1968 بقيادة أحمد جبريل، إثر خلافات عميقة حول منهج المقاومة وأولوية العمل العسكري. ثم جاء انشقاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في شباط عام 1969 بقيادة نايف حواتمة، إثر تباينات في الرؤى السياسية والتنظيمية. وتلا ذلك انشقاق جبهة التحرير الفلسطينية عام 1977 بقيادة أبو العباس (محمد عباس) وطلعت يعقوب، من رحم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بسبب خلافات حول منهج العمل السياسي. ولا يمكن إغفال تأثير مغادرة مجموعة وديع حداد وانفصاله عن جسم تنظيمه الأم، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في عام 1972، بسبب خلافات حول العمليات الخارجية النوعية. كذلك شهدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني انقسامات حادة أدت إلى انشقاقات، كان أبرزها في عام 1992 بسبب الخلافات الجوهرية حول مسار التسوية السياسية مع الاحتلال، وتحديداً حول التعامل مع اتفاق أوسلو. فانقسمت الجبهة إلى تيارين: أحدهما بقيادة الدكتور سمير غوشة (ثم أحمد مجدلاني) أيد الانخراط في مسار منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، والآخر بقيادة خالد عبد المجيد عارض التسوية تماماً وانحاز إلى الفصائل الرافضة لها.
وعلى الرغم من تمسكهم النظري بالوحدة الطبقية والأممية، عانى الشيوعيون الفلسطينيون أيضاً ظاهرة الانشقاقات والاختلاف السياسي في محطات تاريخية معينة، تجلت غالباً في مؤتمراتهم الحزبية. تعود هذه الانقسامات، في كثير من الأحيان، إلى التأثر بالتحولات الأيديولوجية العالمية داخل المعسكر الاشتراكي، مثل الخلافات بين الخط السوفيتي والصيني، أو التباينات حول تطبيق الماركسية-اللينينية في ظل خصوصية الواقع الفلسطيني والعربي الفريد الذي يجمع بين التحرر الوطني والصراع الطبقي، بالإضافة إلى خلافات حول أولويات النضال الوطني والطبقي.
كذلك لم يسلم التيار الإسلامي الفلسطيني، على الرغم من طبيعته الموحدة ظاهرياً، من ظاهرة الانشقاقات والخلافات الداخلية. وقد تعمقت هذه الانقسامات بفعل أسباب متعددة، تتعلق بشكل أساسي بظروف النشأة التاريخية لكل تنظيم، وطبيعة هويته الفكرية، والمرجعية التي يستند إليها، سواء كانت مرجعية دينية أو سياسية أو تنظيمية. فشهدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعض التباينات الداخلية حول آليات العمل السياسي واستراتيجيات المقاومة، خاصة في مراحل التعامل مع العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات. في حين حافظت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على تماسك أكبر نسبياً، وإن لم تخلُ مسيرتها من اختلافات في الرؤى، لا سيما فيما يتعلق بعلاقاتها الإقليمية، أو درجة التنسيق مع حماس على الأرض.
خارطة طريق لمستقبل الوحدة والمناعة الوطنية
إن خصوصية قضيتنا الفلسطينية الفريدة، وما تفرضه من تشتت جغرافي لشعبنا عبر العالم ومواجهة لعدوان إحلالي عنصري مستمر، تُبرِز بوضوح الدرس الأهم المستفاد من تجارب حركات التحرر العالمية التي خاضت نضالاً ضد الاستعمار والاحتلال على أراضيها: أهمية الوحدة كركيزة أساسية لا غنى عنها للنجاح في مرحلة التحرر الوطني، مع ضرورة تغليبها على أي انقسام مهما كانت مبرراته. للأسف، ونتيجة للأسباب المتعددة التي سبق تفصيلها، تفاقمت حالة التشظي التي يعانيها المشهد الفلسطيني بشكل مقلق. هذا التفكك قوض وحدة الفصائل، حتى تلك المتقاربة منها في نشأتها وأهدافها، مما حول جزءاً كبيراً منها إلى مجرد هياكل تنظيمية هامشية، تعتمد في بقائها على موائد وفتات القوى الأكبر في الساحة الفلسطينية، وتحديداً على مائدة السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية والإقليمية الداعمة. هذا الوضع قلل بشكل كبير من فعاليتها وتأثيرها الفعلي في مسار التحرر. كما أن غياب البيئة النقدية الديمقراطية الأصيلة وضعف الحياة السياسية والنقابية الداخلية، بالإضافة إلى عدم وجود آليات فاعلة للمحاسبة والمساءلة والتدقيق، جميعها عوامل ساهمت بقوة في الاحتقان الداخلي والانفجارات التي شهدتها العديد من القوى. هذه الظروف هيأت مبررات وذرائع شتى للانشقاقات، حيث لعب المال السياسي المشروط والدعم الخارجي دوراً حاسماً في إنجاحها وتعميقها. ومع ذلك، يبقى العامل الذاتي داخل كل تنظيم وفصيل هو المفتاح الأساسي لحدوث هذه الانشقاقات ونجاحها، حتى لو كان هناك دعم أو تحريض خارجي من قوى إقليمية أو دولية من هذا النظام أو ذاك. لقد أضعفت هذه الانقسامات الجبهة الداخلية الفلسطينية بشكل مباشر، وأدت إلى استياء عام واسع النطاق في المزاج الشعبي الفلسطيني، مما نتج عنه عزوف وابتعاد قطاعات وشرائح مثقفة وواعية من الشعب والمناضلين عن هذه الأطر الحزبية التي بدت منقسمة وعاجزة عن تحقيق الأهداف الوطنية. لتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة المناعة الداخلية والنهوض بالمسيرة النضالية، يتطلب الأمر خارطة طريق واضحة المعالم، وجرأة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات المصيرية، والتحلي برؤية استراتيجية بعيدة المدى تتجاوز الحسابات الفئوية الضيقة والمصالح الشخصية.
لبدء عملية استعادة الوحدة الوطنية، يجب إجراء مراجعة وطنية شاملة ومحاسبة ذاتية عميقة لمسيرة الحركة الفلسطينية بكافة فصائلها دون استثناء. لا تهدف هذه المراجعة إلى جلد الذات بطريقة هدامة، بل إلى تحديد نقاط الضعف والفشل بوضوح وجرأة، وتحديد المسؤوليات التاريخية على المستويين الفصائلي والوطني. يتطلب ذلك كله شجاعة نقدية غير مسبوقة تعترف بالأخطاء بصراحة، بعيداً عن تبرير الذات أو تحميل المسؤولية للآخرين. يجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته الكاملة عن الأخطاء التي ارتكبها، وأن يستخلص الدروس منها بصدق وأمانة تامة. يُعد تجديد الكيان وتعزيز الهوية الوطنية أمراً حتمياً وضرورياً، ولا بد من إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس ككيان إداري بيروقراطي، بل ككيان وطني وتمثيلي وقانوني أصيل، كممثل شرعي ووحيد حقيقي لكافة مكونات الشعب الفلسطيني. يتطلب ذلك إعادة بناء شاملة لمؤسساتها الديمقراطية (المجلس الوطني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية) على أسس ديمقراطية حقيقية وشفافة، تضمن مشاركة الجميع. يجب أن يضمن هذا البناء تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع مكونات الشعب الفلسطيني، بمن فيهم فلسطينيي الشتات الذين تم تهميشهم لعقود، وأن تكون هذه المؤسسات هي المرجعية النهائية للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، وليست مجرد واجهة صورية. ويجب توفير بيئة ديمقراطية جاذبة وحرة داخل الفصائل وفي جميع الأطر الوطنية، تضمن حرية الرأي والتعبير، والنقد البناء، والتداول السلمي للسلطة والمواقع القيادية. يتطلب ذلك الحفاظ على القرار الوطني المستقل كقيمة عليا ومبدأ غير قابل للمساومة، والرفض التام والمطلق لأي تدخلات خارجية في الشأن الفلسطيني. يجب التحرر من أغلال المال السياسي المشروط الذي يغذي الانشقاقات ويفرض أجندات خارجية، وتوفير مصادر تمويل وطنية شفافة تعزز استقلالية القرار. إن التجديد هو شريان الحياة لأي حركة أو تنظيم، لذا من الضروري ضخ دماء شابة وكفاءات جديدة، من الجنسين، في مواقع القيادة والقرار على صعيد النظام السياسي الفلسطيني بأكمله. يجب أن يتم ذلك بناءً على الكفاءة والقدرة على القيادة والرؤية الاستراتيجية، بعيداً عن المحسوبية أو المحاصصة أو الاستنساخ التقليدي للقيادات التي تجاوزها الزمن. في المقابل، لا بد من مواجهة حاسمة وشاملة لمظاهر الفساد المالي والإداري والسياسي التي استشرت داخل الأحزاب والقوى والمؤسسات الفلسطينية، وكذلك مكافحة التكلس والجمود التنظيمي الذي يعيق التطور ويصيب الوعي التنظيمي والجماهيري بالشلل. إن استعادة دور الجماهير في النضال الوطني، الذي هو مفتاح النجاح الحاسم، يتطلب تنشيط العمل الجماهيري التعبوي والمنظم في النقابات المهنية، الاتحادات الطلابية، المؤسسات النسوية والشبابية، والمؤسسات المدنية في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. هذا التنشيط لا يعيد الثقة للجماهير فحسب، بل يزيل اليأس المتزايد من الفصائل، ويضمن مشاركة أوسع وفعالة في فعاليات النضال الوطني، ويعيد بناء الحاضنة الشعبية المتماسكة للقيادة الموحدة. لم يعد هناك أي مبرر منطقي أو وطني مقبول لوجود هذا العدد الكبير من الفصائل ببرامج متشابهة في جوهرها وأهدافها. لقد أصبحت الضرورة الوطنية الملحة والمصلحة الحزبية ذاتها تقتضي فتح حوارات جدية ومسؤولة بين الفصائل، وتنسيق الجهود بشكل فعّال، وصولاً إلى الاندماج والوحدة الشاملة في أطر وطنية جامعة. يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على العصبويات الضيقة، وعلى المناصب والامتيازات الفردية أو الفئوية. وهنا تقع على عاتق القواعد الشعبية لتلك القوى مسؤولية الضغط لإنجاز ذلك قبل فوات الأوان. فلم يعد اليوم هناك مبرر لبقاء الكثير من القوى غير الفاعلة نتيجة الظروف الموضوعية والتحديات الراهنة. ففي الساحة الفلسطينية عملياً تياران رئيسيان: تيار يتبنى المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتحرير، وآخر يراهن على سراب التسوية السياسية. وكذلك لدينا ثلاث تيارات فكرية وسياسية وبرنامجية رئيسية: التيار الإسلامي، المتمثل بحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي؛ والتيار الوطني العريض، الذي تمثله حركة فتح ومكونات السلطة الفلسطينية؛ والتيار اليساري الديمقراطي التقدمي، الذي تمثله تفرعات حركة القوميين العرب سابقاً، وقوى اليسار الفلسطيني والديمقراطي التقدمي في الساحة الفلسطينية. يبقى التحدي الأكبر هو البحث عن قواسم مشتركة جامعة يمكن البناء عليها، وصياغة برنامج وطني أدنى متفق عليه، يكون أساساً للمرحلة القادمة، وهذا يتطلب تضحيات وتنازلات متبادلة من الجميع.
في نهاية المطاف، يتوقف نجاح المشروع الوطني برمته على نوعية القيادة التي تتولى زمام الأمور. يجب أن يكون الهدف الأسمى هو اختيار وانتخاب قيادة وطنية تتمتع بالكفاءة العالية، والنزاهة المطلقة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، وأن تكون بمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة. قيادة قادرة على توحيد الصفوف الممزقة، وصياغة استراتيجية شاملة وموحدة، وقيادة الشعب نحو تحقيق أهدافه الثابتة في التحرير والعودة والاستقلال، بعيداً عن المصالح الضيقة والطموحات الفردية.
إضافة لذلك، تبرز ضرورة إقامة التحالفات والعلاقات السياسية الاستراتيجية مع مؤيدي قضيتنا وحقوق شعبنا على الصعيد القومي والإسلامي والإقليمي والعالمي، مع الرفض القاطع لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير على القرار الوطني المستقل.
إرادة شعب أم قدر مقسوم؟
بعد هذا التحليل المعمق لمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية وما اعتراها من انقسامات وتحديات، يتجلى سؤال مصيري يطرح نفسه بقوة على كل ضمير فلسطيني مخلص: هل يمكن حقاً تجديد بنية القوى والمؤسسات الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المصيرية من النضال من اجل التحرر، وذلك في ظل استمرار صمود شعبنا الأسطوري ومقاومته الباسلة للاحتلال؟ هذا ليس مجرد تساؤل نظري عابر، بل هو دعوة ملحة لتقييم واقعي صارم وشجاع. فمع استمرار العدوان المتصاعد وتصاعد وتيرة التحديات الوجودية، يصبح التمزق الداخلي ترفاً لا يمكن لشعب تحت الاحتلال أن يتحمله بأي شكل من الأشكال. إن انتزاع الحقوق الوطنية الثابتة، غير القابلة للتجزئة أو التفريط أو المساومة، يتطلب وحدة صف لم تتحقق بشكل كامل حتى الآن، وهي ضرورة وجودية لاستمرار النضال. يبقى الجواب على هذا السؤال الكبير مرهوناً بشكل أساسي بوجود إرادة وطنية جامعة وحقيقية، إرادة تتجاوز المصالح الفئوية الضيقة والأجندات الشخصية والحزبية الضيقة، وتسمو فوق تأثيرات العوامل الخارجية التي سعت لتفتيت الصف الفلسطيني. تتطلب هذه الإرادة وجود عقل جماعي وقيادي قادر على رؤية الصورة الأشمل والأعمق، ووضع استراتيجية موحدة وشاملة تجمع كل أطياف شعبنا الفلسطيني الأبي في الداخل والخارج، وتفعيل كل طاقاته الكامنة.
إنها دعوة عاجلة لبناء نموذج قيادي جمعي يستطيع أن يعيد الثقة واللحمة إلى النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، ليتمكن الشعب الفلسطيني من استمرار خوض معركته الوطنية نحو الحرية والاستقلال الكامل والعودة الشاملة. ورغم الإدراك الكامل بأن تحقيق المراجعة الموضوعية الشاملة على المستوى الوطني قد يواجه صعوبة بالغة في هذه المرحلة الراهنة، نظراً لوجود برنامجين متباعدين في الرؤى، فكرياً وسياسياً (نهج مقاوم يستند إلى مبادئ وخيارات وطنية ثابتة وواضحة، ونهج منخرط في وهم التسوية والحلول الجزئية)، إلا أن الأجيال القادمة وطبيعة الصراع الوجودي مع المشروع الصهيوني ربما تكون أنضج وأوعى مما هو قائم الآن. هذه الأجيال التي نشأت في ظل التشوهات والانقسامات والتدخلات الإقليمية والدولية، وتعي جيداً تداعيات الانقسام الكارثية، لديها فرصة تاريخية غير مسبوقة لتصحيح المسار التاريخي. إنها تستحق مستقبلاً أفضل، وموحداً، وقادراً على تحقيق أهدافها الوطنية السامية، التي ناضل لأجلها أجيال من هذا الشعب الصامد.